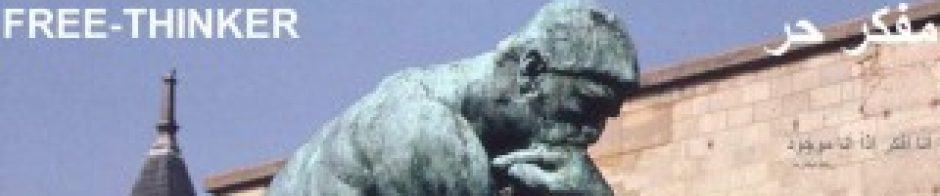حينما يتحدث التاريخ عن الإسكندر الأعظم فإنه يشيد بفتوحاته , بينما حين يتحدث عن جنكيزخان فيصفه بالطاغية , هل كان  الإسكندر يستقبل رعايا الدول التي يفتحها بالقبل والأحضان ؟ أم مثل جنكيزخان بالحديد والنار ؟ فلماذا وكلاهما عمل بطشا بالعباد والبلاد , يسمى الإسكندر ( الأعظم ) ويسمى جنكيزخان ( الطاغية ) ؟
الإسكندر يستقبل رعايا الدول التي يفتحها بالقبل والأحضان ؟ أم مثل جنكيزخان بالحديد والنار ؟ فلماذا وكلاهما عمل بطشا بالعباد والبلاد , يسمى الإسكندر ( الأعظم ) ويسمى جنكيزخان ( الطاغية ) ؟
مصلحة المؤرخ الذي كتب تاريخ الرجلين هي التي تقرر ذلك , يتبعها الحكم الإجتماعي المبني على ذلك من قبل عامة الناس التي تقتنع بكلام المؤرخ وتتبناه , ولهذا السبب تعمل السياسات الحديثة للدول العظمى وصاحبة المصالح حول العالم الى الكذب وتضليل الرأي العام من أجل الحصول على أحكام إجتماعية مبنية على قواعد مضللة وهكذا يتحول الطغيان الى عدالة , والظلمة الى نور , والسفاحين الى دعاة ديمقراطية حول العالم , في الوقت الذي لاينشرون فيه غير الدمار .
ظلت حياة جنكيزخان سرا من الأسرار لا يعلم أحد عنها شيئا , عاصمته كاراكوروم قطعة أرض محمية بالحجر ومليئة بتماثيل بوذا الضخمة , وخوفا من التعرض الى النبش فإن مكان قبره سار عليه 800 فارس الى أن ساووه مع الأرض تماما , ثم تم قتلهم بعد ذلك جميعا كي لا يستدل من أي واحد منهم على المنطقة التي يوجد بها القبر , وكل شيء يدل على جنكيزخان كان قد تم إتلافه , بضمن ذلك كل ما كتب عنه , كما لم يسمح جنكيزخان في حياته لأحد بأن يرسم له صورة , لذلك ظلت شخصية هذا الرجل طي الكتمان حتى العام 1880 عندما عثر على كتاب [ التاريخ السري للمغول ] في منشوريا الصينية . وقد إستغرق هذا الكتاب 100 عام الى ان تمت ترجمته الى الإنكليزية , ومن هذا الكتاب سأقوم بعرض حياة جنكيزخان منذ لحظة ولادته عام 1162 ميلادية وحتى موته عام 1227 ميلادية .
خلال حياته إحتل جنكيزخان أرضا تمتد على عرض 3000 ميل حكمها كخان أي (قائد) لملايين من البشر , ظلت حياته بينهم تشبه الأسطورة . تملأها حكايات الحروب التي خاضها والمدن التي أحرقها , مستقاة من الكتاب الذي كتب بعد موته وظل أحفاده يحفظونه بسرية تامة .
في العام 1161 قامت عصبة صغيرة من الصيادين بالسفر عبر سهوب وسط آسيا العشبية التي تعرف اليوم بجمهورية منغوليا . وذات يوم كان واحدا من هؤلاء الصيادين الذي يدعى ( ياسوجي ) والذي سيصبح والد جنكيز خان فيما بعد , يحمل نسره ويصطاد على ضفة نهر أونون حين شاهد عربة تحمل شخصين من قبيلة الماركي , قام بمساعدة أخوين له بمهاجمة العربة ففر الرجل للنجاة بحياته فيما ساق ياسوجي المرأة التي تدعى ( هوا لون ) الى بيته معتبرا إياها زوجة له . كانت المرأة مذعورة ولكن في عالم بلا قانون لم يكن لها غير قرار الإذعان .
بعد فترة قصيرة ذهب ياسوجي الى إحدى هجماته على قبائل التتار وحين عاد وجد أن زوجته قد رزقت ولدا , سماه ( تيموجين ) ولم يكن يدري أن تيموجين سيكون المقاتل الأعظم نجاحا في زمانه .
نشأ تيموجين على ضفاف نهر أونون وكان يلعب مع إخوته وأقرانه , بعمر أربع سنوات تعلم ركوب الخيل دون سرج , وإمتطاء الخيل واقفا على ظهرها . وأثناء الشتاء كان الأولاد يلعبون فوق مياه النهر المتجمدة يحمل كل واحد منهم مجموعة من عظام كعوب أرجل الغنم ليلعب بها أو يتعارك بها أو يقرأ بها الطالع ( جعاب كما نسميها باللهجة العراقية ) .
عندما صار تيموجين في التاسعة , قرر والده أن يزوجه , فركبا حصانيهما وذهبا الى بيت الحكيم داي الذي أعجب بتيموجين بشدة وعرض عليه أن يتزوج إبنته , وكانت تكبر تيموجين عاما واحدا . لذلك بقي الولد مع هذه العائلة حتى موعد الزفاف .
بعد عدة أسابيع وصلت أخبار سيئة . الأب وفي طريق عودته الى البيت , توقف للأكل في مكان ما , وحين تم التعرف عليه كعدو , وضع له السم في الأكل وهو مريض جدا بسبب ذلك الآن , حين عاد الولد لرؤية أبيه كان الوالد قد فارق الحياة منذ عدة أيام .
بدون وجود الزوج فأن والدة تيموجين لم يعد لها أي مكان في قبيلة زوجها لذلك حين إرتحلت القبيلة فقد تركوها وحدها مع خمسة أولاد , وحين إلتفت الخادم إليهم وقال إن تركهم بهذا الشكل ظلم , إلتفت إليه رئيس القبيلة وطعنه بحربة وتركه ينزف حتى مات .
إعتنت الأم بعائلتها , كان ثلاثة منهم أولادها وإثنين آخرين أولاد زوجها . توجهوا جميعا للبحث عن الطعام , الفاكهة , وجذورالأشجار التي كانت تطبخها لهم ليأكلوها , الأولاد الكبار صنعوا لها إبرا من عظام السمك والحيوانات لتحيك ملابسهم بها . وكانت العائلة تصيد السمك والكلاب والفئران لتقتات عليها , وتلبس جلودها .
سكنت العائلة في ( يارت ) أي خيمة مغولية تنصبها بقرب بعض بيوت القبائل كي لا تبقى منعزلة وحدها في تلك السهوب . ومن خلال تلك الجيرة تعرف تيموجين على صديق يدعى ( جاموكا ) كانا يصطادان سوية ويلعبان ( الجعاب ) ويتسابقان على ظهور الخيل , وبعمر 11 أو 12 سنة صار تموجين وجاموكا ( إخوة دم ) حيث تعاهدا على الصداقة والإخلاص الكامل , ثم جرحا نفسيهما وقام كل واحد منهما بشرب بعض من دم المقابل . وكما يتمكن تيموجين من تكوين أصدقاء بسهولة فكذلك يتمكن من تكوين الأعداء .
بموت الأب عن هذه الأسرة تنازع أبناؤه قيادة العائلة من بعده , وكان الأكبر فيهم ويدعى ( بختيار) وهو شقيق وليس أخ كامل , سرق من تيموجين طيرا إصطاده , ومرة أخرى سرق منه سمكة , عندها إعترض تيموجين عند والدته التي وبخته بأن على العائلة أن تتحد لأن ليس لهم من يعتمدون عليه . بقي تيموجين متذمرا وقام بإقناع أحد أخوته على قتل شقيقهما بختيار , وهكذا تم إستدراجه الى مكان بعيد , سحب الأخوين سهمين وضعاهما في الأقواس وأطلقاهما على شقيقهما وتركاه ينزف حتى الموت على الحشائش .
عند عودة الولدين الى خيمتهم صرخت الأم بغضب حين عرفت بجريمتهما التي ارتكباها بدم بارد , وقالت بأن أولادها يشبهون كلاب البرية أو الضباع أو الوحوش , وأنه لن يبقى لهم صاحب غير ظلهم . أثبت تيموجين منذ هذه السن الصغيرة انه شخص مخلص لأصدقائه وبلا رحمة مع الأعداء .
بعد القوة التي أبداها تيموجين بعد قتل أخيه بختيار بفترة قصيرة , كان عليه أن يدافع عن سمعة قوته , مجموعة مقاتلين من قبيلة تايجيو , قاموا بأسره وأقفلوا عليه نير خشبي وهو آلة ثقيلة جدا تقفل على الرقبة فلا يعود المرء قادرا على الحركة , وجعلوا خدم العوائل تراقبه بالتناوب ولهذا فكل مساء كانوا ينقلونه الى خيمة مختلفة .
إنتظر تيموجين حتى حل يوم أحد الإحتفالات , وكان حراسه سكارى , فقام بضرب حارسه على رأسه بطرف النير الخشبي ثم هرب من الخيمة , وتوارى خلف الأعشاب الطويلة عند حافة النهر . وحين إنتشر الرجال للبحث عنه عثر عليه رجل عجوز يعمل خادما في أحد بيوت تلك القبيلة لكنه لم يلق القبض عليه , حين حل الليل توجه تيموجين الى بيت ذلك الرجل , فقدموا له الطعام وكسروا نيره , فصار حرا , وتوجه الى خيمة أهله . وكانت تلك أول معركة يدخلها مع قبيلة غريبة عنه وهو لم يزل مراهقا , لكنه تدبر أمره بذكاء وشجاعة , فصار يبدو في أعين الناس وكأنه قائد .
بعمر 16 عاما قرر أن يتزوج , فعاد الى بيت خطيبته ( بورت ) ليبحث عن أمرها , دهشت العائلة لمرأى الصبي الذي خطب إبنتهم قبل 7 سنوات , حيث صار رجلا الآن , وكانوا سعداء أنه حفظ عهده معهم , وافقوا على الزواج وأهدوا تيموجين معطفا مصنوعا من فراء السمور كهدية زواج , فعاد فخورا الى خيمته مع عروسه الجديدة , التي بوجودها لم يعد وحيدا , وصار يسعى الى تكوين حياته المادية بشكل جيد .
تسكن الى الغرب منهم قبيلة ( كيرا ) المسيحية , وكانت من أثرى قبائل المغول لكونها
تتاجر مع الكثير من مدن وسط آسيا الثرية , قائد هذه القبيلة رجل يدعى ( طغرل ) يعيش في ( يارت ) مصنوع من ذهب مغزول , وأهله يأكلون بآنية من ذهب , ولزواج أميرة من هذه القبيلة على المرء أن يقدم 200 خادم كهدية .
لم يكن طغرل غير خيار صعب لابديل عنه بالنسبة لتيموجين وكان عليه أن يثق به رغم أن طغرل كان قد قتل كل أخوته ليتمكن من حكم قبيلة كيرا , وهذه الثقة قادمة من أن والد تيموجين كانت له ( أخوة دم ) مع طغرل .
ترك تيموجين عروسه في البيت ورافق إثنين من إخوته لزيارة طغرل , وقدموا له هدية هي معطف فراء السمور الذي تسلمه تيموجين هدية عرس من أهل زوجته , وقالوا له أنهم يعتبرونه بمثابة والدهم لأنه أخ دم لوالدهم الحقيقي . وقد تقبل طغرل الهدية بسعادة .
بدأ تيموجين يكسب الناس من خلال هذا التحالف مع طغرل , قدم للعيش معه شخص يدعى ( بورجو ) كان قد ساعده قبل سنوات في رد قيمة خيول قاما بسرقتها , كما قدم شخص يدعى ( جيلمو ) إتخذ منه تيموجين خادما . ولكن رغم تعاظم قوة تيموجين إلا أن جماعته بقيت صغيرة ولديها الكثير من الأعداء , وبالتحديد قبيلة الماركي أخواله _ أهل والدته التي خطفها منهم والده ياسوجي عندما كانت مسافرة مع زوجها قبل 17 عام .
صحت الجماعة صباح ذات يوم , واذا قبيلة الماركي تهاجمهم , ففر الرجال الى مناطق بعيدة وتركوا الأم وزوجة تيموجين مع الخدم ليختبئوا في مكان آخر . ولكن حين تم العثور على المرأتين , قام المهاجمون بأخذ بورت زوجة تيموجين أسيرة إنتقاما لما لحقهم من أذى من قبل والده .
حين ذهبوا خرج تيموجين من مخبأه , لكن زوجته كانت قد ذهبت , الآلهة حمته من الموت للمرة الثانية وكان عليه أن يصلي الى الشمس عند جبل يعرف بإسم ( بورخان خلدن ) . وكان عليه أن يتخذ قرارا بالإنسحاب الى غابات نهر أونون ليحمي نفسه من أعدائه قبيلتي التايجيو والماركي , ومنذ اليوم عليه أن يودع حياة الصبا .
وافق طغرل مباشرة على تزويد تيموجين ب 20 الف مقاتل لمهاجمة قبيلة الماركي , كما إنه يستطيع الحصول على 20 الف آخرين من حليف آخر هو جاموكا , أخوه بالدم الذي لم يلتق به منذ عدة سنوات , حيث بعث له رسالة أخبره فيها بخطف زوجته الذي كسر قلبه وانه محتاج الى مساعدته ليعمر قلبه من جديد .
القصة أحزنت جاموكا الذي رد على الفور بتقديم المساعدة المطلوبة لأنه هو أيضا كان يكره قبيلة الماركي . إتحدت القوتان وهاجمتا قبيلة الماركي , وإستعاد تيموجين زوجته التي كان الماركي قد زوجوها للإنتقام الى أخي زوج أم تيموجين الأول .
بعد المعركة دخل تيموجين وجماعته في قبيلة جاموكا وصاروا منهم , وأجري لذلك إحتفال عام , وتبادل هدايا ذهبية وخيول أصيلة . أمضى تيموجين وجاموكا السنة والنصف التالية معا , حيث تنامى عدد أتباعهما , وولدت بورت إبنا , والده الحقيقي من قبيلة الماركي , لكن تيموجين تقبله وعامله على أنه إبنه .
لم يكن وضع جاموكا كقائد لهذه المجموعة موضع تساؤل , بينما بقي تيموجين كتابع حتى سنة 1181 , حيث إنشقت هذه الصداقة , لأن جاموكا توقف عن معاملة تيموجين كند . ذات يوم أمر تيموجين بأن يخيم في منطقة منفصلة عن قبيلته قرب الغنم والماعز , فشعر تيموجين بالإهانة , وذهب يسأل والدته عن نصيحة فقالت له : جاموكا متضايق منا وهذا معناه قد آن وقت الرحيل . عدد كبير من أتباع جاموكا غادروا مع تيموجين . الذي شعر بالإستغراب , فبعد سنوات من الطرد والعزلة .. صارت له قبيلته الخاصة .
وخلال ال25 سنة المقبلة سيصبح جاموكا وتيموجين من أعنف المتنافسين , وقد يسرقان من بعضهما النساء والخيول , وجيشاهما يتقاتلان عند السهوب , ففي النهاية واحد فقط هو الذي يجب ان يبقى ليحكم كل قبائل المغول , فقد كان واضحا أن هناك قائدين قويين في هذه السهوب , غير أن تيموجين وبخطوات بطيئة إستطاع إستحواذ القوة الأكبر , فقد كان يمنح لتابعيه المال والذهب والجياد , لذلك نمت قوته .
في هذا الوقت رجال الدين المغول ( شامان) صاروا يقولون إن الرب يحب تيموجين . كما قدم ( شامان ) يدعى ( كرجي) إدعى أنه شاهد ثورا ناطقا يقول ( السماء والأرض تتفقان على أن تيموجين ينبغي أن يكون كبير هذه الإمبراطورية ) الثور كان يقول ذلك .
شامان آخر إسمه ( تب _ تنجري ) إدعى أن الرب كلمه وقال ( أنا منحت كامل وجه الأرض لتيموجين واولاده ) . لكل ذلك تنامت قوة تيموجين وقرر حلفاؤه منحه لقب ( خان ) وكان في العشرينات من عمره . بايعه الجميع على الطاعة وصاروا يسرقون له الحيوانات , ويقاتلون من أجله , وبعد القتال يجلبون له نساءا جميلات كسبايا , وجياد , كما أنهم منحوه حق معاقبتهم اذا لم يطيعوا أوامره , قالوا له ( إفصلنا عن زوجاتنا ونسائنا وإرم رؤوسنا بعيدا في هذه السهوب الخالية ) . الكلمات كانت مثيرة لغروره , لكنها لم تكن أكثر من كلمات , لأن تيموجين ( خان ) بالإسم فقط .. ومعظم قادة القبائل يدعمون غريمه جاموكا , وكان على تيموجين أن يستعمل كل قوته لجعل كل هؤلاء مناصرين له وحده .
عندما كان تيموجين صغيرا , أكل الجذور وثمار البرية ولحم الفئران , ولم تكن عائلته تملك أكثر من تسعة خيول وكانوا يعيشون في خوف من ضياع ممتلكاتهم أو سرقتها . لكنه اليوم في طليعة الأمة ويصدر الأوامر الى رؤساء قبائلها .
في معظم القبائل تكون المكانة السامية لأفراد عائلة القائد , لكن تيموجين كان يقيم الإخلاص والموهبة على تلك القرابة . لذلك فصديقه بورجو وخادمه جيلمو الذين لم تكن تربطه بهما قرابة .. صارا من أقرب مستشاريه . كما إنه سمى 150 مقاتل لحماية مخيمه ليلا ونهارا ووضع (خاسار) أفضل رامي سهام في المخيم قائدا عليهم , (بيلجوتي) أوكلت له مهمة العناية بالخيل التي حفظت قريبة جدا من المخيم بسبب الضرورة . بعض أكثر أصدقاء تموجين ثقة أصبحوا (طباخين) فبعد كل شيء تيموجين لم ينس أن والده مات مسموما من قبل أعدائه .
حين نظم رجاله , بعث رسالة الى طغرل , لم يكن تيموجين يحلم أن يكون أكبر من طغرل , فرد طغرل بسعادة , لكنه نبه الى أن قوة جاموكا المتعاظمة تشعره بالقلق , وأنه يطمح الى أن قوة تيموجين الكبيرة قادرة على كبح جماح جاموكا .
جاموكا من طرفه لم يكن مرتاحا لسماع أخبار طيبة عن تيموجين , فهناك مثل مغولي قديم يقول (( لا تطمح بوضع دبين في كهف واحد )) فبعد كل شيء .. جاموكا أيضا كان يحلم بأن يكون ( خان ) كل المغول وأن يكون ( الكهف ) له وحده .
الدبان تيموجين وجاموكا أعدا لمعركة , وكل ما كانا يحتاجان .. هو السبب لبدء القتال .
والسبب جاء من عارض عام حصل في تلك السهوب , واحد من رجال جاموكا سرق بعض الجياد من رجل إحدى القبائل الموالية لتيموجين , وأحدهما قتل الآخر … إستعد جاموكا لأخذ الثأر , هيأ جيشا وهاجم به تيموجين , فركض مقاتلون غير معدودين بين الطرفين .
قرر جاموكا العودة الى مخيمه بعد أسر عدد من مقاتلي تيموجين . ونسبة الى إحدى الروايات , فإن جاموكا سلق 70 أسيرا حتى الموت . يقول المغول عن ذلك (( إن سلق الأسير , طريقة غير شريفة لقتل العدو , لأنها تقتل روحه كما تقتل بدنه )) . رواية أخرى تقول إن جاموكا إضافة الى ذلك كان قد قطع رأس أميرين وربطهما الى ذيول خيله وجال بهما أرجاء تلك السهوب .
قد يستغرق تيموجين وقتا للقيام من تلك الهزيمة … لكنه سينهض أقوى مما كان .
أعاد تيموجين تشكيل قبيلته , كما أن عددا من العشائر إنفصلت عن جاموكا وإنضمت الى تيموجين , وفي عام 1195 جاءت الفرصة الى تيموجين من قبيلة ( الجرك ) العريضة الثراء التي تسكن في منطقة من مناطق الصين والتي يعرف قائدها بإسم ( الخان الذهبي ) ويسكن في قصر كبير يقع اليوم في بكين مؤثث بالحرير والذهب والعاج .
التتار كانوا يعملون شرطة عند الجرك , ويسعون الى إضعاف المغول حتى لا يشكلوا إزعاجا للخان الذهبي , لكن واحدا من أمراء التتار خان ثقة الخان الذهبي وثار عليه , فأرسل الخان الذهبي بطلب النجدة من طغرل الذي إستعان بتيموجين ورجاله , وكانت تلك فرصة لتيموجين للإنتقام , بالإنقضاض على التتار الذين سمموا والده , فتم هزم التتار وقتل قائدهم وسرقة أموالهم وممتلكاتهم .
حين عاد تيموجين الى دياره عام 1197 عاهده رؤساء القبائل الحليفة على مساعدته ضد التتار اذا إحتاج ذلك مرة ثانية , لكنهم أخلفوا كلمتهم معه , مما دفعه الى هزمهم وأخذ عدد منهم كأسرى , ثم إستدعى رؤساء القبائل الحليفة الباقية , وقطع لهم رؤوس أسراه أمامهم ونثر أشلاءهم في السهوب دون دفن .
المغول يستخدمون أسراهم كعبيد لكن تيموجين تفاهم مع بعض أسراه أنهم اذا أخلصوا له فسيجعلهم جزءا من قبيلته وسيكونون احرارا , وكانت رسالته تلك واضحة وصريحة فالمخلصين له سيعاملون بعطف أما الخونة فإنهم سيقتلون .
دعى جاموكا أتباعه الى لقاء , منحوه فيه لقب ( غورخان ) أي ( خان كل الخانات ) وكان ذلك اللقب إهانة لتيموجين وطغرل , فشرع الجميع الى الإعداد للحرب . وفي ليلة القتال أمطرت السماء مطرا شديدا فحاصر جيش جاموكا الطين والوحل , تقاتل الجيشان , ومن سوء حظ تيموجين أنه أصيب بسهم في رقبته فغادر أرض المعركة , وكان يخاف أن يكون السهم مسموما لذلك فمستشاره وخادمه جيلمو ظل لعدة ساعات يمص الدم من الجرح لسحب السم خارجا . حين أفاق تيموجين كان عطشانا , حين سقاه جيلمو بعض الحليب , إلتفت إليه وقال ( لن أنسى لك ما حييت كل ما فعلته اليوم من أجلي ) .
أعطى تيموجين مجموعة جديدة من الأوامر الى رؤساء القبائل بأن على المحاربين عدم التوقف عن القتال حتى ينهزم العدو , وأن عليهم جمع الغنائم بطريقة منظمة وإيصالها الى تيموجين ومستشاريه , وهو الذي يقرر الطريقة التي تقسم بها الغنائم فيما بينهم .
عام 1202 تم إختبار الجند إزاء هذه الأوامر عندما دخل تيموجين في حرب جديدة ضد التتار الذين ومنذ قرون يفعلون ما بدا لهم في هذه السهوب , ولهذا تقدم تيموجين بجيشه نحوهم وبدأت السهام تطلق نحوهم بكثافة , وسرعان ما تمت هزيمتهم .
ثلاثة من زعماء القبائل لم ينفذوا تعليمات تيموجين بشأن الغنائم , أبقاهم أحياء لكنه صادر حتى أصغر قطعة غنيمة حصلوا عليها .
كانت لتيموجين الآن مشكلة جديدة , التتار قبيلة مكونة من عدة آلاف من الرجال , هل يأخذ بعضهم كعبيد ويترك البقية ؟ ليتجدد قتاله معهم بعد عدة سنوات ؟ إهتدى الى حل لهذه المشكلة عن طريق تحويل التتار الى مغول . مساعديه نصحوه بقتل كل ذكر تتري يزيد طوله عن العارض الذي يربط الحصان الذي يجر عربته , أما الصغار فيلتحقون بقبائل المغول كجزء منها وقد تم ذلك فعلا , أما من الغنائم فقد أخذ تيموجين تتريتين ضمهما الى حريمه كزوجتين الى جانب زوجته الأولى بورت , وبهذه الطريقة وفي غضون أشهر قليلة فإن التتار كقبيلة كبيرة كان قد تم محوها من الوجود .
سمى تيموجين قادة المجاميع , لم يهتم لرؤساء القبائل , لأنه كان يريد عساكر مخلصين وموهوبين , ولم يكن يهمه منهم إذا كانوا من طبقات دنيا من المجتمع حلاقين أو نجارين , القائد العام لقواته كان إبن حداد . وهكذا حول النظام الجديد قوات تيموجين الى ماكنة قتالية رهيبة , وحيث لم تكن للمغول لغة مكتوبة , لذلك تم إبتداع نظام الرسل الذين ينقلون الرسائل شفاها ويتوزعون على نقاط بنظام البريد .
بعد هزيمة التتار أرسل تيموجين رسالة الى طغرل يخطب فيها إبنة طغرل الى إبنه جوشي , وبالمقابل فهو مستعد لإرسال إحدى بناته لتتزوج واحدا من أبناء طغرل . طغرل هذه الأيام كان قد أصبح رجلا عجوزا , وحين سيموت يجب أن يأخذ مكانه شخص ما , لذلك فإن تيموجين يعد نفسه لهذا الموقع بتلك الزيجات . في البداية رفض طغرل العرض , لكنه عاد ودعا تيموجين الى حفل لتزويج الأولاد , حين ذهب بمصاحبة القليل من قومه , تم نصحه بأن ينتبه الى أن طغرل ربما يعد لقتله مع عائلته . عندها فر تيموجين مع صحبه يلاحقهم جيش طغرل , نفذ طعامهم , فتشتت الأصحاب وضاع قسم منهم . فصحيح أن تيموجين يحكم قبيلة كبيرة , ولكن كونها من عدة أعراق , فهي قبيلة ضعيفة الولاء وقد تتخلى عنه لأي سبب وتمنح ولاءها الى طغرل أو جاموكا .
تجمع 19 قائدا حول تيموجين , يدينون بديانات مختلفة , بعضهم كان نصرانيا وبعضهم بوذي , وبعضهم مثل تيموجين يعبدون إله الطبيعة . أعدوا جميعا للحرب .
أرسل تيموجين رسالة الى طغرل يدعوه فيها الى نسيان الماضي , شعر طغرل بالفرح لذلك وأرسل الموافقة مع رسوله الخاص الى تيموجين , أمسك الرجال الرسول وقتلوه , وتوجهوا ليلا الى قبيلة طغرل وهاجموها وإستمرت المعركة ثلاثة أيام , قتل فيها طغرل أثناء محاولته الفرار وإستسلمت قبيلته , لقد كان طغرل بمثابة والد لتيموجين , لكنه بعد أن خان ثقة إبنه الروحي , كان يجب عليه أن يموت .
خلال سنتين كان تيموجين قد هزم أكبر قبيلتين في المنطقة وهما قبيلة التتار وقبيلة طغرل , لكنه لم يزل غير مرتاح لأن قبائل ( النايمان ) تمتلك رجالا بالآلاف ,, وقد تحالفوا مع جاموكا . خلال عام 1204 كان تيموجين مستعدا تماما لقتالهم , ولكي يوهمهم بكبر حجم قواته , أمر جنوده الذين يسيرون في مقدمة الجيش بأن يحمل كل واحد منهم ليلا وهم يتقدمون , خمس شعل بدلا من شعلة واحدة . وحين بدأ القتال شنوا على النايمان عدة طلعات من الكر والفر ورموهم بالسهام من إتجاهات مختلفة مما جعل النايمان يرتبكون ويتراجعون للإختباء خلف أحد الجبال فإنتهت الحرب .
جاموكا حليف النايمان فر الى الجبال أيضا , بعد أن تخلى عنه أغلب تابعيه , وظل مع قلة من صحبة في البرية سنة كاملة يعتاشون على صيد الحيوانات , حين تعب الرجال من هذه الحياة , خانوا جاموكا , أسروه وذهبوا به الى تيموجين .
تيموجين لم يكره شيئا كالخيانة ,, أخذ جاموكا , وأعدم رفاقه الذين غدروا به أمام عينيه , وصار الآن بمواجهة واجب قاسي , فقد كان على تيموجين أن يتخلص من جاموكا أخوه بالدم .
طبقا لكتاب التاريخ السري للمغول , فإن تيموجين سأل جاموكا لآخر مرة أن يعود حليفا له , لكن جاموكا رد عليه أنه لن يستطيع لأن لا ثقة بينهما بعد اليوم , وعلى تيموجين أن يقتله دون تأخير وأن يدفنه في أرض مرتفعة .
أعطى تيموجين أوامره بقتل جاموكا , ودفنه في أرض مرتفعة , ووضع معه في قبره سهما ذهبيا إكراما له . يومها كان عمر تيموجين 43 سنة , في ذلك اليوم صار القائد الأعلى الوحيد لكل المغول .
يومها تجمع آلاف المحاربين المغول عند أحد روافد نهر أونون , نصبوا خيامهم قرب خيمة تيموجين وربطوا أعلاما الى ذيول خيولهم , ونثروا أطنانا من الزهور فوق سطوح خيماتهم , ووبايعوا تيموجين قائدا أعلى تحت إسم ( جنكيز خان ) . كلمة جنكيز كلمة مغولية معناها ( القوي ) , عبارة جنكيز خان تعني : ( القائد القوي ) .
قام جنكيزخان بتعيين عدد من القادة الكبار , منح رتبا قيادية الى إثنين من أوفى أصدقائه وهما ( بروجو ) و ( جيبي ) كما منح رتب قيادة عامة الى أولاده الأربعة : ( جوشي ) و ( كاجاتاي ) و ( أوجوداي ) و ( طولوي ) . ثم سن قانون الخدمة الإلزامية , كل رجل ما بين 17 _ 50 سنة عليه أن يلتحق بها , وفي فترة الجندية على الجندي طاعة أوامر قائده العسكري فقط , وليس رئيس قبيلته .
سن جنكيز خان بعض القوانين , ولكي تتم كتابتها , فرض على المغول تعلم القراءة والكتابة من قبيلة تركية تدعى ( أويغور ) . وكان أول واجب بعد تعلم الكتابة , هو كتابة كتاب ( الياسة ) أو كتاب القانون العظيم , في كتاب الياسة حاول جنكيز خان فرض النظام داخل الدولة المغولية , منع خطف النساء وجعله جريمة , كما قرر أن السرقة عمل غير قانوني وعقوبة السارق هي الموت . بعض عقوبات الياسة قاسية جدا , لكن جنكيز خان سمح لبعض القبائل بالمحافظة على تقاليدها الخاصة , وأصر على حرية المعتقد الديني , وبإمكان المسلمين والمسيحيين والبوذيين أن يمارسوا شعائرهم كما يحلو لهم وهم مقبولون تحت رعاية مليكهم . اٌقسى القوانين كانت قد سنت للجيش , أثناء الخدمة لا مكان للعصيان أو عدم الطاعة , والموت هو عقوبة الجندي الذي يسلب أثناء القتال ويحتفظ بغنائمه لنفسه , أما الرسل الذين يشربون الخمر أثناء مأمورياتهم فإنهم يعرضون أنفسهم الى الإعدام .
وتحت هذا التنظيم صارت قوة المغول قوة مهابة ولكن .. إلى أين ستمضي هذه القوة ؟؟؟
نظر المغول الى جنكيز خان متطلعين أن يقودهم الى الثراء , ولهذا فجنكيزخان كان محتاجا الى مصادر جديدة للثروة . في العام 1210 مات الخان الذهبي رئيس قبيلة الجرك العريضة الثراء وخلفه إبنه على الحكم . لسنوات طويلة عد الجرك أنفسهم متحضرين بالنسبة الى بقية قبائل المغول البدوية , كما أنهم كانوا حلفاء طغرل الذي حاول قتل جنكيزخان ذات يوم , وفوق هذا بعث حاكمهم الجديد سفيره الى جنكيزخان يطلب طاعة وولاءا مثل ما كان طغرل يفعل معهم من قبل , فأعلن عليهم جنكيز خان الحرب .
بدأت الحرب عام 1211 جهزها المغول ب 65 ألف مقاتل خيًال , و جهزها الجرك ب 85 ألف مقاتل مشاة , لكن عامل تفوق سرعة المقاتل الخيًال على المقاتل المشاة كانت في مصلحة المغول .
ذكر الرحالة ماركو بولو بأن المغول كانوا يرتحلون لمدة عشرة أيام دون التوقف لطبخ الطعام , وأنهم كانوا يصيدون ويسرقون حين تنفذ تجهيزاتهم , أما اذا نفذ لديهم الماء فإنهم يقطعون أوردة الخيل ويشربون دمها .
بسرعة تقدموا عبر منطقة منشوريا الى الشرق , ثم عبروا سور الصين العظيم , هيجوا قبائل ( الخاتان ) الساكنة في هذا الطريق الطويل ضد الجرك , فقبل حوالي 100 سنة كان الجرك قد إحتلوا الخاتان .
عام 1212 أعلن جنكيز خان للخاتانيين أنه قدم لتحريرهم من الجرك , وأنهم اذا إنضموا الى المغول فإنه سيعاملهم معاملة طيبة , فإنضموا الى جانبه وقدموا 100 ألف مقاتل .
كان المغول بلا رحمة مع القبائل التي لم ترض الإشتراك معهم في هذا القتال , دمروا حقولها وأفزعوا أهلها , أصبح أكثر من مليون إنسان بلا مأوى , وشحت المواد الغذائية , فجاعت الناس , أما الجرك الذين صاروا محاصرين في ديارهم فقد بدأوا بأكل لحوم البشر ليعيشوا .
كان كل جندي مغولي يأخذ عشرة أسرى من القبائل التي ترفض المعاونة على القتال , يستخدمهم كعبيد لجلب الماء وجمع الأزبال في خنادق خاصة , ولم تكن حياة هؤلاء الأسرى تعني شيئا , ففي فترات القتال العنيف كانوا يوضعون في المقدمة ويستعملون كدروع بشرية , وعند موتهم يرمون في نفس خنادق جمع الأزبال .
حين وصل المغول الى ديار الجرك , رأى جنكيز خان أن الجرك لا يعيشون مثل المغول , فمدنهم محمية بالأسوار , ولإختراق هذه الأسوار قام المغول ببناء السدود لإغراق هذه المدن , كما قاموا بعمل أسلحة حادة كالتي عند الجرك , وأهم من كل هذا أنهم توصلوا الى صناعة ( المنجنيق ) وهو آلة كبيرة تملأ بالحجارة أو المواد المشتعلة وترشق الى مدن الجرك من فوق السور , كما تعلموا صناعة آلة قاذفة للسهام تعبأ بعشرات السهام وترشق مرة واحدة , وأخيرا تعرف المغول على قاذفة اللهب الصينية وهي قصبة بامبو تملأ بالبارود ويشعل رأسها ثم ترمى على العدو . حين أسر المغول المهندسين الجرك المسؤولين عن تصنيع هذه الآلات عاملوهم بالحسنى على شرط أن يعلموا المغول أسرار عملهم , والناس كانت تعرف معنى رفض طلب للمغول … غير أن هناك بعضا من هؤلاء المهندسين , رفضوا التعامل مع المغول .
خلال ثلاث سنوات كان المغول قد خربوا بلاد الجرك وإحتلوا مدنها , وأخيرا وصل جنكيزخان الى مدينة ( زونغ دو) عاصمة الجرك , فوافق الخان الذهبي على كل شروط المغول , عاهدهم على الوفاء لجنكيزخان , وأعطاهم كل ما يريدون , ووهب إحدى الأميرات الى جنكيز خان ومعها ألف عبد وثلاثة آلاف فرس , ووعد بدفع الجزية كل سنة . وقد قبل جنكيز خان بذلك , فكل ما كان يهمه هو ثروات الجرك وليس أرضهم أو أرواحهم .
حين عاد جنكيز خان الى دياره , نكث الجرك كل وعودهم معه , فأرسل جنكيز خان خيالته لتدمير المدينة وحمل كل ما فيها كغنائم الى مملكته . مئات الآلاف من البشر تم قتلهم , وهناك شهادات تقول أن عظام المقتولين بقيت لسنوات خارج المدينة على شكل تلال بيضاء . عندها عين جنكيز خان واحدا من أخلص قواده حاكما على الجرك ويدعى ( موكالي ) وزوده ب 60 الف جندي لتدعيم حكمه .
في العام 1215 كان جنكيز خان قد وصل الى درجة من النجاح لم يحلم بها أحد , والثروة الجديدة التي هبطت على المغول من أرض الجرك , غيرت شكل حياتهم تماما , تغير شكل بيوتهم وأثاثهم وطريقتهم في الأكل , جلب المغول معهم الحلاقين والنجارين والحدادين والصاغة والكتبة والأطباء , وقد أمضى جنكيز خان سنوات عدة يحاول ضبط نظام المجتمع الجديد , لكنه الآن قد بلغ 57 من العمر , طويل وقوي ونشيط وعينه تلمع مثل عين قط , لكنه صار عجوزا , شعر وجهه صار أبيضا بلون الثلج , والناس في زمانه لم تكن أعمارهم تتجاوز الستين .
إنه الوقت الذي على جنكيزخان العجوز أن يقرر من الذي سيحكم بعده . إستدعى أولاده الأربعة ( جوشي ) و ( كاجاتاي ) و ( أوجوداي ) و ( طولوي ) , جوشي كان الأكبر وقد إختاره جنكيزخان ليقوم من بعده , لكن كاجاتاي الإبن الثاني كان متذمرا من ذلك بشدة , قال لأبيه إن جوشي ليس أكثر من نغل حبلت به أمهم من الرجل الذي عاشرته سبية حين خطفتها قبيلة الماركي . فرد عليه جوشي بغضب , تلاسن الولدان بحضور أبيهما الذي ظل يستمع ساكتا وحين إنتهيا من الحديث نهر جنكيزخان ولده كاجاتاي وقال له ( أنت لم تهن جوشي وحده بكل هذا الكلام , لكنك أهنت أمك , وأنتم تعرفون جيدا كم كان صعبا علي بناء هذه الإمبراطورية , لذلك لا أريد منكم تدميرها بالخلافات العائلية ) .
بعد الإستماع الى كلام الأب كاجاتاي إقترح على أبيه إقتراحا ( أن يصير أوجوداي الخان بعد وفاة أبيه , هو لا يفكر جيدا ويسكر أغلب الوقت لكنه كريم وطيب القلب , وربما هو الخيار الوحيد لأن طولوي ورغم كونه مقاتلا بارعا إلا أنه ومنذ صغر سنه أثبت أنه قاس بما فيه الكفاية , أما جوشي وكاجاتاي , فيحرمان تماما من حمل اللقب , لأن إحتمال أن يكون أحدهما خانا , معنى ذلك الإيذان لحرب أهلية بأن تقع ) .
وافق الجميع على هذا الكلام , فقام جنكيز خان بتعيين ولديه جوشي وكاتاجاي حاكمين لولايتين منفصلتين تفصل بينهما آلاف الأميال .
في هذه الفترة حول جنكيز خان بصره الى الغرب حيث يوجد السلطان الذي يعادي المغول , السلطان محمد الثاني سلطان خوارزم المسلمة , التي تحتل أرضا تمتد من جبال أفغانستان الحالية شرقا الى البحر الأسود غربا ومن بحر الأرال شمالا الى الخليج العربي جنوبا , والمغول متعطشون لخيرات هذا البلد الكبير الواسع الخيرات , والى خبرات الحرفيين المسلمين الذين يعرفون أسرار صناعة الفولاذ الذي يصنعون منع أسحلة تبقى لماعة وحادة على الدوام , كما يعرفون أسرار صناعة الزجاج , ولديهم خياطون يصنعون ملابس جميلة من القطن .
أرسل جنكيز خان رسالة الى السلطان محمد الثاني قال له فيها ( أنا سيد البلاد الشرقية وأنت سيد البلاد الغربية ويجب أن نوقع معاهدة بيننا ليتزاور تجارنا في أمان ) . وافق السلطان محمد في تسامح ظاهر وتشكك باطن , لأنه لم يكن يريد أن يقع لخوارزم ما وقع على الجرك .
عام 1218 أرسل جنكيزخان قافلة تجارية الى ( أوترار ) وهي مدينة خوارزمية في أقصى شرق السلطنة , فقام حاكم المدينة بإرسال خبر بذلك الى السلطان محمد الثاني موضحا أن هذه القافلة أتت للتجسس على البلاد , فتم إعتقال التجار وقتلهم .
مرة أخرى يقوم حليف بخيانة العهد … أرسل جنكيز خان جيشا قوامه 100 الف خيال , حاصروا مدينة أوترار مدة 5 أشهر , وحيت إستسلمت , تم قتل 20 الف من رجالها , وأسر حاكمها ثم تم إعدامه .
جنكيز خان وولده طولوي , توجها بحملة الى مدينة بخارى , فهرب آلاف من مقاتليها حين سمعوا بوصول الخيالة المغول , وإستسلمت المدينة في اليوم التالي . تم قتل جنود خوارزم على الفور , وأخذ البقية أسرى لإستعمالهم كدروع بشرية في معارك مقبلة , أما أصحاب الحرف والخبرات من أطباء ومعلمين ومعدنين وصناع أسلحة , فإن المغول سيعاملونهم معاملة حسنة إذا قبلوا التعاون مع المغول .
بعد شهرين وصل المغول الى سمرقند العاصمة السلطانية وكانت محاطة بأسوار عالية , هاجمها أكثر من 100 الف مغولي , فسقطت خلال عشرة أيام . ثم إتجه المغول الى تيرميز وبقية المدن .
السلطان محمد الثاني هرب الى جزيرة في بحر الخزر ومات هناك سنة 1221 . إبنه جلال الدين هرب عندها الى الهند وظل يقاتل في سبيل مملكته عشر سنوات , لكن سلطنة خوارزم كانت قد أصبحت كليا تحت حكم جنكيز خان الذي قام أتباعه بتدمير العشرات من مدنها , وتغيير مسارات طرق التجارة فيها كليا , وتحويل مزارعها الى أرض بور , أما البشر الذين قتلوا فقد كانوا بالملايين .
جنكيز خان صار الآن وحسب قوله ( يحكم دولة تمتد من مشرق الشمس حتى مغربها ) ولم يتبق أمامه غير شيء واحد هو : البحث عن الخلود .
عام 1222 خيم جنكيزخان في منطقة جبلية تقع اليوم في أفغانستان , ينتظر رجلا صينيا مقدسا إسمه ( جنجون ) قيل أنه أكتشف سر الخلود , ويقال أن عمره الآن 300 سنة . حين وصل جنجون الى مخيم جنكيزخان قال إن عمره الآن هو 75 فقط , وأن كل الحكايات التي قيلت عنه ملفقة فهو لا يمنح الخلود , لكنه فقط يعرف كيف يشفي من المرض .
وبالرغم من خيبة الأمل إلا أن جنكيزخان أحب هذا الرجل بشدة وإلتقاه عدة مرات . نصح جنجون الخان بان يعيش حياة معتدلة وأن يكون رحيما مع الناس وأن يتوقف عن الصيد , لكن جنكيزخان سأل الحكيم ان يصلي من أجله .
عام 1226 تمرد ( التانغوت ) ضد المغول في الجنوب من الإمبراطورية , فقاد جنكيزخان حملة لتأديبهم . لكنه حين مرض إستدعى ولديه أوجوداي وطولوي ليظلا الى جانبه .
بعد ذلك اللقاء على من سيخلف جنكيز خان في الحكم , إنقطعت أخبار جوشي تماما , وهناك شائعات قوية تقول : إن جنكيزخان كان قد قتل ولده .
على فراش الموت , حكى جنكيز خان لولديه حكاية الحية المتعددة الرؤوس التي عند مهاجمتها لا تدري الى أين تذهب , لأن كل واحد من رؤوسها يعطيها أمرا مختلفا , وأمر أولاده أن يكون لهم رأس واحد , لا رؤوس متعددة .
قام الولدان بإرسال رسالة سلام الى ملك التانغوت , لكن رده كان مهينا , بعد عدة أيام من ذلك مات جنكيز خان عن عمر 65 سنة , من شدة الحزن عليه دفع الغضب جنوده الى قتل جميع سكان عاصمة مملكة التانغوت بالكامل , وبعدها وضعوا جثته في عربة وعادوا به الى أرض المغول , كان جنكيزخان قد أمر أن يحفظ خبر موته سرا , ولذلك فكل من شارك في عملية دفنه وإخفاء أثر قبره سيقتل . لحد اليوم لا يعلم أحد بالتحديد أين يقع القبر , لكن أكثر الناس تعتقد أنه ووري الثرى في المكان الذي كان يحبه بشدة : عند جبل بورخان خلدن . ميسون البياتي – مفكر حر؟