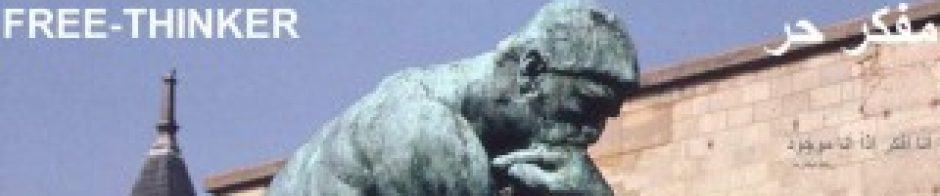رياض الحبيّب السبت، 01 أيلول 2012، 10:58
خاص: موقع لينغا
لا شكّ في أنّ المُتعَب يحتاج إلى الراحة والسَّهْـران إلى النوم والقلِق إلى الطمأنينة والمضطرب إلى الهدوء. فالراحة والنوم والطمأنينة والهدوء ردود فعل طبيعيّة يحتاج إليها كل كائن فيه نسمة حياة. أمّا المضطرب الذي يُسَلِّم نفسه إلى أقسى درجات الألم بدل الراحة ويُسَلِّم جسده إلى أشدّ أنواع العذاب بدل الهدوء وهو يدري أن جسده سيتعرّض للموت، يستحق وقفة تأمّل طويلة وقد يصعب على المتأمِّل في هذه الحالة الشائكة أن يصل إلى نتيجة مقنِعة. هو ما حصل لي يوم كنت يافِعًا، إذ عَلِمْتُ أنّ على المسيحي أن يحبّ الله ويحبّ أخاه بالإنسانيّة وعليه أن يستعدّ لأيّ ضيق من المُحتمَل أن يعترض حياته وإن كان مطمَئِنًّا إلى أنّه بعد الموت سيحظى بعِـشرة مع المسيح في ملكوته. لكنّني احتجْتُ إلى إرشاد الروح القدس لتفسير حالة الإضطراب التي انتابت السيّد المسيح قُبَيل تسليمه إلى القضاءَين اليهودي والروماني، إذ فهمت جميع أسباب الإضطراب المذكور في العهد الجديد في أماكن عدّة إلّـا اضطراب يسوع الرّوحي: {لمّا قال يسوع هذا اضطرب بالروح وشهد وقال الحقّ الحقّ أقول لكم إنَّ واحدًا منكم سيُسَلِّمُني} يوحنّا 21:13 وكان تساؤلي أوّلًـا: مِمّا اٌضطرب الربّ يسوع؟ وثانيًا: لماذا اضطرب الربّ يسوع؟ في وقت توقّعتُ أنه سيقابل التسليم وتبعاته الصلب بأعلى درجات الغبطة؛ إذ أوشك مشروع الفداء على النهاية، لبدء عهد جديد مبارك بحلول النعمة، بعد عهد ناموس موسى النبيّ، عهد الشريعة الطويل المدى ذي الثواب والعقاب
إليك الآيات التي ورد فيها الفعل “اضطرب” في العهد الجديد؛ بحسب موقع الإنجيل المُدوّن أدنى وموقع البشارة أيضًا، ذلك لأنّ أيّ موقع الكتروني مُعرّض للعطل ومحتاج إلى الصيانة فمن الضروري الحصول ما أمكن على أزيد من مصدر لتصفّح الكتاب المُقدَّس: {مَتّى 3:2 فلمّا سَمِعَ هيرودس الملك اضطرب وجميع أورشليم معه. مَتّى 26:14 فلمّا أبصرَهُ التلاميذ ماشيًا على البحر اضطربوا قائلين إنهُ خيال. ومن الخوف صرخوا. مرقس 50:6 لأنّ الجميع رأوه واضطربوا. فللوقت كَلَّمَهُمْ وقال لهم ثِـقوا. أنا هو. لا تخافوا. لوقا 12:1 فلمّا رآه زكريا اضطرب ووقع عليه خوف. لوقا 29:1 فلمّا رأته اضطربت من كلامه وفكّرت ما عسى أن تكون هذه التحية. يوحَنّا 33:11 فلمّا رآها يسوع تبكي واليهود الذين جاءوا معها يبكون انزعج بالروح واضطرب. يوحَنّا 27:12 الآن نفسي قد اضطربت. وماذا أقول. أيّها الآبُ نجِّني من هذه الساعة ولكن لأجل هذا أتيت الى هذه الساعة. أعمال الرُّسُل 31:21 وبينما هم يطلبون أن يقتلوه نما خبر الى أمير الكتيبة أنّ أورشليم كلَّها اضطربت} آمين
أمّا إرشاد الروح القدس فيتمّ بطريقتين إحداهما مباشرة والأخرى غير مباشرة؛ فالمباشرة هي أن يُرشِدَ إلى معرفة الصّواب باتجاه مُعيّن فيُقنِع وهذا الإتجاه يعتمد على اثنتين؛ قوّة علاقة الإنسان مع الله وسعة اطّلاع الإنسان على كتاب الله إذ غالبًا ما يكون فيه جواب على كلّ سؤال. أمّا غير المباشرة فهي إرشاد الباحث إلى شخص مُؤمِن ومُطّلِع قد عرف الصواب من قبل، أو إلى كتاب تفسير في صفحاته ما يبحث عنه الباحث ليقتنِع مرتاح البال. فذهبت إلى أحد كتب التفسير حتى وجدت التالي لدى العَلَّـامة أوريجينوس: [اعتاد السيد المسيح أن يتحدث عن آلامه وموته دون أن يضطرب، لكنه إذ يشير إلى خيانة تلميذه قيل: “اضطرب بالروح” فإنّ خطايا المؤمنين تُحزِن قلب السيد المسيح الأبوي. وكما تكلّم الرّبّ قديمًا وقال: “رَبيّتُ بَنين ونشّأتُهم، أمّا هُم فعَـصوا علَيَّ” إشعياء 1: 2 كما قيل: “فِي ضِيقِهِمْ تَضَايَقَ… لكِنَّهُمْ تَمَرَّدُوا وَأَحْزَنُوا رُوحَ قُدْسِهِ” إش 63: 9، 10 واضطرب يسوع في روحه البشرية، إذ صار بالحق إنسانًا كاملًـا، روحه تضطرب من أجل خيانة تلميذه له. ليس اضطراب الخوف من الموت أو عن جهل لِمَا سيحدُث، إنما اضطرابٌ من أجل التلميذ الذي يتجاسر فيخُون سيّدَهُ ورَبَّه. فإنّ الذي يخونني ليس غريبًا عن تلاميذي، وهو ليس واحدًا من تلاميذ كثيرين، بل واحدٌ من الرسل الذين نالوا كرامة اختياري لهُمْ] انتهى
فلمّا قرأت هذا التفسير ارتحت واقتنعت، لكنّ التفكير قادني إلى أبعد؛ إلى تصوّر قلب يسوع الكبير حزينًا على مصير تلميذه الأسخريوطي إذ اختاره من البداية للقيام بعمليّة التسليم، آسِفًا على الميتة التي ماتها تلميذه نادمًا في ما بعد. كما أخذني التفكير إلى تصوّر شعوره بالأسى على مصائر تلاميذه ورسله وأتباعه من ضيق واضطهاد وطرد وتشرّد وقتل منذ ذلك الحين إلى يومنا وإلى مجيئه الثاني، لأنّ كُلّـا من محبّة الربّ وحزنه أعظم ممّا للإنسان بكثير وأنّ مَداهُما أطوَل زمنيًّا وأبعَدُ مكانيًّا. فيا ليت كلّ اضطراب مثل اضطراب يسوع لأنّه من النوع الإيجابي إذْ صبّ في مصلحة البشر. أمّا نقيضه فالإضطراب السلبي الذي يُصيب البشر، مِثل جنون العظمة ذي النتائج الكارثيّة، إذ اجتاح عدد من حكّام العالم أراضي الغير تحت مسمَّيات باطلة ووهميّة
* * *
لماذا المُضطرِب؟
المضطرِب هو البحر الثامن عشر والأخير في هذه السلسلة من بحور الشعر؛ اسم جديد اخترته لأحد مجزوءات البسيط (بدون حيود عن عروض الخليل) شأنه شأن أحدها الذي أصبح بحر المجتثّ! والدليل على أنّ المجتثّ منتزع من البسيط هو وزنه: مُستفعِلُنْ فاعلاتُنْ= مُستفعِلُنْ فاعِلا- تُنْ= (مُستفعِلُنْ فاعِلُنْ مُسْ) فواضح انتزاعه من البسيط الذي وزنه: (مُستفعِلُنْ فاعِلُنْ مُسْتفعِلُنْ فاعِلُنْ) وهناك مَن اعتبر المجتث من مجزوءات الخفيف (راجع-ي ما ذكرت في معرض المقتضب) ولقد أشرت إلى الإسم الجديد أوّل مرّة في معرض المتدارك. وقد سمّيته “المُضطرِب” بعد دراستي قصيدة عبيد بن الأبرص (ت 554 م) المصنّفة ضمن المُعَلَّقات وهي أشهر قصائد عبيد؛ إذ عدّها ابن قُتيبة من المُعَلَّقات السبع بينما عدّها التبريزي من المعلقات العشر، لذا كانت شهرتها وتزكيتها من ابن قتيبة والتبريزي وآخرين وراء أهميّتها في تراث العرب الشعري، حتى نُظِمَتْ على طرازها قصائد كثيرة في الماضِيَين البعيد والقريب. لذا لا يمكن تجاهلها وإطلاق أحكام ساذجة عليها غير مدروسة. ولعلّ تسمية المضطرب من جهة أخرى تُعيد إلى الأذهان ذكرى تلك القصيدة التي حَظيَت باهتمام أهل الشعر والعروض ولا تزال إلى أيّامنا، على رغم اضطراب عدد من إيقاعاتها، بل لعلّها تُحيي ذكرى الشاعر! أليس خيرًا من إحياء ذكريات أناس أساؤوا إلى الإنسانيّة وأسوأهم مُجرمو التاريخ وإرهابيّوه؟ إنّ أولئك لخالدون في مزابل التاريخ
* * *
أين الإضطراب؟
إنّ عبيد بن الأبرص في تقديري شاعر من الطبقة الأولى مثل امرئ القيس ومثلهما الأعشى قيس ودُرَيد بن الصِّمّة والخنساء… وقد سبق لي ذكر مساجَلة شعريّة حصلت بين عبيد وامرئ القيس في معرض البسيط. أمّا العروضيّون فقد أجمعوا على وجود اضطراب في وزن مُعَلَّقة عبيد لكثرة ما فيه من زحاف وعِلَّة، بدون قيام أحدهم بأيّ تحليل لمعرفة سبب ذلك الإضطراب ولا استطاع حلّ لغز الإيقاع وإشكاليّته في وزن هذه المُعَلَّقة، سواء أكان حكمه مستندًا إلى نهج الخليل أم معتمدًا على العروض الرقميّ (وهو طريقة حديثة للتعبير عن موسيقى الكلمات بالأرقام) فمن المعلومات التي حصلت عليها حتى الآن هي أنّ النقّاد (حكموا على مُعلّقته بأنها أشبه ما تكون بقصيدة مرتجَلة، من حيث اضطراب أبياتها وافتقادها بعضًا من مقوّمات التجربة الفنّيّة. وأنّ استعمال الشاعر لمجزوء البسيط فيها حال دون حرّيّة التعبير عن كلّ ما تجيش به نفسه من رؤًى وتأمّلات، ناهيك بالخلل الموسيقي الذي أحْدَثهُ هذا “البحر” ذلك أنّ التجارب تتطلَّب أوزانًا ملائمة تساعد على توفير النغم والاسترسال في تدفّق المعاني وانسيابها) ديوان عبيد ص 15 شرح: أشرف أحمد عدرة، دار الكتاب العربي، بيروت
و(من المُرَجَّح أنّ الشاعر قالها إثر غارة الحارث الأعرج، ملك بني غسّان، على بني أسد)- المصدر نفسه ص 19 وبنو أسد قومُه. ما دفعني إلى التأمّل في الظرف النفسي الذي مرّ به شاعر فحل مُتقِن جميع فنون الشِّعر في إثر نائبة نزلت على قومه، شاعر جاشت به مشاعر الكرامة والشهامة وإحساسُهُ بموسيقى الشعر مُرهَف، شاعر تأثّر بحادثة رهيبة فارتجل زهاء خمسين بيتًا من الشِّعر وعُدّتُهُ الشِّعريّة خيالٌ وتجربة وإحساس وإيقاع موسيقي، لم يَطُلْ عُمرُهُ ليدرك عَروض الخليل. ولا توقَّع يومًا ظهور عروض رقمي. ولم يحسب حسابَ ناقد سيأتي يومًا ليضع وزن قصيدته بين قوسين ويُثير ناقد آخر جدلًـا حوله، بعدما أظهر براعة في تحدّي امرئ القيس المُشار إلى شعره بالبنان في جميع مراحل تطوّر الشِّعر وقبلما طلب إليه المنذر أن ينشدها لشهرتها أو لروعتها. فلو ذهب باحث مدقِّق أبعد قليلًـا لفكّر في ما عكست قصيدة عبيد المرتجَلة من اضطراب في شخصيّة عبيد نفسه! واضطراب الشاعر وانفعاله وحسّاسيّته المفرطة حالات من الطبيعي أن تنتاب الشعراء وسائر ذوي الفكر الناضج وذواته، لذا كان الحكم على أحدهم بالموت بتُهمة مخالفة مزاج ما أو فكر أو عقيدة خطيئة عظمى، أسأل الله ألّـا يحسبها على من تورّط بها، مثلما سأل الشمّاس استيفانوس هامة شهداء المسيحيّة أثناء رجمه بالحجارة
أمّا بعد فلا دليل لديّ على أنّ عبيد بن الأبرص أوّل مَن نظم على ذلك الوزن المضطرب؛ لأنّي عثرتُ على قصيدة لاٌمرئ القيس في سبعة عشر بيتًا مصنّفة على طرازه، لكنّها عروضيًّا وبالمنظار الخليلي الذي تعوّدنا عليه أكثر رصانة من مُعَلَّقة عبيد. فأوّلًـا: مَن يدرس مُعَلَّقة عبيد يجد عددًا من مجزوءات البحور الخليليّة متجهة إلى إيقاعات المُعَلَّقة وليس العكس! لأنّ بحور الخليل ظهرت بعد زمن عبيد بحوالي قرنين من الزمان. وثانيًا: يجد صدور أبيات المُعَلَّقة بالمنظار الخليلي أقلّ رصانة من أعجازها، ما أدّى إلى اضطراب القصيدة. وثالثًا يجد غلطًا في نقل القصيدة عن أصلها وربّما حصل الغلط أثناء نسخها! والدليل: وجود مفردات مختلفة موضوعة في محلّ واحد للبيت الواحد، ما سنرى بعد قليل. والملاحظات الثلاث لم أقرأ في المواقع الالكترونية أن أحدًا أشار إلى واحدة منها. أمّا النقاد فما أخطأوا في الحكم على المُعَلَّقة باضطرابها عروضيًّا، لأنّ للرّأي العام كلمة مسموعة، لكنّ أحدًا منهم إذا كان مُنصِفًا فلا يستطيع أن يُنكر على عبيد سلامة إحساسه بالإيقاع. وسوف أثبت بأدلّة قاطعة أن الشاعر ما خرج عن الوزن في بيت ما من أبيات المُعَلَّقة. أمّا أحد الأدلّة على الغَلَط المذكور هو ما رُوِيَ عن قوله التالي؛ إذ طلب إليه قاتِلُهُ المَلِكُ المنذر بن ماء السّماء أن يُنشِدَهُ (أقفر من أهلِهِ ملحوبُ) قُبيل قيامِ الملك بقتله لكنّ عبيد قال
أقفرَ من أهلِهِ عَبيدُ * فليس يُبدي ولا يُعِـيدُ
عَـنَّتْ لهُ (مَنِيّةٌ) نكودُ * وحان منها لهُ ورودُ
والشارح روى البيت الثاني عن الأصفهاني بشيء مختلف
عَنّتْ لهُ “عَنّةٌ” نكودُ * وحان منها لهُ ورودُ- ص 132
ثمّ رواه من مصدر آخر، عن الأصفهاني أيضًا
عَنّتْ لهُ “خُطّةٌ” نكودُ * وحان منها لهُ ورودُ- ص 135
والملاحظ وجود ثلاث كلمات مختلفة في مكان واحد: (مَنِيّة، عَنّة، خُطّة) وهذا قد يمرّ عليه القارئ والقارئة مرور الكرام، إذا كانت الموسيقى آخر ما يفكّران به، لأنّ معنى البيت لن يتغيّر سواء أكانت الكلمة مَنِيّة أم عَنّةٌ أم خُطّة. فإليك معنى البيتين بحسب شارح الديوان: (حكَمْتَ عليّ بالقتل فأنا اليوم لا أقول شعرًا جديدًا ولا أكرّر ما قلتُهُ من شِعر) و(اعترضني حُكمُكَ بقتلي وأوشكتَ أن تُنفّذ هذا الحكم وتوردني الرّدى) انتهى
أمّا الإيقاع فمختلف، إذ جَعَلت “مَنِيّةٌ- بتشديد الياء” صَدْرَ البيت من الرَّجَز
عنّتْ لهُ مَنيّةٌ نكودُ= عَنْنَتْـلَهُو- مَنِيْـيَتُنْ- نكودُ= مُستفعِـلُنْ مَفاعِلُنْ فَعُوْلُ
لعلّ أصل الكلمة “مِيتة” ما يستقيم به وزن البيت، لكنّ حروفها أشبهت حروف “مَنِيّةٌ” فاختلف تنقيط الحرفين ما بين الميم والتاء المربوطة! بينما خدَمَت عَنّةٌ (أو خُطّة) موسيقى البيت بأكمله وجعلته من طراز سُمِّي مُخَلَّع البسيط وهو الإسم الشائع لوزن مُعَلَّقة عبيد، أو البسيط المُخَلَّع (أي المُنتَزَع) الذي بات اشتقاق وزنه وتسميته من محاور الجدل بين أهل العروض؛ منهم من اعتبره مُنتَزَعًا من البسيط ومنهم من اعتبره مُنتَزَعًا من المنسرح! والمعلوم أنّ المنسرح (مستفعِلُنْ مفعولاتُ مستفعِلُنْ) لم يألفه أهلُ العروض مجزوءً شأنه في ذلك شأن الطويل والسّريع. فبعد كتابة مُخلَّع البسيط (مستفعِلُنْ فاعِلُنْ فعُولُنْ) بالشكل التالي
مستفعِلُنْ فاعِلُنْ فَـ عُوْلُنْ= مستفعِلُنْ فاعلاتُ مُسْتَفْ
أمكن اعتباره و”مخلَّع المنسرح” اسمين لوزن واحد. فليس الإضطراب في مُعَلَّقة عبيد وحدها فحسب، بل في اتفاق أهل العروض على رأي نهائي. لذا رغِبتُ في حسم الخلاف على وزن المُعَلَّقة، بما لديّ من تجارب شعريّة ومن معرفة بالعروض، لأنّ شكل المنسرح “المجزوء” لا يغطّي إيقاعاتها المختلفة
وللتوضيح؛ حاولت اقتطاف التالي من قاموس لسان العرب بتصرّف: [المُخَلَّعُ من الشِّعر: مَفْعُولُنْ في الضرب السادس من البَسيط مُشتَقٌّ منه… ولمّا نُقِل مستفعِلُنْ بالقطْع إِلى مَفعُولُنْ بقِيَ وزنه، مِثل قوله: “ما هَيَّجَ الشَّوْقَ من أطلال، أضْحَتْ قِفارًا كَوَحْيِ الواحِي” فسُمِّيَ هذا الوزن مُخَلَّعًا؛ والبيت الذي أورده الأَزهري في هذا الموضع هو بيت الأسود: “ماذا وُقوفي على رَسْم عَفا، مُخْلَوْلِقٍ دارِس مُسْتَعْجِمِ” وقال: المُخَلَّع من العَرُوض ضَرْبٌ من البسيط] انتهى. ولتقطيع البيتين الواردين في هذا الإقتباس
ماذاوُقو- فِيْعَـلـا- رَسْمِنْعَـفا * مُخْلَوْلِقِنْ- دارِسِنْ- مُسْتَعْجِمِ
مستفعِلُنْ- فاعِلُنْ- مستفعِلُنْ، مثله وزن العَجُز- وهذا مجزوء البسيط
ما هَيْيَجَشْ- شوْقَمنْ- أَطْلالِنْ * أَضْحَتْقِفا- رَنكَوَحْ- يِلْواحِي
مستفعِلُنْ- فاعِلُنْ- مَفعُولُنْ، مثله وزن العَجُز- وهذا هو الشكل الأوّل لمُخَلَّع البسيط
وتعليقي: أوَّلًـا؛ لا اعتراض لأحد على تسمية مُخَلَّع البسيط التي أتى بها الخليل إذا ما اقتصر سببها على المقطوع (مَفعُولُنْ) لكنّ المشكلة هي أنّ الوزن الذي شاع عن مُخَلَّع البسيط هو (مستفعِلُنْ فاعِلُنْ فعُولُنْ) أي الذي دخل فيه الخبن فعُولُنْ على المقطوع مَفعُولُنْ، ما أدّى إلى اختلاف الإيقاع اختلافًا واضحًا وإنْ أجازه أهل العروض، نظرًا إلى أنّ الخبن زحاف جائز وليس عِلّة لازمة؛ مثالًـا قول عبيد
تصبو وأنَّى لكَ التَّصابي * أنّى وقد راعَكَ المَشِيبُ
تصْبُوْوَءَنْ- نالكَتْ- تَصَاْبِيْ * أَنْناوَقدْ- راعَكَلْ- مَشِيبُوْ
مُستفعِلُنْ فاعِلُنْ فعُولُنْ، مثله وزن العجز- وهذا هو الشكل الثاني لمُخَلَّع البسيط. وهو أكثر رصانة من مجزوء البسيط الذي مستفعِلُنْ هي عَروضُهُ وضربُها مثلها. وأكثر رصانة من الشكل الأوّل لمُخَلَّع البسيط الذي عروضهُ مستفعِلُنْ (أو أحد زحافاتها) وضربُها مَفعُولُنْ. وفي الشكل الثاني الجوهرة التي نالت استحسان ذوي الحسّ المرهف وذواته من الناس. أمّا الأكثر وضوحًا فهو اختلاف إيقاع فعُولُنْ كعروض وكضَرْبٍ عن مستفعِلُنْ كعروض وكضرب. فالإيقاع فعُولُنْ الذي دخل على مجزوء البسيط (مستفعِلُنْ- فاعِلُنْ- مستفعِلُنْ) يعتبر اضطرابًا مفيدًا في عروض مجزوء البسيط وفي ضربه الذي مثلها، بل أحيا هذا المجزوء إذ قلّما نظم عليه شاعر، أحياه بلباس جديد هو المُخَلَّع لولا اختلاف العروضيّين على طريقة انتزاعه التي أشرت إليها، ما زاد من الحاجة إلى إيجاد طريقة أفضل، لعلّها الطريقة المعتمدة في هذه المقالة
هل اللاحق من بحور الشِّعـر؟
ثانيًا؛ إنّ الوزن (مستفعِلُنْ فاعِلُنْ مستفعِلُنْ) من الأشكال الجارية في قصيدة عبيد وهو في رأيي كافٍ لتطبيقه على جميع أبياتها باستخدام الزحافات والعِـلل، فلا حاجة إلى ابتكار وزن جديد! مثالًـا؛ الوزن (مستفعِلاتُنْ، أربع مرّات) الذي ابتكره أبو الحسن بن حازم القرطاجنّي (ت 1386 م \ 684 هـ) في كتابه «منهاج البلغاء وسراج الأدباء» وأطلق عليه اسم “اللاحِق” على أنّه ألحَقَ قديمًا بجديد. وتحليل اللاحِق ليقارب المخلّع سهل بالتالي: مستفعِلا- تُنْ مُسْتفْ- عِلاتُنْ= مستفعِلُنْ- مفعُولُنْ- فعُولُنْ
لكنّ إيقاعَيهما مختلفان لاختلاف الحشو الأوسط في كليهما وهو فاعِلُنْ في المُخَلَّع ومفعُولُنْ في اللاحق. وللرصافي قصيدة غالبيّتها من وزن اللاحق، كانت من الأناشيد المدرسيّة في ماضي العراق، ما سيأتي الحديث عنه تباعًا للمقارنة ما بين الإيقاعين. فأعترف تاليًا بروعة ابتكار القرطاجنّي لكنّي لن أعتبره بحرًا مستقِلًّـا! لأنّ وزن اللاحق منتزَع من المنسرح بوضوح ساطع! فإذا حلّلت وزنه بشكل آخر هو التالي
مستفعِلا- تُنْ مُسْتفْعِ- لاتُنْ= مستفعِلُنْ- مفعُولاتُ- فعْلُنْ
فلا ينقص المنسرح سوى إضافة عِلُنْ إلى يسار فعْلُنْ للحصول على مُسْتفْعِلُنْ، لذا أخطأ القائل بأنّ “اللاحق” اسم جديد لمُخَلَّع البسيط! كما أنّ وزن كُلٍّ من اللاحق والمُخَلَّع لا يُلبّي حاجة قصيدةٍ إيقاعاتُها كالتي في مُعَلَّقة عبيد، إذِ اٌستُحسِن في أبياتها الحشو الأوسط فاعِلُنْ وإذْ قافيتها مزدوجة بالضَّربَين مفعُـولُنْ وفعُـولُنْ، عِلمًا أنّ المُعَلَّقة خالية من الحشو مفعُـولُنْ على الإطلاق، أي “اللاحق” لا يلحقها
أغلب الظّنّ
ثالثًا؛ قيل أنّ أبا العلاء المَعَرِّي، الذي كان علم العروض ضمن دائرة اهتمامه، قد عُنِيَ بهذا الوزن “مستفعِلُنْ فاعِلُنْ فعُولُنْ” ونظم شِعرًا عليه لكن دون أن يُسمِّيَه “مُخَلَّع البسيط” ودون أن تصِله هذه التسمية من أحد الرّواة وإن أحسّ هو وغيره باختلاف إيقاعه عن إيقاع (مستفعِلُنْ فاعِلُنْ مستفعِلُنْ) عِلمًا أنّه عاش الفترة 973 -1057م\ 363 – 449 هـ من العصر العباسي، أمّا الأزهري (لعلّ المقصودَ به: أبو منصور محمد بن أحمد الهرويّ) إذ عاش الفترة 895ـ980 م\ 282- 370 هـ من ذلك العصر فما وُجد دليل قاطع على أنّ التسمية “مُخَلَّع البسيط” منسوبة إليه إذ توُفِّيَ بعد ولادة المَعَرِّي بسبع سنين وما مِن سبب ليمنع راوية من إخبار أبي العلاء تلك التسمية. وتاليًا ضاعت هويّة صاحب التسمية وظهرت في محلِّها رواية أغلب الظّنّ؛ مثالًـا: نُسِبَت التسمية إلى الجوهري ولا أدري ما كان المقصود به إسماعيل بن حماد الجوهري (ت 393 هـ) صاحب مُعجم الصحاح، ما زاد من الحاجة إلى نسيان المُخَلَّع وإيجاد تسمية لائقة أفضل منه وأدق، لعلّها التسمية التي في عنوان هذه المقالة
* * *
وزن المُضطرِب
وزنه (مستفعِلُنْ فاعِلُنْ مستفعِلُنْ، مرّتين) والقافية في أبياته مزدوجة بضرب مقطوع مفعُولُنْ وبخبنه فعُولُنْ، أمّا الأفضل فصَقلُ الضروب كلِّها على الخبن. لبيته عروض واحدة مستفعِلُنْ جاز خبْنُها (مُتَفْعِلُنْ= مَفاعِلُنْ) وطيّها (مُسْتَعِلُنْ= مُفتَعِلُنْ) وقطْعُها (مَفعُولُنْ) الجائز فيه الخبن (فعُولُنْ) والمستحسَن. وللعروض أربعة أضرب؛ 1. مقطوع مفعُولُنْ الجائز خبنه والمستحسَن 2. فعُولْ بإسكان اللام إذ جاز في فعُولُنْ القصر 3. فعُولـاْنْ إذ جاز في فعولن التسبيغ. أمّا الحشو الأوّل مستفعِلُنْ فقد جاز فيه الخبن والطيّ وجاز الخبْل (مُتَعِلُنْ= فَعِلَتُنْ) لكنّه نادر وغير مُستَحَبّ. وأمّا الحشو الثاني فاعِلُنْ فقد جاز فيه الخبن فَعِلُنْ لكنّ الأفضل تجنّبه كي لا يلتبس وزن الشّطر أو العَجُز أو كلاهما مع وزن آخر ولا سيّما مجزوء الكامل المُرَفَّـل
* * *
الفرق بين المُضطرِب ومجزوء البسيط
هنا عودة سريعة إلى معرض البسيط لإلقاء بعض الضوء على مجزوءاته الثلاثة، إذ ورد أنّ لعَروضِهِ مُسْتَـفعِلُنْ ثلاثة أضرب: صحيح مُسْتَفعِلُنْ مثلها ومُذيَّل مُسْتَـفعِلانْ ومقطوع مُسْتَـفعِلْ أي مَفعُوْلُنْ. فنجد أنّ الشعراء قلّما نظموا على واحد منها بل نادرًا وتبدو ميتة! باستثناء المقطوع إذ دبّت فيه الحياة بعدما لحقه الخبن فعُولُنْ وهذا هو محور هذه المقالة وفيه السبب الدّاعي إلى تغيير اسم المُخَلَّع إلى المضطرب. وفي ما تقدّم مسألتان؛ الأولى: إمّا بَقِيَ الضّرب المقطوع في قصيدة ما بدون أيّ خبْن بقِيَت القصيدة بوزن مجزوء البسيط وبقِيَ انتماؤها إلى البسيط، لكنّ القطع إذا جرى فيها ولحقه الخبنُ أيضًا أصبحت القصيدة من المضطرب واضطرابُها نافع ورائع وهو الشائع. فسواء أجَرى القطع في القصيدة أم لم يَجْرِ فإنّ الخبن فعُولُنْ هو الزحاف المُفضَّل لِلضَرْب في المضطرب. والثانية: طالما اعتُبر التذييل (مُسْتَـفعِلانْ) من حصّة مجزوء البسيط فإنّ القصر فعُولْ (وهو من العلل التي بالنقص) والتسبيغ فعُولانْ (وهو من العلل التي بالزيادة) اللاحِقَين بالضّرب فعُولُنْ حصّتا المضطرب
* * *
المُضطرِب ومُعَلَّقة عَبِيد بن الأبرص
لا أظنّ أحدًا يلومني إذا ما رجعتُ بالزمن إلى أيّام الشاعر عبيد بن الأبرص ودخلتُ في عروقه، مثل جُزيئة كيميائيّة ذات عدسة ڤيديو أبحرت في دمه لكي تصل إلى أعماقه، لعلّها تكتشف مصادر الإيقاع الذي ارتجل عليه قصيدته التي عُدّت من كنوز الشعر العربي. فأردْتُ أن أبقى هناك لأختبر شعوره والحارث الأعرج يُغير على قومه بعصابة خاسئة. ويا ليت شِعري هل حالت عِزّة نفس الشاعر الذي كان سيِّدًا في قومِه دون إنشاد ملك ظالم شيئًا من شعره أم أنّه كان واثِقًا من تنفيذ الحُكم فيه مهما أنشده؟ لأنّ ذلك اليوم كان من أيّام بؤس الملك لا النعيم، بحسب ما رُويَ عنه. فأينما وصلت الدراسات السابقة حول مجزوء البسيط ومُخَلَّعه ما استطاع أصحابها الوصول إلى مصادر الإيقاع لدى الشاعر. هذا وإن سُمِعَـت صيحات مُخْلِصة، معدودة بالأصابع، لفصل المُخَلَّع عن البسيط فصلًـا تامًّا وللإعتراف باستقلاليّته. هنا أوَّلًـا مطلعُ القصيدة
أقفرَ مِن أهلِهِ مَلحُوبُ * فالقُـطَّبيّاتُ فالذَّنوبُ
أقفرَمِنْ- أهْلِهِيْ- مَلْحُوْبُو * فلقُطْطَبيْ- ياتُفَذْ- ذَنوبو
مُفْتعِلُنْ- فاعِلُنْ- مَفعُولُنْ * مُسْتَفْعِلُنْ- فاعِلُنْ- فَعُوْلُنْ
لاحظ-ي أنّ عروض البيت مَلْحُوْبُو= مفعولُنْ وضربها فعُولُنْ فالقصيدة ابتداء بأوّلها من المضطرب. تشاطرها قصيدة امرئ القيس التي أشرتُ إليها أعلى ومطلعها
عَيناكَ دَمْعُهُمَا سِجَالُ * كأنّ شأنيهِمَا أوشالُ
عَيْنَاكَدَمْ- عُهُمَا- سِجَالُ * كَأنْنَشَأ- نَيْهِمَا- أوْشَالُ
مُسْتَفْعِلُنْ- فَعِلُنْ- فَعُوْلُنْ * مَفاعِلُنْ- فاعِلُنْ- مَفعُولُنْ
وهنا قد يتساءل المرء؛ أليس شطر البيت من مجزوء الكامل ذي الضّرب المُرَفَّـل مُتَـفاعِلاتُنْ= فَعِلُنْ فَعُوْلُنْ؟ والجواب: أنت على صواب، لكنّ التشابه يحصل أحيانًا بين البحور، مثلما لوحظ بين مجزوء الكامل ومجزوء الرَّجَز في بيت الشاعر الرّصافي المذكور مثالًـا في معرض بحر الكامل وتحديدًا مجزوء الكامل
ناموا ولا تستيقِظوا * ما فاز إلا النُّوَّمُ
فهذا البيت إذا ما سُمِعَ مُفرَدًا ظنّ سامعه أنّه من مجزوء الرَّجَز. عِلمًا أنّ في مُعَلّقة عبيد صدورًا تُعَدّ من مجزوء الكامل المُرَفَّـل إذا ما سُمِعَ أحدُها بدون العجز، منها
واللهُ ليسَ لـهُ شَـرِيكٌ * عَلّـامُ مَا أخْفتِ القلوبُ
وَلْـلـاهُلَيْ- سَلَهُو- شَريكُنْ * عَلْـلـامُمَا- أخْفتِلْ- قلوبو
مُستَفعِلُنْ- فَعِلُنْ- فعُولُنْ * مُستفعِلُنْ- فاعِلُنْ- فعُولُنْ
وقد نوّهت أعلى بضرورة تجنّب الخبن في فاعِلُنْ، كما ذكرتُ أنّ صدور أبيات هذه المعلّقة أقل رصانة من أعجازها فلعلّ البيت السابق وأبياتًا لاحقة أخرى وراء الحكم على المعلّقة باضطراب وزنها ومنها
أَفلِحْ بِما شِئتَ فقد يُبلَغُ بالضَّعفِ وقد يُخدَعُ الأَريبُ
أَفلِحْبِما- شِئْـتَـفَـقـدْ- يُبلَغُبِضْ * ضَعْـفِوَقدْ- يُخدَعُلْ- أَريبُو
مُستَفعِلُنْ- مُفتعِلُنْ- مُفتعِلُنْ * مُفتَعِـلُنْ- فاعِلُنْ- فعُولُنْ
فالصدر من الرّجز، لكنّ الشّكّ في صحّة نقله، لأنّ حذف الفاء من “فقدْ” لا يخلّ بالمعنى، إنّما يصحّ الوزن: أَفلِحْ بما شِئتَ قد يُبلَغُ بالضَّعفِ وقد يُخدَعُ الأَريبُ
أَفلِحْبِما- شِئْـتَـقـدْ- يُبلَغُبِضْ * ضَعْـفِوَقدْ- يُخدَعُلْ- أَريبُو
مُستَفعِلُنْ- فاعِلُنْ- مُفتعِلُنْ * مُفتَعِـلُنْ- فاعِلُنْ- فعُولُنْ
وسبب الشكّ هو أنّ البيت التالي قد ورد تاليًا في ديوان الشاعر فقارن-ي بينهما
لا يعِظُ النّاسُ مَن لا يَعِظُ الدَّهرُ ولا ينفعُ التّلبيبُ
وإليك مثالًـا على النقل غير الدقيق، إذ ورد في ديوان الشاعر
ساعِدْ بأرضٍ إِذا كُنتَ بها * ولا تَقُل إنَّني غَريبُ
مُستَفعِلُنْ- فاعِلُنْ- مُفتعِلُنْ * مَفاعِلُنْ- فاعِلُنْ- فعُولُنْ
بينما ورد التالي في مصدر آخر للقصيدة وهو شاذّ عن إيقاعات عبيد
ساعِدْ بأرضٍ إِن كُنتَ فيها * ولا تَقُل إنَّني غَريبُ
ساعِدْبِئَرْ- ضِنْئِنْكُنْ- تَفِيها * وَلـاتَقُلْ- إِنْنَنِيْ- غَريبُو
مُستفعِلُنْ- مَفعُولُنْ- فَعُولُنْ * مَفاعِلُنْ- فاعِلُنْ- فعُولُنْ
فصَدرُ هذا البيت على وزن “اللاحق” المذكور أعلى
فكُلُّ ذي نِعمَة مَخلوسٌ * وكُلُّ ذي أَمَلٍ مَكذوبُ
فَكُلْلُذي- نِعمَتِنْ- مَخلوسُنْ * وَكُلْلُذي- أَمَلِنْ- مَكذوبُو
مَفاعِلُنْ- فاعِلُنْ- مفعُولُنْ * مَفاعِلُنْ- فَعِلُنْ- مفعُولُنْ
والشاعر هنا قد وضع العروض على مفعُولُنْ وتابعَها بضرب مثلها فكأنّه حاول موالفة الإيقاع بين الصدر والعجز، ما لم يفعل امرؤ القيس، كما في البيتين التاليين
عَدْوًا تَرَى بَيْنَهُ أبْوَاعًا * تَحْفِزُهُ أكْرُعٌ عِجَالُ
مُستفعِلُنْ- فاعِلُنْ- مفعُولُنْ * مُفتعِلُنْ- فَاعِلُنْ- فعُولُنْ
تُطْعِمُ فَرْخاً لـهَا صَغِيرًا * أزْرَى بهِ الجُوعُ والإحثالُ
مُفتعِلُنْ- فَاعِلُنْ- فعُولُنْ * مُستفعِلُنْ- فاعِلُنْ- مفعُولُنْ
والبيت الأوّل يقابل قول عبيد: مُضَبَّرٌ خَلْقُها تَضبيرًا * يَنشَقُّ عَن وَجهِها السَّبيبُ
مُضَبْبَرُنْ- خَلقُها- تَضبيرَنْ * يَنشَقْقُعَنْ- وَجْهِهسْ- سَبيبُو
مَفاعِلُنْ- فاعِلُنْ- مَفعُولُنْ * مُستفعِلُنْ- فاعِلُنْ- فعُولُنْ
أمّا الثاني فيقابل قول عبيد: فذاكَ عَصرٌ وقد أراني * تَحمِلُني نهدَةٌ سُرحوبُ
فَذاكَعَصْ- رُنْوَقَدْ- أَراني * تَحمِلُني- نَهدَتُنْ- سُرحوبُو
مَفاعِلُنْ- فاعِلُنْ- فَعُولُنْ * مُفتَعِـلُنْ- فاعِلُنْ- مَفعُولُنْ
وإليك مثالًـا على ورود العروض بوزن مُستفعِلُنْ
قد يوصَلُ النازِحُ النائي وقد * يُقطَعُ ذو السُهمَةِ القريبُ
قَدْيُوصَلُنْ- نازِحُنْ- نائيوَقَدْ * يُقطَعُـذُسْ- سُهْمَتِلْ- قَريبُو
مُستَفعِلُنْ- فاعِلُنْ- مُستَفعِلُنْ * مُفتَعِـلُنْ- فاعِلُنْ- فَعُولُنْ
يقابله بيت امرئ القيس التالي: صَابَ عَلَيْهِ رَبِيعٌ صَيّفٌ * كأنّ قُرْيَانَهُ الرِّحَالُ
ومثالًـا للعروض على مَفاعِلُنْ ما لم يرد مثله في قصيدة امرئ القيس
أَخلَفَ ما بازلـاً سَديسُها * لا حِقَّةٌ هِيْ ولا نَيوبُ
أَخْلَفَما- بازلـاً- سَديسُها * لـاحِقْـقَـتُنْ- هِيْوَلـا- نَيوبُو
مُفتعِلُنْ- فاعِلُنْ- مَفاعِلُنْ * مُستفعِلُنْ- فَاعِلُنْ- فعُولُنْ
أمّا أروع ما في المضطرب والأكثر رصانة فهو مجيء العروض وضربها على فعُولُنْ والحشو على فاعِلُنْ بدون الخبن (فعِلُنْ) ما جعلهُ مُحبّبًا إلى قرائح الشعراء في الماضي والحاضر ومُطرِبًا الآذان والنفوس، كما في قول عبيد: (أقفر من أهلهِ عبيدُ…) وقوله: (تصبو وأنَّى لكَ التَّصابي…) وفي التالي
أعاقِرٌ مِثلُ ذاتِ رِحْم * أم غنِمٌ مِثلُ مَن يَخِيبُ؟
أَعاقِرُنْ- مِثلُذا- تِرِحْمِنْ * أَمْغَنِمُنْ- مِثلُمَنْ- يَخِيبُو
مَفاعِلُنْ- فاعِلُنْ- فعُولُنْ * مُفتعِلُنْ- فاعِلُنْ- فعُولُنْ
قطّعْتُهُ غُدوةً مُشيحًا * وصاحبي بادنٌ خَبُوبُ
واقتطفت من قصيدة امرئ القيس التالي المفعَم بالرّصانة عينها
أوْ جَدْوَلٌ في ظِلالِ نخْلٍ * للمَاءِ مِن تحتِهِ مَجَالُ
مِن ذِكْرِ لَيْلى وأين ليلى * وخيرُ ما رُمْتَ ما يُنالُ
أخيرًا؛ كانت ملاحظات الشعراء والعَروضيّين القائلة بوجود اضطراب في وزن مُعَلّقة عَبيد وراء القول بأنّها (كادت ألّـا تكون شعرًا) لكنّ قولهم دلّ على قناعتهم بأنها موزونة مهما اضطربت في رأيهم! فلم يقولوا “كادت أنْ تكون نثرًا” لأنّ الوزن في أدب العرب هو ما يميّز الشعر من النثر وسيبقى يميّزه مهما طال الزمن
* * *
الأعشى قيس
ألمْ تَرَوْا إِرَمًا وعَادًا * أوْدَى بها اللّيلُ والنّهارُ
وقبْلَهمْ غالتِ المنايا * طَسْمًا ولمْ يُنْجِهَا الحِذارُ
وحَلَّ بالحَيِّ مِن جَدِيسٍ * يومٌ مِن الشَّرِّ مُسْتَطارُ… إلخ
* * *
بشار بن برد
قالوا العمى منظرٌ قبيحٌ * قلنا بفقدي لكُمْ يَهُـونُ
تاللهِ ما في البلاد شيءٌ * تأسى على فقدِهِ العـيونُ
هناك من نسب هذين البيتين إلى أبي العلاء المَعَرّي على أنّ كليهما كان ضريرًا
* * *
بشّار بن بُرْد وسَلْمُ الخاسِر
روى أبو الفرَج الأصفهاني (بتصرّف من الكاتب) بيتًا للشاعر سَلْم بن عمرو بن حمّاد الخاسر (ت 186 هـ) معناه مسلوخ من بيت لبشّار بن بُرد. فبلغ بيتُهُ بشار فغضب واستشاط وحلف ألّـا يدخل إليه ولا يفيده ولا ينفعه ما دام حَيًّا. فاستشفع سَلْم إليه بكل صديق له، وكل من يثقل عليه رده، فكلّموه فيه، فقال: أدخلوهُ إليّ، فأدخلوه إليه فاستدناه، ثم قال: إيه يا سَلم، من الذي يقول
مَن راقبَ الناسَ لم يظفر بحاجتِهِ * وفاز بالطَّيِّبات الفاتكُ اللهِجُ؟- من البسيط
قال: أنت يا أبا معاذ (كُنية بشّار) قد جعلني الله فداءَك! قال: فمن الذي يقول
من راقب الناس مات غمًّا * وفاز باللذة الجـسـورُ؟- من المضطرب
قال: تلميذك وخِرّيجك وعبدك يا أبا معاذ. فاجتذبه إليه وقنعه بمخصرة كانت في يده ثلاثًا وهو يقول: لا أعود يا أبا معاذ إلى ما تنكره، ولا آتي شيئا تذمّه، إنما أنا عبدك وتلميذك وصنيعتك. وما صُنِّف سَلْمُ الخاسِر من شعراء الطبقة الأولى على رغم موهبته، إنّما وُضِع في مرتبة أقل من الفحول الذين عاصَرَهُم
* * *
أبو نؤاس
من ديوان الشاعر ص 246
أعطتكَ رَيحانها العُـقارُ * وكان من ليلِكَ اٌنسفارُ
– – –
لا ينزلُ الليلُ حيثُ حَلَّتْ * فلَيلُ شُرّابها نهارُ
حتى لو اٌستُودِعَتْ سِرارًا * لمْ يخْفَ في ضوئها السِّرارُ
ما أسكَرَتْني الشَّمُولُ لكنْ * مُدِيرُ طرْفٍ بهِ اٌحْورارُ
البحتري
مِنِّيَ وَصْلٌ ومنكَ هجرُ * وفيّ ذلٌّ وفيكَ كبرُ
ومَا سَوَاءٌ إذا التقينَا * سَهْلٌ عَلى خُلّةٍ ووَعْرُ
إنّي وإنْ لمْ أبُحْ بوَجْدِي * أُسِرُّ فيكَ الذي أُسِرُّ
يَا ظَالِمًا لي بغيرِ جُرْمٍ * إلَيْكَ مِن ظُلمِكَ المَفرُّ… إلخ
* * *
أبو العلاء المعري
يموتُ قومٌ وراءَ قومٍ * ويثبتُ الأوّلُ العزيزُ
كمْ هَلكَتْ غادةٌ كعابٌ * وعَمَّرَتْ أمُّهـا العجوزُ
أحْرَزَها الوالدانِ خوفًا * والقبر حرْزٌ لها حَريزُ
يجـوز أنْ تُبطئَ المنايا * والخُلْدُ في الدَّهر لا يجوزُ
* * *
محمود سامي البارودي
توَازَنَ الصَّيْفُ والشِّتَاءُ * واعْتَدَلَ الصُّبْحُ والمَساءُ
واصْطَلَحَتْ بَعْدَ طُولِ عَتْبٍ * بينهُما الأرْضُ والسَّماءُ
تبتهِجُ العَيْنُ في رِياضٍ * أنضَرَها الماءُ والهَواءُ
مَنابتٌ زَرْعُها بَهِيجٌ * وغَـيْضَةٌ ماؤُها رَوَاءُ
يُرِيْدُ كُلُّ اٌمْرِئٍ مُناهُ * وَيَفْعَلُ اللهُ ما يَشاءُ
* * *
جميل صدقي الزهاوي 1
لا تتركنّ الشرور تنمو * فأَوّلُ النار من شرارِ
إنَّ لجَهْل النفوس شرًّا * حَذارِ من جَهْلِها حذارِ
إنْ كنت ترجو في البَرِّ مالًـا * فجُبْ لهُ واسعَ البراري
أوْ كنت في البحر تَرتَجيه * فاركبْ له غارب البحارِ
لا يضجر الحُرّ حين يَسعى * إلّـا مِن الذل والصَّغارِ
لاحظ-ي أنّ الصّدر: (إنْ كنت ترجو في البَرِّ مالًـا) يصلح مثالًـا على وزن اللاحق
* * *
معروف الرصافي
سَمِعْتُ شعرًا للعندليبِ * تلاهُ فوق الغُصْن الرطيبِ
إذ قال نفسيْ نفسٌ رفيعَهْ * لم تهْوَ إلّـا حُسْن الطبيعَهْ
عشقتُ منها حُسْن الربيعِ * أحسِنْ بذاك الحُسن البديعِ… إلخ
فجميع الأبيات مُصرَّعَة والقوافي منوّعَة وغالبيّتُها على وزن “اللاحق” باستثناء التالي وهو من المخلّع الذي أصبح اسمه اليوم: المضطرب
أطيرُ فيها لفرط وجدي * مِن غصن وردٍ لغُصنِ وردِ
يا قومُ إنّي خُلِقتُ حُرّا * لمْ أرضَ إلّـا الفضا مقرّا
وله ثلاثة أبيات جمع فيها الشاعر بين الوزنين ولا بأس لأنهما متقاربان، أحَدُها
فالعيش عندي فوق الغصونِ * لا في قصور ولا حصونِ
فلعَيشُعِنْ- ديْفوقلْ- غُصونِي * لافيقُصُوْ- رِنْوَلا- حصونِي
مستفعِلُنْ- مفعُولُنْ- فعُـولُنْ * مُستفعِلُنْ- فَاعِلُنْ- فعُـولُنْ
* * *
جبران خليل جبران
يا رفقة كُلّهُمْ أديبٌ * وكُلّهُمْ فاضِلٌ مُهذَّبْ
مِن رجُلٍ كامل اٌختبارٍ * قوَّمَهُ دَهْرُهُ وأدَّبْ
إنِ اٌتفقتُمْ أو اٌختلفتُمْ * للخير سَهْمٌ في كلّ مذهبْ
أضواؤكمْ في العيون شتّى * وكلّ تلك الأضواء كوكبْ
* * *
في وادي الحياة – نازك الملائكة
القصيدة مُنوّعة القوافي، كتبتها الشاعرة صيف سنة 1945 ومنها
عُدْ بيَ يا زورقي الكليلـا * فلن نرى الشاطئَ الجَميـلـا
كم زورق قبلنا تولَّى * ولم يَزَل سادرًا جَهـولـا
فعُدْ إلى معبدي بقلبي * وحَسْـبُ أيامنا ذُهـولـا
– – –
حَسْبُكَ يا زورقي مَسيرًا * لن يُخْدَعَ القلبُ بالسَّرابِ
واٌرجِعْ، كما جئتَ، غيرَ دار * قد حَلُكَ الجوُّ بالسَّحابِ
ومَلَّ مجدافُكَ المُعَنَّى * تَقلُّبَ الموج والعُبَابِ
ولم يَزَلْ معبدي بعيدًا * خلف الدياجيرِ والضبابِ
يَشُوقني الصَّمتُ في حِمَاهُ * وفتنة الأيك والرَّوابي… إلخ
* * *
ابراهيم طوقان
حلفتِ ألّـا تُكلّميني * وسوءُ حظّي قبل اليمينِ
إنْ ترحميني تُعذّبيني * أو تظلميني لا تُنصفيني
– – –
يا مَن هواها أجرى دموعي * وأشعلَ النارَ في ضلوعي
لمّا تيقَّنْتِ من خضوعي * حلفتِ ألّـا تكلّميني
– – –
عرفتِ وجدي وطولَ سُهدي * وكيف أرعى في الحبّ عهدي
اللهُ حسبي، أبَعْدَ وُدِّي * حلفتِ ألّـا تكلّميني؟
– – –
حملتُ في القلب منكِ غَمّا * أذاب جسمي لحْمًا وعظما
وكنتِ أقسى عليَّ لمّا * حلفتِ ألّـا تكلّميني
– – –
هذا فؤادي لديكِ رهنُ * ذُهِلتُ عنه فيما أظنُّ
غدًا أنادي إذا أحنُّ: * حلفتِ ألّـا تكلّميني
* * *
النهر الخالد- محمود حسن إسماعيل 1
مصر1910 – 1977
مُسافِرٌ زادُهُ الخيالُ * والسِّحرُ والعطرُ والظِّلالُ
ظمآنُ والكأسُ في يديهِ * والحبّ والفنّ والجمالُ
شابت على أرضِهِ الليالي * وضيَّعَتْ عُمرَها الجبالُ
ولم يَزَلْ ينشدُ الدِّيارا * ويسألُ الليل والنهارا
والناسُ في حبِّهِ سكارى * هاموا على شَطِّهِ الرّحيبِ
آهٍ على سِرِّكَ الرَّهيبِ * ومَوجكَ التائهِ الغريبِ
يا نِيلُ يا ساحرَ الغُـيوب… إلخ
تغنّى بها الموسيقار محمد عبد الوهاب
– – –
محمود حسن إسماعيل 2
زَأَرْتِ في حالِكِ الظلامِ * وقُمتِ مشدودة الزِّمامِ
للنور للبعث للأمامِ * لبأسِكِ الظافر العتيدِ
ومَجْدِك الخالد التليدِ * عَصَفتِ بالنار والحديدِ
وعُدتِ للنور من جديدِ * بغدادُ يا قلعة الأسودِ… إلخ
تغنّت بها السيّدة أمّ كلثوم في أعقاب الثورة العراقية على النظام الملكي سنة 1958
* * *
مثالًـا على الضرب المقصور فعُـوْلْ
والتالي أشطُر مُصَرَّعة من مُوشّح لشاعر أندلسي، على الأرجح، أردتُ الإشارة بها إلى جواز النّظم على المُضطرِب مشطورًا! شأنه شأن الرَّجَز والسّريع
علّقتُهُ أوْطَفًا كَحيلْ
يَحْسِدُهُ الغُصْنُ إذْ يَميلْ
تجولُ في ثغرهِ شَمولْ
رجُل أَوْطَفُ بَيِّن الوَطَف وامرأة وطْفاء إذا كانا كثيرَي شعر أهداب العين. والشَّمُول: الخَمْر لأنّها تَشمَل بريحِها الناس- لسان العرب
* * *
لأننا في الوجود- سعيد عقل
يا بعضَ ما أنتِ، هَلْ نوالْ * لموعدٍ باتَ في المُحالْ؟
ولي، إذا تذكُرينَ، عهدٌ * أبهى وأشهى مِن الخيالْ
يا طِيبَ ما اٌنهارَ فوق زَندي * ذَيّالِكَ الخصْرُ مِن دَلالْ
ورائحٌ حبّنا وغادٍ * على نجومٍ، على لَيالْ… إلخ
من ديوان الشاعر؛ المجلّد الثاني ص 12
* * *
مثالًـا على الضرب المُسبَّغ فـعُـولـاْنْ
الزهاوي 2
لا يغضَبِ النّاسُ مِنْ مقالي * إنْ قُلتُ: أصلُ الإنسانِ حَيْوانْ
فإنّ إنسانًا اٌبن قِرْدٍ * أفضَلُ مِنْ قِردٍ ابنِ إنسانْ
لا يَغضَبِنْ- ناسُمِنْ- مَقالي * إنْ قلتُأَصْ- لُلئِنسا- نِحَيْواْنْ
مُستفعِلُنْ- فاعِلُنْ- فعُولُنْ * مُستفعِلُنْ- مفعولُنْ- فعُولَـاْنْ
فإنْنَئِنْ- ساننِبْ- نَقِردِنْ * أفضلُ مِن- قِردِنِبْ- نِئِنْسانْ
مَفاعِلُنْ- فاعِلُنْ- فَعُولُنْ * مُفتَعِـلُنْ- فاعِلُنْ- فعُوْلَـانْ
وقد أسكِنتْ ياء حيوان للضرورة الشعريّة وهذا جائز. أمّا البيت الأوّل ففيه جمع بين المضطرب في صدره وبين اللاحق في عجزه
* * *
لعلّ خير ما أختم به هذه الحلقة مقطع من قصيدة مُعارِضَة لمُعَلّقة عبيد بن الأبرص. والقصيدة حلقة في سلسلة معارضة المُعَلَّقات العشر التي انفرد بها صاحب السلسلة عبر تاريخ الشِّعْـر العربيّ كُلِّه إذ لم يسبقه أحد إلى نظم مثلها وهي منشورة الكترونيًّا
رياض الحبيّب
سَبْعًا حكىٰ المَلِكُ المصلوبُ – لِسانُهُ مُحْكَمٌ عَجيبُ
الواهِبُ الإبن َ خيرَ أمٍّ – والإبنُ للرَّبِّ مُستجيبُ
عطشانُ لا يرتوي بماءٍ – ترويهِ مِن حُبِّها القلوبُ
أنتَ معي اليوم في الفردوس بَلْ – لكُلِّ مَن آمَنوا نصِيبُ
غفرانُهُ غيرُ مُستحَقٍّ – لولا على مَتْنِهِ الذنوبُ
قد أُكْمِلَ العَهْدُ في جديدٍ – ومِن نبوّاتِهِ الصّليبُ
إيلي لماذا تركْتَني، هلْ – تذكَّرَ الشعْبُ ما مكتوبُ؟
يا أبَتي في يَدَيْك رُوحِي – بالمَوتِ عَن خاصّتي أنوبُ
فاٌنشقّ عَن هَيكلٍ حِجابٌ – وعافهُ كاهِنٌ مُريبُ
للنّاس مفتوحة سَماءٌ – يأوي إلى الله مَن يتوبُ
مُعترِفًا بالمسيحِ رَبًّا – والصّوتِ: هذا اٌبنِيَ الحبيبُ
واٌنفتحتْ بَغتة قبورٌ – والمَوتُ مهما يَطُلْ مغلوبُ
حالَ إلى ظُلْمَةٍ فضاءٌ – لكنْ كسُوفٌ طغىٰ غريبُ… إلخ
* * *
موقع البشارة albishara.org موقع الإنجيل enjeel.com/search.php
موقع الباحث العربي baheth.info
¤ ¤ ¤ ¤ ¤