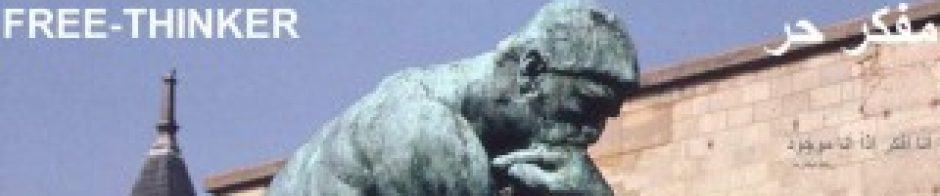هذه هي المقالة الثانية والعشرون من قراءتي النقدية لكتاب الدكتور يوسف القرضاوي ((الإسلام والعلمانية، وجها لوجه)). الكتاب في الرابط:
http://www.scribd.com/doc/28242163
يقول د. القرضاوي في مستهل هذا الفصل ص 153-172- تحت عنوان ((الشريعة وتجارب البشر: التجارب التاريخية للتطبيق الإسلامي)):
((ويقول العلمانيون: إنكم يا دعاة الحل الإسلامي، وأنصار تطبيق الشريعة، تدعوننا إلى إسلام مثالي، لا يوجد إلا في بطون الكتب نظريات ومبادئ، ولم يطبق في الواقع إلا فترة قصيرة هي فترة النبوة، ثم فترة الخلفاء الراشدين. بل يقول د. فؤاد زكريا: “أما التجارب التاريخية، فلم تكن إلا سلسلة طويلة من الفشل، إذ كان الاستبداد هو القاعدة، والظلم هو أساس العلاقة بين الحاكم والمحكوم، والعدل والإحسان والشورى، وغيرها من مبادئ الشريعة لا تعدو أن تكون كلاما يقال لتبرير أفعال حاكم يتجاهل كل ما له صلة بهذه المبادئ السامية. ولا جدال في أن لجوء أنصار تطبيق الشريعة، مهما اختلفت آراؤهم في الأمور التفصيلية، إلى الاستشهاد الدائم بعهد الخلفاء الراشدين، وبعمر بن الخطاب بوجه خاص، هو ـ في ذاته ـ دليل على أنهم لم يجدوا ما يستشهدون به طوال التاريخ التالي، الذي ظل الحكم فيه يمارس باسم الشريعة، أي أن التطبيق، الذي دام ما يقرب من ثلاثة عشر قرنا، كان في واقع الأمر نكرانا لأصول الشريعة، وخروجا عنها. إن أنصار تطبيق الشريعة يركزون جهودهم، كما قلنا، على الاستشهاد بأحداث ووقائع تنتمي إلى عصر الخلفاء الراشدين، ولا سيما عمر بن الخطاب، ولكن ألا يعلم هؤلاء الدعاة الأفاضل أن عمر بن الخطاب شخصية فذة فريدة، ظهرت مرة واحدة، ولن تتكرر؟! وإذا كانت تجارب القرون العديدة، وكذلك تجارب العصر الحاضر، قد أخفقت كلها في الإتيان بحاكم يداني عمر بن الخطاب، فلماذا يداعبون أتباعهم بالأمل المستحيل في عودة عصر عمر بن الخطاب؟! وإذا كان الخط البياني للحق والعدل والخير، قد ازداد هبوطا على مر التاريخ، وبلغ الحضيض، في التجارب المعاصرة لتطبيق الشريعة، فعلى أي أساس يأمل هؤلاء في أن تكون التجربة المقبلة، التي يدعون إليها في مصر، هي وحدها التجربة التي ستنجح فيما أخفقت فيه الأنظمة الإسلامية على مر القرون؟!)). انتهى.
قبل أن أواصل مع القرضاوي، هذه القراءة النقدية، بودي أن أبدي بعض التحفظات على مثل هذه المواقف غير العلمانية التي عبر عنها فؤاد زكريا وغيره من العلمانيين. ولقد تعرضت في المقالات السابقة لما رأيته أنه تنازلات تقدم للإسلاميين لأسباب عدة أبرزها، حسب رأيي، غياب أجواء الحرية في بيئاتنا العربية لإسلامية التي مازالت تهيمن عليها مجموعة من الطابوهات الممنوعة من التداول والنقد خاصة ما تعلق منها بالدين والتاريخ والسياسة والمرأة.
إن موقف العلمانيين كما عبر عنه القرضاوي: (( إنكم يا دعاة الحل الإسلامي، وأنصار تطبيق الشريعة، تدعوننا إلى إسلام مثالي، لا يوجد إلا في بطون الكتب: نظريات ومبادئ، ولم يطبق في الواقع إلا فترة قصيرة هي فترة النبوة، ثم فترة الخلفاء الراشدين))، هو موقف لا يرضي الإسلاميين رغم ما فيه من تنازلات نراهم يستغلونها حتى النخاع، وهي أخطاء ظل يقع فيها علمانيونا منذ بداية النهضة العربية بسبب الخوف من التكفير. فليس هناك في نظري إسلام مثالي سواء في عهد النبي محمد أم بعده، بأفكار وحلول وسياسات مثالية خارقة تتجاوز في سموها وحصافتها مستوى ما أبدعه البشر خارج التعاليم الدينية التي زعمت لنفسها مصادر ربانية متعالية. أجواء القمع والحصار فرضت على ثقافتنا العالمة والشعبية على السواء اعتقادات خرافية حول العصر الإسلامي الأول صُوِّرَ لنا عصرا مثاليا خارقا بلغت فيه الممارسات الأخلاقية والسياسية والحربية مستويات لا تداني من العدل والإنصاف والرشاد والإنسانية. هذا غير صحيح. وغير صحيح أيضا التصديق بفكرة أن الإسلام ((لم يطبق في الواقع إلا فترة قصيرة هي فترة النبوة، ثم فترة الخلفاء الراشدين)). فحتى هذه الفترة لم تكن قمة المثالية: نحن نعرف كل التجاوزات التي كان يرتكبها المؤسسون الأول للإسلام في حق بعضهم البعض وفي حق المهزومين الذين لم يكن أغلبهم يناصب العداء للمسلمين، سواء في فجر الإسلام أم طوال القرون.
ولقد حاول المتكلمون قديما خاصة المعتزلة القيام بدراسة نصوص الإسلام وتطبيقاتها باعتبارها أقرب إلى التجارب البشرية التي ينطبق عليها حكم الخطأ والصواب على الضد من رجال الدين الذين كانوا يرون الحكمة الإلهية وراء الخطأ ووراء الصواب بنفس القدر وبالتالي اعتبروا من قبيل الزندقة مناقشة هذه القضايا؛ فعارضوا بل دعوا إلى قمع مثيري مسائل مثل خلق القرآن وحرية الاختيار والعدل الإلهي والمسؤولية.
كان تبني فكرة خلق القرآن مثلا، موقفا علمانيا في الصميم، فالله حسب هذا الموقف أنزل القرآن تلبية لحاجات أملتها مناسبات محددة، ولهذا كان يتراجع فينسخها عندما تتغير الحاجات، وبما أن الحاجات تواصل تغيرها على مر الزمن أثناء نزول الوحي وبعد وفاة محمد فإن النسخ أو بالأحرى تجاوز التشريع بالتعديل والإلغاء يجب أن يتواصل تلبية لما يستجد من الحاجات. هذا ما جعل رجال الدين يشعرون بخطر حقيقي على مصدر رزقهم ونفوذهم فيتصدون لهذا الفكر. فكرة العدل الإلهي عند المعتزلة تفترض هي الأخرى تجاوز النصوص التي تعبر عن نقاء هذا العدل مثل قكرة القضاء والقدر التي تفترض القبول بالظلم الذي لا يتفق والتنزيه الواجب تجاه الله.
وعليه فلم يكن الإسلام نقلة نوعية خارقة في تاريخ البشرية كما يتوهم المسلمون من غير المطلعين بكفاية عليه. العلمانيون بتسليمهم بصحة هذه الخرافة يساهمون في جلب المياه إلى طاحونة الإسلاميين لتبقى تدور وتدور دون طحين. تلك التجربة كانت بشرية في الصميم بإنجازاتها وإخفاقاتها، بانحرافاتها ومغامراتها وحروبها الدموية التي طالت القاصي والداني من الشعوب. كما سنرى عما قريب عندما نتعرض للتجارب الإسلامية في تطبيق الشريعة كما يصفها القرضاوي ويدافع عنها ويقدم لنا منها أمثلة.
وعندما يقول فؤاد زكريا ((إن أنصار تطبيق الشريعة يركزون جهودهم.. على الاستشهاد بأحداث ووقائع تنتمي إلى عصر الخلفاء الراشدين، ولا سيما عمر بن الخطاب، ولكن ألا يعلم هؤلاء الدعاة الأفاضل أن عمر بن الخطاب شخصية فذة فريدة، ظهرت مرة واحدة، ولن تتكرر؟! وإذا كانت تجارب القرون العديدة، وكذلك تجارب العصر الحاضر، قد أخفقت كلها في الإتيان بحاكم يداني عمر بن الخطاب، فلماذا يداعبون أتباعهم بالأمل المستحيل في عودة عصر عمر بن الخطاب؟!)). عندما يقول هذا فهو بنظري يقدم تنازلات ويبعث في الناس أوهاما لا تستند إلى حقائق التاريخ. هل كان ((عمر بن الخطاب شخصية فذة فريدة، ظهرت مرة واحدة، ولن تتكرر؟!)). قد يكون عمر بن الخطاب موزعا عادلا للغنائم، ولكن عندما نعرف أن ما كان يوزعه كان في معظمه ثروات وخيرات انتزعت من أفواه المهزومين ليجوعوا حتى يشبع المسلمون الغالبون، كما كان يوزع سبايا وعبيدا كان يتم تحويلهم من أوطانهم مكبلين في الأغلال من طرف الغزاة المسلمين نحو عاصمة الدولة بعد كل غزوة في شكل مغانم (أفاء الله بها على المسلمين) بعد أن انتزعوهم بالغصب والاحتلال وفرض شروط مجحفة على المغلوبين في العراق والشام ومصر قبل أن يواصل الخلفاء بعده هذه (الفتوحات) في بلاد واسعة أخرى غزاها المسلمون ظلما وعدوانا شأنهم في ذلك شأن كل الغزاة.
نعم قد يعترض معترض فيقول بأن هذا كان السلوك العام في العالم يومئذ وهذا ما فعله القرضاوي في هذا الفصل عندما حاول إبراز نقائص التجارب الاشتراكية والديمقراطية مع التستر طبعا على أنها تجارب بشرية لم يدع لها مؤسسوها العصمة والقداسة ولهذا أمكن تجاوزها أو تعديلها وإلغاؤها وهذا ما لا يقبله مع الإسلام الذي ظل يُقَدَّمَ إلينا، نصوصا وتجارب، على أنها مثاليات خارقة لتطبيقات شريعة ربانية لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، ويطالبوننا بتصديقها والالتزام بها والامتناع عن نقدها رغم وقائعها المخزية التي تفقأ العيون.
لننتقل الآن إلى نقد القرضاوي لمواقف العلمانيين من تطبيق الشريعة. فبعد هذا الكلام ينطلق في مساجلة طويلة دافع فيها عن كل التاريخ الإسلامي حتى جعل الانحراف في الحكم استثناء والاستقامة قاعدة. يلخصها قول سيد قطب كما أورده القرضاوي: ((والشهيد سيد قطب (رحمه الله) رغم شدته على التاريخ الإسلامي، بعد عصر الراشدين، وحملته القاسية على بني أمية في كتابه “العدالة الاجتماعية في الإسلام” لم يسعه إلا أن يعترف بأن الإسلام ظل راسخ البناء، مرفوع اللواء، منفردا بالفتوى والقضاء والتشريع للأمة الإسلامية، في كل شئونها، اثنى عشر قرنا من الزمان)).
بناء على هذا القول يكتب القرضاوي منتقدا فؤاد زكريا على موقفه السابق باعتباره ((ينطوي على أغلاط أو مغالطات شتى))، يذكر منها ثلاثا:
((أول هذه الأغلاط أو المغالطات، هو اختزال عهد الراشدين كله إلى عهد عمر وحده، متجاهلين عهد أبي بكر (رضي الله عنه)، وما فيه من إنجازات هائلة، رغم قصره، حتى قال د. محمد حسين هيكل، في كتابه “الصديق أبو بكر”: أليست هذه بعض معجزات التاريخ؟! في سنتين وثلاثة أشهر، تطمئن أمم ثائرة، وتصبح أمة متحدة قوية، مرهوبة الكلمة، عزيزة الجانب، حتى لتغزو الامبراطوريتين العظيمتين، اللتين تحكمان العالم، وتوجهان حضارته، لتنهض بعبء الحضارة في العالم قرونا بعد ذلك)).
قبل أن أواصل ألفت نظر القارئ إلى أنه وبينما يجري اليوم إدانة الاستعمار وحتى الكنيسة المسيحية على أخطاء الماضي، ويسعى الأحفاد إلى تقديم الاعتذار على ما اقترفه الأسلاف في حق الشعوب، لا يزال القرضاوي يعتبر الغزو والاستعمار من ((معجزات التاريخ))، وكأن غزوات المسلمين كانت تستهدف فقط تحرير الشعوب من تلك الأمبراطوريتين العظيمتين.
ويقول ((ومتجاهلين ـ كذلك ـ السنوات الأولى في عهد عثمان (رضي الله عنه) وما حققت من رخاء ورفاهية في الداخل، وفتوحات وانتصارات في الخارج، كما يشهد بذلك التاريخ.))
مرة أخرى يفتخر القرضاوي بالفتوحات والانتصارات في الخارج، ولا يأبه لما كانت تحدثه من استرقاق واحتلال ودمار وطرد للشعوب من أوطانها.
((ومتجاهلين ـ كذلك ـ ما أرساه علي (رضي الله عنه وكرم الله وجهه) من مبادئ في سياسة الحكم، وسياسة المال، ومعاملة البغاة والخارجين على الإمام، برغم الصراع، الذي وقع بينه وبين الأطراف الأخرى)).
فهل الحروب الأهلية التي دارت رحاها بين الصحابة في خلافة علي، وكان بعضهم من المبشرين بالجنة، كانت مجرد صراع عاد. ونحن نعرف أنها كانت مذابح حقيقية لا تختلف عن غيرها من المذابح طوال تاريخ البشرية بالنظر إلى مستوى وبساطة وسائل الإبادة يومئذ.
(( والغلط الثاني أو المغالطة الثانية، هي الإدعاء بأن عمر كان فلتة لا تتكرر، فهو قول يكذبه الواقع التاريخي، فقد رأينا النموذج العمري يتكرر في صور مختلفة، وفي عصور مختلفة)).
والغلط الثالث أو المغالطة الثالثة، أن من الظلم البين لحقائق التاريخ أن نطلق الحكم على جميع خلفاء بني أمية، وبني العباس، وآل عثمان، وسلاطين المماليك في مصر والشام، وملوك المرابطين، والموحدين، وغيرهم في المغرب، وسلاطين المغول في الهند، وغيرهم: بأنهم كانوا ـ جميعا ـ ظلمة وفجرة، ومنحرفين عن عدل الإسلام، ونهج الإسلام)).
((فالواقع أن هذا ليس من الإنصاف في شيء، فقد كان من هؤلاء كثيرون، اتصفوا بكثير من العدل والفضل وحسن السيرة، ولا سيما إذا قورنوا بغيرهم من حكام العالم في زمنهم)).
بغض النظر عن هذه المغالطات الفادحة في حق التاريخ، فهل يجوز إسلاميا أن نقارن الحكام الإسلاميين بغيره من حكام العالم في زمانهم؟ طبعا لا، كيف يمكن مقارنة العاملين على هدي شريعة ربانية يصفها أصحابها بأنها جامعة مانعة شاملة بأفكار وسياسات بشرية ضعيفة حسبهم؟ ولعل هذا المأزق هو ما جعل القرضاوي وغيره يستميتون في الدفاع عنها ولو عبر تزوير حقائق التاريخ. فليس من المعقول أن تبتعد أمة يزعمون أنها لا تجتمع على ضلالة عن شريعتها الربانية. وعندما يتحدى العلمانيون الحظر المضروب ويكشفون للناس، اعتمادا على المصادر نفسها التي ينهل منها الإسلاميون، كل ذلك الكم الهائل من نماذج الحكم الإسلامية الاستبدادية السيئة، يقول القرضاوي: ((ولكننا كثيرا ما نأخذ أخبار تاريخنا من مصادر غير موثقة، وروايات غير ثابتة، لو عمل فيها مبضع “الجرح والتعديل” لم تقم لها قائمة)).
ثم يقول: ((فإذا نظرنا إلى رجل مثل هارون الرشيد، نجد الإخباريين والقصاصين صوروه، وكأنه رجل خلاعة وفجور، لا علاقة له بالعلم، ولا بالعمل، ولا بالعبادة، ولا بالجهاد، ولا بالعدل، ولا بالفضل. والواقع أن الوقائع الثابتة من سيرة الرجل، الذي بلغت الحضارة الإسلامية في عهده أوجها، والذي كان يغزو عاما، ويحج عاما، تكذب هذه الأقاويل المصنوعة، وقد دافع عنه ابن خلدون في مقدمته دفاعا علميا رصينا، يرد به على المتقولين والخراصين، وإن كانت حياته، لا تخلو من هنات غفر الله لنا وله)).
يقول القرضاوي ((هنات غفر الله لنا وله)) عن حاكم يغزو عاما ويحج عاما وكأن الغزو والاحتلال والسبي والاسترقاق وكل ما كان يساهم في مزيد من ذلك الترف الخيالي الذي كان يحياه الخلفاء وحاشيتهم ومتملقيهم. لنعتمد على ابن خلدون مثلما اعتمد القرضاوي عليه لنتعرف على حقيقة دواعي الجهاد وإلى أين كانت تذهب غنائم الغزو كما نعرف أن التصرف فيها ليس من قبيل الهنات أي الأخطاء البسيطة. كتب ابن خلدون في المقدمة ص 216-217: ((وانظر ما نقله المسعودي والطبري وغيرهما في أعراس المأمون (ابن هارون الرشيد) ببوران بنت الحسن بن سهل، وما بذل أبوها لحاشية المأمون حين وافاه في خطبتها إلى داره بفم الصلح، وركب إليها في السفين، وما أنفق في أملاكها، وما نحلها المأمون وأنفق في عرسها، تقف من ذلك على العجب. فمنه أن الحسن بن سهل نثر يوم الأملاك في الصنيع الذي حضره حاشية المأمون، فنثر على الطبقة الأولى منهم بنادق المسك ملثوثةً على الرقاع بالضياع والعقار، مسوغةً لمن حصلت في يده، يقع لكل واحدٍ منهم ما أداه إليه الاتفاق والبخت؛ وفرق على الطبقة الثانية بدر الدنانير في كل بدرة عشرة آلافٍ؛ وفرق على الطبقة الثالثة بدر الدراهم كذلك؛ بعد أن أنفق في مقامة المأمون بداره أضعاف ذلك. ومنه أن المأمون أعطاها في مهرها ليلة زفافها ألف حصاةٍ من الياقوت، وأوقد شموع العنبر في كل واحدةٍ مائة من وهو رطل وثلثان وبسط لها فرشاً كان الحصير منها منسوجاً بالذهب مكللاً بالدر والياقوت. وقال المأمون حين رآه: “قاتل الله أبا نواسٍ، كأنه أبصر هذا حيث يقول في صفة الخمر:
كَأنَّ صُغْرَى وَكُبْرَى مِنْ فَوَاقِعهَا حصباء در على أرض من الذهب
وأعد بدار الطبخ من الحطب لليلة الوليمة نقل مائةٍ وأربعين بغلاً مدة عامٍ كاملٍ ثلاث مراتٍ كل يومٍ. وفني الحطب لليلتين، وأوقدوا الجريد يصبون عليه الزيت. وأوعز إلى النواتية بإحضار السفن لإجازة الخواص من الناس بدجلة من بغداد إلى قصور الملك بمدينة المأمون لحضور الوليمة، فكانت الحراقات المعدة لذلك ثلاثين ألفاً، أجازوا الناس فيها أخريات نهارهم… (حتى ينتهى ابن خلدون إلى القول): (( وعلى قدر عظم الدولة يكون شأنها في الحضارة؛ إذ أمور الحضارة من توابع الترف، والترف من توابع الثروة والنعمة، والثروة والنعمة من توابع الملك، ومقدار ما يستولي عليه أهل الدولة. فعلى نسبة الملك يكون ذلك كله)).
هذا نموذج لحكم الشريعة الإسلامية في أعز مجد الإسلام. وبما أن القرضاوي استشهد بابن خلدون فمن المفروض ألا تكون مقدمته ((مصادر غير موثقة، وروايات غير ثابتة))، حسب القرضاوي، خاصة وابن خلدون يدافع عن الخليفة المأمون رافضا بعض ما كان يروى عنه مما يمكن اعتباره خدشا (في دينه وعلمه واقتفائه سنن الخلفاء الراشدين من آبائه، وأخذه بسير الخلفاء الأربعة أركان الملة ومناظرته للعلماء وحفظه لحدود الله تعالى في صلواته وأحكامه)). (المقدمة أيضا ص 27). فكيف كانت حال غيره؟
ابن خلدون، على الأقل، اعتبر هذا الترف أمرا طبيعيا من توابع الملك ولم يكن يراه خروجا عن الشريعة الإسلامية، أما القرضاوي وسيد قطب وغيرهم من الإسلاميين المعاصرين فيتسترون عليه، ولا يهمهم من تاريخ الإسلام إلا تطبيق الشريعة التي كان يشرف عليها رجال الدين فيحققون من هذه المهنة جاها وثراء على حساب عامة الناس المسحوقين والمخدوعين ولعل هذا ما يطمحون إليه اليوم وهم يؤيدون حكومات الاستبداد التي تطبق الشريعة الإسلامية أو تلك التي تتقاسم معهم بعض النفوذ على العامة فيتولى رجال الدين وازع القرآن كرديف لوازع السلطان الذي يتولاه الحكام.
إلا أن القرضاوي يضطر إلى التنازل حد الوقوع في تناقضات صارخة عندما ينقل عن صديقه محمد الغزالي وهو يجيب عن السؤال: ((بم تفسر النكسات التي أصابت الأمة الإسلامية، بدءا من الخلاف الداخلي بين علي ومعاوية، حتى يومنا هذا)).
فها نحن أمام نكسات تواصلت منذ الصراع بين علي ومعاوية إلى يومنا هذا !!!
أجاب الغزالي ((أجمع أولو الألباب من عدو وصديق، على أن الإسلام عقائد وشرائع، وعبادات ومعاملات، وأخلاق ونظم، وتراتيب إدارية وتقاليد اجتماعية، وأنه يكلف أتباعه بتطويع الشئون العادية لخدمة ذلك كله. وكنا في أثناء دراستنا الإسلامية، نعرف الفرق بين الإسلام والفكر الإسلامي، وبين الإسلام والحكم الإسلامي، الإسلام وحي معصوم، لا ريب فيه أما الفكر الإسلامي، فهو عمل الفكر البشري في فهمه، والحكم الإسلامي هو عمل السلطة البشرية في تنفيذه، وكلاهما لا عصمة له. ومن هذا التقديم يظهر أنه لا غرابة في وجود أخطاء في تاريخنا الثقافي والسياسي، وإنما الغرابة في التستر على هذه الأخطاء، أو الاستحماق في معالجتها، والتعفية على آثارها.
وجمهور المسلمين يعلم أن سلفنا الأول شغله قتال الاستعمارين الروماني والمجوسي، ولعله أشرف قتال عرفته الدنيا، ولكنه يشعر بغضاضة وألم، لما أعقب ذلك من قتال داخلي بين المسلمين أنفسهم، كانت له آثار بعيدة المدى، على حاضرهم ومستقبلهم. وجمهور الفقهاء والمؤرخين والدعاة يؤكد على أن علي بن أبي طالب “الخليفة الرابع” كان إمام حق، وأن معاوية بن أبي سفيان كان يمثل نفسه وعصبيته، في خروجه على “علي”. وشاء الله أن يكسب معاوية هذه المعارك، ومن ثم تحولت الخلافة الراشدة إلى ملك عضوض في بني أمية)). انتهى.
وهذا كان رأي فؤاد زكريا وفرج فوده في تحفظهما على دعوات تطبيق الشريعة باعتبار التطبيق عملا بشريا يخطئ ويصيب، فلماذا اتهمهما القرضاوي بالكفر ووقف مع قتلة فوده ؟ فمن يتستر على الأخطاء ومن يستحمق في معالجتها ومن يقف حجر عثرة ضد كل محاولات الخروج من الاستبداد السياسي الذي يتخذ الإسلام درعا ضد التجديد والحريات والديمقراطية والعلمانية؟
يتبع
عبدالقادر أنيس فيسبوك