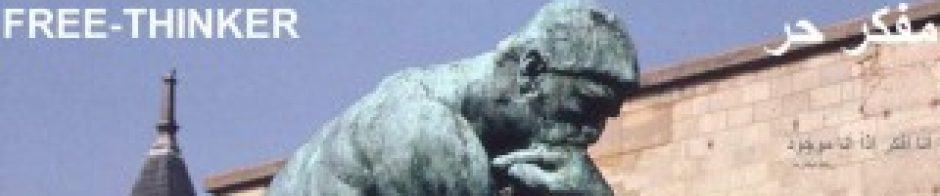بالفيديو الشريف المكي الصخيرات من المغرب, يشفي الناس من جميع الامراض بما فيها السرطان والايدز بلمس المناطق الحساسة والتقبيل, يدعي ان لديه طافة خارقة منحه اياها الله سبحانه وتعالي قادرة على التدمير وليس فقط على الشفاء يرتاده عشرات الآلاف في البوسنة والمغرب يوميا
-
بحث موقع مفكر حر
-
أحدث المقالات
-
- لفهم حرب #التعريفات_الجمركية التي يشنها #ترامببقلم طلال عبدالله الخوري
- #زياد_الصوفي يفتح ملف #سامر_فوز لمن يهمه الامربقلم زياد الصوفي
- ** هَل سيفعلها الرئيس #ترامب … ويحرر #العراق من قبضة #نظام_الملالي **بقلم سرسبيندار السندي
- ** ما علاقة حبوب الكبتاغون … بانتصارات نعيم قاسم وحزبه **بقلم سرسبيندار السندي
- ** فوز عون وسلام … صفعة أخرى لمحور المتعة والكبتاغون **بقلم سرسبيندار السندي
- ** هل جحيم كاليفورنيا … عقاب رباني وما الدليل **بقلم سرسبيندار السندي
- #سورية الثورة وتحديات المرحلة.. وخطر #ملالي_طهرانبقلم مفكر حر
- #خامنئي يتخبط في مستنقع الهزيمة الفاضحة في #سوريابقلم مفكر حر
- العد التنازلي والمصير المتوقع لنظام الكهنة في #إيران؛ رأس الأفعى في إيران؟بقلم مفكر حر
- #ملالي_طهران وحُلم إمبراطورية #ولاية_الفقيه في المنطقة؟بقلم مفكر حر
- بصيص ضوء على كتاب موجز تاريخ الأدب الآشوري الحديثبقلم آدم دانيال هومه
- آشور بانيبال يوقد جذوة الشمسبقلم آدم دانيال هومه
- المرأة العراقية لا يختزل دورها بثلة من الفاشينيستاتبقلم مفكر حر
- أفكار شاردة من هنا هناك/60بقلم مفكر حر
- اصل الحياةبقلم صباح ابراهيم
- سوء الظّن و كارثة الحكم على المظاهر…بقلم مفكر حر
- مشاعل الطهارة والخلاصبقلم آدم دانيال هومه
- كلمة #السفير_البابوي خلال اللقاء الذي جمع #رؤوساء_الطوائف_المسيحية مع #المبعوث_الأممي.بقلم مفكر حر
- #تركيا تُسقِط #الأسد؛ وتقطع أذرع #الملالي في #سوريا و #لبنان…!!! وماذا بعدك يا سوريا؟بقلم مفكر حر
- نشاط #الموساد_الإسرائيلي في #إيرانبقلم صباح ابراهيم
- لفهم حرب #التعريفات_الجمركية التي يشنها #ترامب
أحدث التعليقات
- لقمان منصور on من يوميات إمرأة حلبجية
- سوري صميم on فضح شخصية الشبيح نارام سرجون
- سيف on ألحلول المؤجلة و المؤدلجة للدولار :
- bouchaib on شاهد كيف رقصت رئيسة كرواتيا مع منتخب بلادها بعد اخراجهم فريق المجرم بوتين
- Saleh on شاهد كيف يحاول اغتصابها و هي تصرخ: ما عندكش اخت
- س . السندي on #زياد_الصوفي يفتح ملف #سامر_فوز لمن يهمه الامر
- س . السندي on الايمان المسيحي وصناعة النبؤات من العهد القديم!
- تنثن on الايمان المسيحي وصناعة النبؤات من العهد القديم!
- Hdsh b on الايمان المسيحي وصناعة النبؤات من العهد القديم!
- عبد يهوه on اسم الله الأعظم في القرآن بالسريانية יהוה\ܝܗܘܗ سنابات لؤي الشريف
- عبد يهوه on اسم الله الأعظم في القرآن بالسريانية יהוה\ܝܗܘܗ سنابات لؤي الشريف
- منصور سناطي on من نحن
- مفكر حر on الإنحراف الجنسي عند روح الله الخميني
- معتز العتيبي on الإنحراف الجنسي عند روح الله الخميني
- James Derani on ** صدقوا أو لا تصدقو … من يرعبهم فوز ترامب وراء محاولة إغتياله وإليكم ألأدلة **
- جابر on مقارنة بين سيدنا محمد في القرآن وسيدنا محمد في السنة.
- صباح ابراهيم on قراءة الفاتحة بالسريانية: قبل الاسلام
- س . السندي on ** هل تخلت الدولةٍ العميقة عن باْيدن … ولماذا ألأن وما الدليل **
- الفيروذي اسبيق on مقارنة بين سيدنا محمد في القرآن وسيدنا محمد في السنة.
- س . السندي on مقارنة بين سيدنا محمد في القرآن وسيدنا محمد في السنة.
- عبد الحفيظ كنعان on يا عيد عذراً فأهل الحيِّ قد راحوا.. عبد الحفيظ كنعان
- محمد القرشي الهاشمي on ** لماذا الصعاليك الجدد يثيرون الشفقة … قبل الاشمزاز والسخرية وبالدليل **
- عزيز الخزرجي فيلسوف كونيّ on أفضلية الإمام عليّ (ع) على آلرُّسل :
- عزيز الخزرجي فيلسوف كونيّ on أفضلية الإمام عليّ (ع) على آلرُّسل :
- عزيز الخزرجي فيلسوف كونيّ on أفضلية الإمام عليّ (ع) على آلرُّسل :
- س . السندي on رواية #هكذا_صرخ_المجنون #إيهاب_عدلان كتبت بأقبية #المخابرات_الروسية
- صباح ابراهيم on ** جدلية وجود ألله … في ضوء علم الرياضيات **
- س . السندي on الفيلم الألماني ” حمى الأسرة”
- Sene on اختلاف القرآن مع التوراة والإنجيل
- شراحبيل الكرتوس on اسطورة الإسراء والمعراج