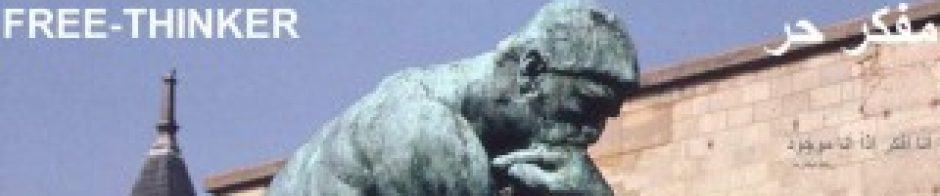بقلم موسى الحسيني
بقلم موسى الحسيني
هناك ملاحظة قد لم ينتبه لها البعض وهي ان الاجيال الجديدة من رجال الدين من الطائفتين الشيعية والسنية هم عادة من الطلبة الفاشلين في دراساتهم ومن محدودي الذكاء، وبعضهم من ابناء الشوارع الذين قضوا طفولتهم ومراهقتهم على هامش الحياة يتنقلون بين اعمال وافعال ومهن متواضعة او وضيعة.
بالنسبة لرجال الدين الشيعة في العراق ومنذ الحرب العراقية الايرانية، نجد ان غالبيتهم من الجنود الهاربين من الخدمة العسكرية، فالنظام العراقي والى يوم الاحتلال، يفرض على الطالب الفاشل ان يخضع لقانون الخدمة العسكرية الالزامية عند بلوغه 18 سنة، والكثير منهم يحاول التهرب من الخدمة الالزامية ب باساليب التحايل على القانونن بدعوى العجز او الجنون او غيرها ومنهم اكتشف ان التسجيل في المدارس الدينية يؤجل خدمتهم العسكرية فتهافتوا على تلك المدارس لا ايمانا ولا رغبة في تعلم الدين والفقه بل الهروب من الواجب الوطنين اي ان كل مايربطهم بالدين هو انه وسيلة تحايل، الغاية منها الخلاص من الخدمة العسكرية .
وبعد الاحتلال غدا الدين من افضل وسائل الارتزاق ، فلم ينزع احدهم العمامة حتى مع الغاء قانون الخدمة الالزامية، لانهم اكتشفوا ان مهنة الدين توفر لهم حياة رفاهية لايمكن ان يحققوها في مجالات الحياة الاخرى بحكم تدني قدراتهم العقلية والمعرفية، لذلك فهم يلجئون الى متابعة ما هو تافه متدني من الكتب بلغته ومنهجه الاسطوري الذي يعتمد اختلاق القصص الخرافية الاقرب للهلوسة منها عن كرامات الائمة ومكانتهم، وقد يصل بعض هذه الروايات الى حد الشرك دون فهم ان مكانة ال البيت قد بُنيت على اساس تمسكهم بالشريعة وايمانهم المطلق بالخالق وقدراته ، وليس منافسة لمكانته او لعرشه . رجال الدين هؤلاء لا علاقة لهم بالاسلام كدين، فهم لايفهموا منه الا بحدود ما تراه الادبيات الطائفية البحتة، لذلك فهم طائفيين لا تفضيلا لها على غيرها من الطوائف نتيجة مقارنة عقلية او معرفية بين المدارس الفقهية المختلفة،بل هم يتحزبون ويتعصبون للطائفة كمصدر للعيش والرزق والرفاهية، اي انه موقف دفاع عن مصالح شخصية مرتبطة مصيريا بالوضع الطائفي الشاذ.
لناخذ مثلا اكثر شخصيتين شهرة بين رجال الدين الشيعة اليوم، عمار الحكيم ، ومقتدى الصدر، ولنتابع ما الذي قدماه للدين الاسلامي عموما ما يمنحهم الان الامتيازات والاموال والمكانة الاجتماعية التي تؤهلهم للتدخل بالشؤون العامة للعراقيين ! لن يجد اي باحث او مدقق في تاريخ حياتيهما او سيرتيهما ما يمكن ان يمثل خدمة للدين او حتى للطائفة بما يستحق ان يتمتع به بكل هذه الامتيازات، علاقتهم بالدين تُختزل في انهم ابناء او احفاد مراجع سابقين، مع ان الخالق قال في كتابه الكريم ان الدين والايمان لايورث حتى لابناء الانبياء، وابن نوح خير مثال على ذلك. فعمار لبس العمامة ليتهرب من الخدمة العسكرية الالزامية في ايران كمواطن ايراني، كما تثبت وثائق سيرته ذلك، ولا يختلف موقف مقتدى كمواطن عراقي عن ذلك .
بالنسبة لرجال الدين السنة في العراق. فنظام القبول في الكليات المختلفة يستنذ لمعدل لطالب في المرحلة الثانوية، وتتدرج المعدلات من الطب والصيدلة والهندسة الى الحقوق والاقتصاد والسياسة وغيرها من الفروع، وحصل منذ السبعينيات ان بدات الجامعات بعدم قبول اصحاب المعدلات الاقل من الستين بالمئة، ولم يعد للطالب ذو المعدل المتدني الذي يرغب بمواصلة التعليم اما السفر للدراسة على حسابه الخاص في الخارج، او اداء الخدمة العسكرية او دخول كلية الشريعة التي بقيت مفتوحة امام المعدلات القليلة، فأصبحت هذه الكلية تجمعا للفاشلين او محدودي الذكاء ممن لم يتمكنوا من حيازة المعدل المطلوب لدخول الكلية التي كانوا يرغبون بها او التي يمكن ان تؤهلهم لمستقبل مهني او اجتماعي افضل. وهكذا اصبح الدين بالنسبة لهم مجرد وسيلة عيش، كما كان وسيلة لتخلصهم من متاعب الخدمة العسكرية.
فلا غرابة ان نجد بعض رجال الدين السنة ان تتحكم فيه نزعة التكابر والتظاهر بانه يمتلك الحقيقة المطلقة وانه على علاقة مباشرة بالخالق من خلال الادعاء برؤية النبي في احلامه ! اما رجال الدين الشيعة فانهم يلتقون ويرون في احلامهم الامام المهدي المنتظر!…هذه الظواهر لايمكن تفسيرها الا بالكذب والنصب والتحايل على الله ونبيه وال بيته لخداع المتلقي اوالتابع اوالمريد، والكذب والتحايل هذا يعكس حالة دونية تنتفي فيها المفاهيم الاخلاقية، انها حالة سقوط اخلاقي لابل هي هلوسة تؤشر الى مرضي الانفصام الشخصي (الشيزوفرينيا). فالدين بالنسبة لهؤلاء وسيلة للعيش والحصول او كسب متاع الدنيا والمتع بكل الطرق. لذلك تغدو الفتاوى الشاذة والغريبة والمنكرة كافضل الطرق للشهرة وكسب الملذات التي حُرم منها قياسا لذوي المهن الناجحة، (لهذا سمعنا بفتاوى بول البعير ونكاح الوداع ونكاح الجهاد والترويج للمتعة وارضاع الكبير والدعوة لتحجب الشاب الجميل وجواز استخدام المراة للجزر لاشباع رغبتها وغيرها مما هو شاذ وتافه من الفتاوى التي تعكس نفسيات مريضة).
تلك هي خصائص غالبية رجال الدين المسلمين من كل الطوائف والمذاهب والملل. انهم رجال دين “اسلام الصهيونية المعولمة” (طول لحيتك، وامسك مسبحة وضع المحابس في اصابعك وتظاهر بالتدين)، اصنع ما شئت ابتداء من السرقة والكذب والزنى وحتى القوادة، ناهيك عن القتل والخطف والتدمر والتخريب والتعامل مع المخابرات الاجنبية، فكل ذلك هو “الدين”، ومن يعترض فاولئك هم الكفار.
تلك هي شريحة النخبة التي يخضع لها المجتمع الأسلامي اليوم والتي تروج لها وسائل الاعلام الدولية والعربية. الواقع هو اننا واقعين تحت تاثير وقيادة جهالنا واغبيائنا والجماعات الحاقدة على الانسانية والفاقدة للشعور بالمسؤولية الدينية والوطنية والاخلاقية. وعلينا ان نتوقع من رجال الدين هؤلاء كل شئ منحرف لانهم يمتلكون القدرة باسم الله ونيابة عنه ان يخطئوا ويكفروا المجتمع ان رفض انحرافاتهم وشذوذهم وسقوطهم وفشلهم في الحياة.
المصدر الأصلي —– مجموعة العراق فوق خط أحمر —–