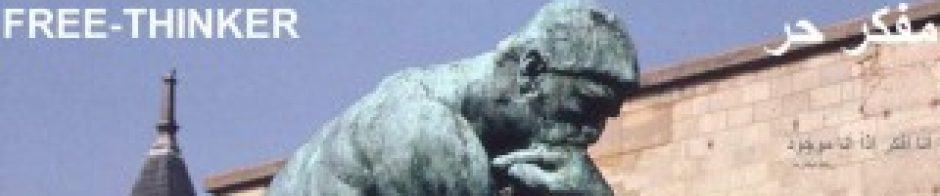كامل النجار
لا يختلف اثنان، حتى بين رجال الدين الإسلامي أنفسهم، في أن الأمة الإسلامية أي خير أمة أُخرجت للناس، تحتل المرتبة الدنيا في سلم الحضارة والرقي، وعداوتها للمرأة تكاد أن تفوق عداوتها لليهود والنصارى. حتى في دول إفريقيا الجنوبية سادت الديمقراطية وانتخبت جمهورية ليبريا السيدة الين جونسون سيرليف رئيسة لفترتين متتاليتين، ونحن مازلنا نمنع المرأة من قيادة السيارة وكشف وجهها. أفلا يجب علينا محاولة معرفة السبب في هذا التخلف، وإذا عرفناه، ألا يحق لنا نقده ومحاولة تقويمه؟
أعتقد أن الغالبية العظمى من القراء تعزو هذا التخلف إلى الإسلام وشيوخه المتاجرين به على حساب كرامة الإنسان المسلم. وهذا هو اعتقادي الذي لا يخامرني أي شك به. وقد قارنت مراراً بين الشعوب الهندية والباكستانية وشعب بنغلاديش. فجميعهم من اثنية واحدة، وكانوا يعيشون في الهند الكبيرة حتى عام 1948 عندما طالب السيد محمد علي جناح بإقامة وطن منفصل للمسلمين، فقامت باكستان الكبرى التي انفصلت فيما بعد إلى باكستان وبنغلاديش. وليقارن أي شخص الآن بين المستوى الذي وصلت إليه الهند وبين باكستان أو بنغلاديش. فالعامل الوحيد في تخلف الأخيرتين هو الإسلام
وعندما ننتقد الإسلام يرد بعض الكتاب بأن نقد الإسلام يجب أن يكون علمياً، ولا أدري ماذا يقصدون. هل الإسلام علم حتى ننقده نقداً علمياً. فهل إذا انتقدت قصيدة لامريء القيس مثلاً، يتحتم عليّ أن يكون نقدي علمياً أم أدبياً؟ ناقد الشعر ينتقد النظم وقواعد القصيدة والتزامها البحور المتعارف عليها، ثم يتحدث عن محتواها وربما يقارنها بقائد شعراء آخرين. والقرآن ما هو إلا سجع يحتوي على أخطاء عديدة في اللغة وفي المحتوى. فهل يجب أن يختلف نقده عن نقد الشعر، مثلاً؟ وربما يقول بعض المعلقين أن نقدنا طائفي لأننا لم ننتقد اليهودية والمسيحية. ولكن الإشكال هنا أن كل القراء يعرفون أن الديانات “السماوية” الثلاث تتشابه في تعاليمها الجزرية لأن أصلها واحد وهو الوصايا الموسوية. وإذا انتقدنا رب الإسلام، وهو أحدث الأديان الثلاثة، يصبح نقده نقداً لكل الأديان لأن القرآن نفسه يكرر علينا في آيات عديدة أن رب اليهود ورب المسيحيين (النصارى) هو نفس الإله (إلهنا وإلهكم واحد). فإذا انتقدت رب الإسلام لا يتحتم عليّ أن انتقد يهوه أو إلوهم أو ابن الإنسان، فكلهم يرمزون إلى نفس الكيان الغيبي الاسطوري الذي نعتقد أنه في السماء.
نحن الآن في نفس الوضع الذي كانت فيه أوربا في القرون الوسطى قبل مرحلة التنوير. خرجت أوربا من مرحلة الظلام التي تربعت على عرشها الكنيسة الكاثوليكية بمجهود فلاسفة التنوير. فماذا فعل أو كتب هؤلاء الفلاسفة حتى تسنى لهم الخروج بأوربا من محنتها؟ هؤلاء الفلاسفة كتبوا عن الوجود وهل له خالق أم لا، ثم انتقدوا تعاليم الكنيسة وإلهها الذي صورته لهم على أنه مرسل الزلازل والبراكين ليعاقب بها الخارجين على الكنيسة. ولم ينتقد أي منهم الإسلام أو حتى يذكره. هدفهم كان إخراج أوربا من الظلمات إلى النور.
فترة التنوير بدأت في القرن السابع عشر واستمرت في القرن الثامن عشر، ولكن قبل ذلك سبقتها إرهاصات من القلائل المتنورين والذين أغضبوا الكنيسة. منهم الفونس ملك كاستيل بإسبانيا (توفي عام 1284) عندما قال: لو كنت مستشار الله يوم الخلق لخلق عالماً ليس به نواقص كما نراها الآن. فغضبت الكنيسة عليه وأطلقوا الإشاعات عنه. وحدث أن الفونس اتهم زوجته بالعقر وأرسل إلى الدنمارك يطلب أميرة يتزوجها لتنجب له. وبينما كانت الأميرة في طريقها إليه حبلت زوجته. فأشاعت الكنيسة أنه ارتكب إثماً عظيماً لأنه لم ينتظر مشيئة الله في الإنجاب، وأن الله سوف يعاقبه علي ذلك في هذه الحياة. وفي ليلة من الليالي هطلت أمطار غزيرة معها برق ورعد شديدان، فما كان من الكنيسة إلا أن أشاعت أن البرق عذاب أرسله الله ليحرق قصر الفونس. بمثل هذه الخرافات حاربت الكنيسة كل من تجرأ وتحدث عن الدين أو عن الله.
ثم جاء الفلاسفة العظام وكان أولهم ديكارت (1596-1650) الذي كان خائفاً من الكنيسة في باديء الأمر فبدأ بالدفاع عن الله. وتدريجياً بدأ ديكارت بتجريد الله من بعض سلطانه، فقال بفصل الله عن الفلسفة (إن الله لا شأن له بالفلسفة إطلاقاً). ثم قال أن الكون لا نظام فيه، بل هو كون يعج بالفوضى ولا ينم عن مصمم ذكي. وأخيراً قال إن الله رحيم كريم ولكنا لا نحتاجه. وأكمل بمقولته المشهورة “أنا أفكر فإذاً أنا موجود”. وبهذه المقولة ارتقى بالعقل فوق تعاليم الكنيسة ومنحه حرية التفكير والنقد.
ثم جاء سبنوزا (1632-1677) وبدأ بنقد التعاليم اليهودية فطرده الحاخامات وصبوا على رأسه اللعنات ومنعوا العامة من الحديث معه أو حتى السلام عليه. وأخيراً تجرأ سبنوزا بعد أن زال عنه الخوف من رجال الدين فقال إن قوانين الطبيعة هي الله ولا إله غيرها. ثم جاء أليكساندر بوب (1688-1744) وحاول الدفاع عن الله وحاول صرف الفلاسفة عن الكلام عن الله، فقال إن الدراسات البشرية يجب أن تكون دراسة الإنسان. أي ما معناه: اتركوا الله في شأنه
ثم جاء جانجاك روسو (1712-1778) وحاول كذلك في البداية الدفاع عن الله وقال إن الشر من أنفسنا والخير من الله. ولكنه بالتدريج بدأ نقد الأديان وحتى نقد الله بطريقة غير مباشرة، وألف كتابه (اميل) Emile الذي اعتبرته الكنيسة هرطقة وتعدي على الإله، فأحرقوا كتابه وهموا بحرقه لولا أن أخبره أحد الأمراء ليهرب ليلاً من باريس، ففعل.
وبالتدريج زادت جرأة الفلاسفة في نقد الكنيسة والإله، فجاء إمانيويل كانط (1724-1804) الذي بدأ بالدفاع عن الله ثم حدث زلزال لشبونة في عام 1755 الذي دمر معظم المدينة وقتل الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ، وكان لهذا الزلزال أثرٌ عظيم في نفس كانط، فألف كتاب Critique of pure reason (تقييم الفكر النقي) الذي قال فيه إن التنوير هو خروج الإنسان من عبوديته التي فرضها على نفسه باعتماده على قوة خارجية. و حث على صرف النظر عن كل الطقوس الدينية من تعصب وسلطان الكنيسة والصلاة وكل الطقوس التي منعت الإنسان من الاعتماد على نفسه ودعته للاتكال على قوة خارجية. ثم هاجم الدين وقال إن الذي يقول إن الألم والمصائب اختبار من الله، يقدم عذراً لا برهان عليه، وتكذّبه تجاربنا الشخصية اليومية. ومن يعتمد على هذا القول يشتري العزاء بحقيقة الألم الواقع لدرجة أنه يفقد المواساة للمصابين.
ثم جاء هيجل (1770-1831) فزادت الجرأة معه وانتقد الله في البداية، ثم قال إن الله قد مات. وأخيراً جاء نيتشه (1844-1900) وأكد موت الله. فنرى هنا أن كل فيلسوف بنى على الذي سبقه وزادت جرأته على نقد الكنيسة وربها حتى قال آخرهم بموته. فالناقد العربي لا يتحتم عليه أن يبدأ من الصفر ويجامل رجال الدين في البدء خوفاً منهم، ثم يزيد نقده عنفاً.
ويمكن تلخيص حركة التنوير الأوربية في الآتي:
1-الفكر هو أسمى ملكات الإنسان
2-الفكر أو العقل هو ما يمكن الإنسان من التحرر من الاعتقاد البدائي المتعصب الذي يحبس الإنسان في إمعاء الجهل والتخلف
3-معرفة القوة الكامنة في العقل تمكن الإنسان ليس فقط من التفكير السليم، بل تعلمه السلوك القويم
4-عن طريق العلم وتقدمه يستطيع العقل أن يقود البشرية إلى حالةالإبداع الدنيوي
5-العقل يجعل كل الناس متساوين، وبالتالي يستحقون حرية متساوية ومعاملة واحدة تحت طائلة القانون
6-قبول أي معتقد يجب أن يتم عن طريق العقل وليس بسلطة الكنيسة ورجال الدين
هذا النقد المتدرج للدين، مع ملاحظة أن هؤلاء الفلاسفة جميعهم انتقدوا الكنيسة وممارساتها، ثم وجود الله، ولم يتطرق أحدهم إلى الأديان الأخرى، أدى في النهاية إلى سقوط عباءة الدين وارتقاء العقل حتى بين العامة. ولم يقل أحد من الفلاسفة أو العامة إن نقد هؤلاء الفلاسفة للدين أو لله، لم يكن نقداً علمياً وناتجاً عن أبحاث.
فهل يجب علينا إعادة اختراع العجلة، أم علينا أن نتعلم من نقد هؤلاء الفلاسفة التنوريين وبذا ننتقد الإسلام ورجاله وحتى إلهه دون أن ننتقد بالضرورة اليهودية والمسيحية؟ وهل يجب أن يكون نقدنا للإسلام نقداً علمياً حتى يرضى عنا الذين يقولون إن كتاباتنا لا تفيد ولا تستحق النشر وأنها تضر بالعلمانية لأنها تنفّر العامة منها، وهم يعلمون أن العامة أغلبهم لا يقرؤون، وإن قرأوا لا يستوعبون؟
أنا أعتقد أن نقد الإسلام وتعاليمه الفاشية مهمة يجب علينا الاطلاع بها في محاولة لتخليص شعوبنا من براثن الجهل وجشع تجار الدين ومن المهوسين الانتحاريين الذين يكرهون الحياة. وفي المقام الأول يجب علينا تحرير المرأة من تلك القيود التي أدمنت عليها وأصبحت جزءاً من شخصيتها التي تقودها لانتخاب جلاديها. ولا يهمني أن يعتبر البعض أن نقدي للإسلام ليس نقداً علمياً