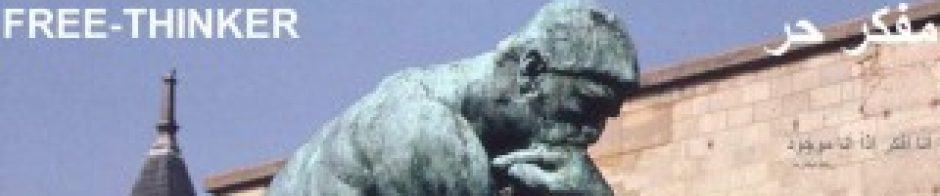حسن محمد الزين: السفير
قبل 4 اشهر من قيام الشاب محمد البوعزيزي بإحراق نفسه في 17/12/2010 متسبباً بالاحتجاجات التونسية التي اسقطت زين العابدين بن علي في 14/1/2011 أرسل الرئيس أوباما في 12/8/2010 إلى اعضاء مكتب الأمن القومي وقادة الوكالات الأمنية والأركان العسكرية مذكرة توجيهية غاية في الخطورة حملت عنوان «الإصلاح السياسي في الشرق الأوسط وشمال افريقيا».Political Reform in the Middle East and North Africa
وقد طلب أوبامـا إعـداد ما يلزم تحـضيراً لأن «المنـطقة دخلت مرحلة حساسة وحرجة» وأضاف «يجب علينا إعطاء دفعة قوية من الديموقراطية لضمان المصالح وتوفير الصدقية لسياسـاتنا على المدى البعيد»، مرجحاً «أن يختار القادة العرب القمع بدل الإصلاح عندما يواجهون أي معارضة داخلية، لكن موجة التغيير والتحول ستنتقل تدريجياً لتعم الشرق الأوسط».
وقد وثقت المذكرة بعنوان توجيه رئاسي
presidential Study Directive
واختصاراً
PSD11
وهو شكل دستوري تتبعه قرارات رئاسية تنفيذية تعرف رمزياً بـ
PDD
متسلسلة من (9ـ13) واللافت صدورها سنة 2011 مع إخفاء تفاصيلها خلافاً للعادة.
وبالتزامن معها، نشرت وثائق «ويكيليكس» في 5/12/2010 قبل الحراك التونسي بأسابيع وهي الفترة الكافية لانتشار مفعول العصف الإعلامي.
الغريب أن وثائق «ويكيليكس» الخاصة بفضائح النظام التونسي كانت من أوائل الوثائق المنشورة عربياً، ولم يلتفت إلى هذا الربط أغلبية المحللين العرب (عدا قلة من الكتاب، منهم الكاتب التونسي حسن مصدق).
وليس من قبيل الصدفة نشر الوثائق قبل أسابيع من الربيع العربي؟ ولهذا قال البروفسور جوزيف ناي أحد مستشاري أوباما للشؤون الدولية ان وثائق «ويكيليكس» «نموذج واقعي عن تأثير القوة الناعمة الأميركية في السياسية الدولية رغم أنها وثائق مسروقة» فهي لعبت دوراً محفزاً ومسرعاً ومكثفاً للحراك بمعزل عن خلفيات جوليان أسانج ومسرب الوثائق الجندي الأميركي برادلي مانينغ.
وبالعودة إلى المذكرة التي لا شك في سندها، فهي مدرجة على موقع منظمة العلماء الأميركيين
federation of American Scientis-FAS
المتخصص بأرشيف الوثائق الرئاسية منذ عهد ترومان (1944) لغاية أوباما (2008ـ2012).
وقد أثارت المذكرة رقم 11/
PSD11
جدلاً في الشهر الأول للثورات، وأشار إليها مدير
CIA
آنذاك ليون بانيتا (وزير الدفاع لاحقاً) اثناء استجوابه في جلسة استماع لجنة استخبارات الكونغرس، مستنداً إلى المذكرة لتأكيد
علم الإدارة الأميركية بصيرورة الأحداث العربية (مقالة للصحافي الأميركي مارك لاندر تحت عنوان «تقرير سري أصدره أوباما تنبأ بالاضطرابات العربية» نشر في النيويورك تايمز في 16 شباط 2011.
وللتوثيق، بحثنا في ارشيف الصحف الأميركية والغربية والروسية والعربية، فوجدنا لها أثراً في عدد من المقالات، خاصة صحيفة «الواشطن بوست» بمقالة الكاتب المرموق ديفيد اغناتيوس في 6 شباط 2011، و«النيويوركر» بمقالة الكاتب «رايان ليزا» بعنوان «الربيع العربي وتجديد سياسة أوباما الخارجية».
لكن المفاجأ أنها لم تنشر عربياً (ألمح إليها كتاب عرب ومواقع «انترنت» عربية) وربما نجد تفسيراً لذلك بأن العرب لم يحصلوا على الوثيقة، او كانوا تحت تأثير صدمة «الثورات العربية».
وقد وضع أوباما بموجب المذكرة الخطوط العريضة لـ«الربيع العربي» وهي عملية تتصل بخطة التوجه نحو آسيا والباسيفيك. وشكل بموجبها فريقاً استشارياً من مكتب الأمن القومي ضم سامنتا باور مساعدة الرئيس، ومديرة مكتب حقوق الإنسان، وغايل سميث مستشار أوباما لشؤون التنمية الدولية، ودينيس روس أشهر مبعوث أميركي سابق لعملية السلام ومستشار أوباما، وتوم دونيلون المستشار الرئاسي لشؤون الأمن القومي.
وشملت المذكرة طلب تقييم «منافع وأضرار تغيير الأنظمة العربية على المصالح الأميركية».
وجاء جواب اللجنة قاطعاً «ان تغيير الأنظمة العربية التي فقدت شرعيتها سيصب في خدمة المصالح الأميركية، لأنه سيقدم شركاء جدداً عبر شرعية ديموقراطية، ولهذا ينبغي دعم الحراك علناً».
ولم تأت هذه المذكرة من فراغ، حيث سبقتها معطيات رفعتها الوكالات الأمنية:
الوثيقة الأولى هي تقديرات مجلس المخابرات القومية الأميركية
NIC
للعام 2009 وتحدث عن «سيطرة الحركات الإسلامية ديموقراطياً على نظم شمال افريقيا والشرق الأوسط» وافترض التقدير 4 عمليات تحوّل في 4 دول عربية، وأشار بصورة لافتة إلى ان «نظام إيران المشاكس سيعمل على قطع الطريق أمام تحول نظام منشق إلى نظام حليف لأميركا» وكأن التقدير قصد «سوريا».
والوثيقة الثانية هي مشروع معهد السلام الأميركي تحت عنوان «دعم الأمن والديموقراطية في الشرق الأوسط الكبير» وقد بدا المشروع أعماله بعد استلام أوباما نهاية العام 2008 ونشرت وثائقه في 21/2/2010 وأوصى بـ«تقويض النظم العربية بعملية ذات شقين، التحرر السياسي الاستراتيجي، والتحول الديموقراطي التدريجي».
الغريب انه رغم مرور 3 سنوات على الوثيقة، لم يتعرف إليها أي محلل عربي (عدا كاتب أردني)؟
هذا الكلام قد يفاجئ البعض، لكن تجدر الإشارة ان اثبات وجود مخطط اميركي سابق على قيام «الحراك العربي العام 2011» لا يعني ان الشباب والناشطين والحركات الوطنية والإسلامية كانوا على علم بالمخطط، او انهم تحركوا بدوافع غير وطنية أو غير إسلامية، وبالتأكيد لم نقصد هذا المعنى، لأن حراكهم جاء بدون أدنى شك تلبية لمطالب وديناميات وصحوات عربية وإسلامية لها مصادرها ومنابعها المستقلة والذاتية.
وبالمقابل، فإن الاستراتيجيات الدولية لا تشتغل على النيات الحسنة والمطالب المشروعة، بل تعمل على رصد المشهد وتوجيه وتوظيف العناصر المتواجدة ضمن نطاق ساحة عملياتها لخدمة استراتيجياتها، تماماً كما ان ثبوت احتلال الاتحاد السوفياتي لافغانستان العام 1979 اكد حق الشعب الافغاني في مقاومة الغزو، ودفع آلاف المجاهدين العرب الذين جرى تسليحهم وتدريبهم على يد
CIA
وبالمقابل وظف الأميركي جهودهم لتدمير الاتحاد السوفياتي في إطار الحرب الباردة.
وبناء عليه، ينبغي الفصل بين إثبات شرعية حق او مطلب ما، وبين توظيفه ظرفياً وموضوعياً في إطار لعبة الشطرنج تمتلك أميركا كافة أدوات التحكم والسيطرة فيها، وعندها يتحول الطرف الأضعف إلى بيدق يحرك عن بعد، ما لم يُحسن التعامل مع اللعبة، وهذا يوجب على اللاعبين العرب اليقظة.
÷ مدخل إلى عملية «الربيع العربي»:
بدأ التخطيط لـ«الربيع العربي» بداية العام 2009 مع تولي أوباما الرئاسة، حسب وثيقة معهد السلام المنشورة في 21/1/2010 وقبل الثورات العربية بسنة وجاءت على شكل توصيات ودراسات حالة تحت عنوان:
«تعزيز ودعم الأمن والديموقراطية في الشرق الأوسط الكبير»:
In Pursuit Of Democracy and Security in the Great Middle East
وجاء في فذلكة الدراسة المترجمة للغة العربية والمنشورة على موقع
:/resourses/ in-pursuit- democracy-and-security-in-the-www.usip.org greaster-middle-east
«إن دعم الديموقراطية من قبل مسؤولينا الأعلى لن يدعم المصالح الأمنية الأميركية فقط، بل إنه سيرفع من شأن رؤية الرئيس أوباما بعلاقات جيدة بين الولايات المتحدة ودول الأغلبية المسلمة، الرؤية التي وضع معالمها بجرأة خلال خطابه في القاهرة في 4 حزيران 2009، من خلال تشجيع إدارة أوباما على صياغة استراتيجية تربط بين الأمن والتغيير الديموقراطي، فإننا نقدم ما نعتقد بأنه سيكون استراتيجية مجدية سياسياً وطويلة الأمد، وهي الاستراتيجية المفضلة سواء في الاعتماد على الوضع الراهن، او محاولة تقويضه بسرعة عن طريق تشجيع تغيير النظام».
والجملة الأخيرة هي الأخطر في الـ70 الدراسة، فهي تتحدث رسمياً عن تشجيع تغيير النظم العربية قبل سنة من الربيع العربي.
وللعلم فإن معهد السلام هو المعهد البحثي الخاص بالكونغرس والبيت الأبيض، وهو يضم خبراء من الحزبين الجمهوري والديموقراطي، من بينهم المفكر فرانسيس فوكوياما، ويعين رئيس المعهد أوباما (يرأسه حالياً البروفيسور دانييال برومبيرغ، وهو مدير مبادرة أميركا والعالم الإسلامي ومقرها قطر).
وتجدر الاشارة إلى أن معهد السلام
USIP
كلف بعد اندلاع الثورات بإدارة ملف سُمّي رسمياً «مكتب الربيع العربي».
ولهذا عين السفير «فريدريك هوف» عضو معهد السلام مديراً للملف «الانتقالي السوري» وعين الدكتور رضوان زيادة الخبير لدى المعهد ممثلاً للمعارضة السورية في واشنطن.
كما تولى المعهد تدريب آلاف الناشطين العرب على «استراتيجيات الكفاح غير المسلح وتكتيكات اللاعنف» وذلك في معاهد متخصصة في صربيا وبريطانيا والنمسا وقطر، ويمكن قراءة اسم معهد السلام على الكتاب الذي وزع على الناشطين بعنوان «الكفاح السلمي ـ 50 نقطة حاسمة» وهو يستلهم أفكار المفكر الأميركي جين شارب، وتجربة قائد منظمة «أوتبور» الصربية سرجيو بوبوفيتش الذي قاد عملية إسقاط نظام ميلوزيفيتش، كما يمكن ملاحظة الاقتباس الحرفي للتكتيكات في تدريبات «اكاديمية التغيير» التي يديرها الدكتور هشام مرسي صهر الشيخ يوسف القرضاوي.
هذه التدريبات تمت قبل «الربيع العربي» واعترف بها الناشطون في مقابلات تلفزيونية، وعلى رأسهم هشام مرسي مدير «اكاديمية التغيير» متحدثاً عن تدريب 1000 ناشط من مختلف المحافظات المصرية قبل الثورة، كذلك أقر بها الناشط احمد ماهر قائد 6 ابريل في مقابلة مع جريدة الشرق الأوسط بوجود «غرفة عمليات» نسقت أنشطة الثوار في ميدان التحرير، وسار على منوالهم الناشط سليم عمامو الناشط في «أنونيموس» التونسية، والناشطة اليمنية توكل كرمان، وأثبت هذه الحقائق عشرات الباحثين، على رأسهم الناشط المصري سعد الدين ابراهيم مدير مركز ابن خلدون في مقابلة مع صحيفة «الوطن» المصرية، متحدثاً عن مليار ونصف المليار دولار أنفقتها الإدارة الأميركية على تدريب الناشطين.
هذه التدريبات استند إليها المفكر الإسلامي المصري طارق رمضان حفيد الإمام حسن البنا زعيم «الإخوان المسلمين» في كتابه الصادر تحت عنوان «الإسلام والصحوة العربية» وفي محاضراته المنشورة على
youtube
التي أثارت ضجة، كاشفاً عن تلقي الناشطين العرب برقية خلال مؤتمر عقد في شهر أيلول من العام 2010 في احدى دول اوروبا الشرقية تؤكد فيها الخارجية الأميركية بدء موجة التحولات العربية (قبل الثورات بثلاثة أشهر…!).
وقد وضع المعهد برامجه حسب كل دولة وفق دراسات الحالة
«Case Study»
وقسمت إلى نوعين:
1ـ دول نصف ديكتاتورية
Semi Autocracy
يمكن إصلاحها عبر عقد صفقات بين الأنظمة والمعارضات، (مصر والأردن والمغرب ولبنان واليمن) وكلمة صفقة وردت حرفياً
«Past making».
2ـ دول ديكتاتورية بالكامل يستحيل إصلاحها، (تونس/ ليبيا/ وسوريا/ إيران) وإدراج إيران لأن الخطة تشمل الشرق الأوسط الكبير.
واعتبرت الخطة أن هناك «قدراً من عدم اليقين السياسي على الادارة الأميركية تحمله للخروج من المأزق». وكشفت الوثيقة عن عملية ذات شقين:
1ـ التحرر السياسي الاستراتيجي.
2ـ التحول الديموقراطي التدريجي.
وأضافت «وكلتا القوتين المحركتين ـ التحرر والتحول ـ تتطلبان تجاوز الولايات المتحدة لنظام التنمية الديموقراطية الذي يعتمد إلى حد كبير على قدرة جماعات المجتمع المدني على المطالبة بالإصلاحات إلى إعطاء الدول وكوادرها الحاكمة دوراً رئيسياً بإمداد التغييرات».
ولم تكن الإدارة الأميركية بصدد الغدر بحلفائها، وهذا ما أكدته هيلاري كلينتون في تصريح نقلته وكالات الأنباء إثر مقتل السفير الأميركي في بنغازي قائلة «ان هذا الحادث لن يغيّر دعم الادارة الأميركية للربيع العربي رغم العقبات»، وأضافت «لقد انذرنا الحكومات العربية قبل اسبوعين من الربيع العربي في لقاء تم في الدوحة، وقلنا لهم إن أسس المنطقة تغرق في الرمال، وان المنطقة ذاهبة نحو السقوط ما لم تحدث إصلاحات جذرية، واليوم أكرر القول بأننا لن نعود إلى الوراء، ولن نعود إلى ما قبل العام 2011، فهذا أصبح أمراً مستحيلاً، بل أصبح يهدد مستقبلنا وأمننا».
ولم يكن مقرراً انهيار النظام المصري تحت الضغط، لان العملية تتضمن الضغط من الاسفل (منظمات المجتمع المدني) والضغط من أعلى (الجيش)، ولكن يبدو ان النظام سقط بسبب هشاشته الذاتية، ولأخطاء قيادية
Management
ارتكبها الفريق الأميركي، وبعض أركان النظام المصري، وهذا ما سبّب الفوضى.
ويعود الخلل في القراءة الأميركية للحالة المصرية إلى قوة التنظيمات الإسلامية (الإخوان) والبروز المفاجئ للتيار السلفي، مقابل التعويل على القوى الليبرالية الهشة التي تحتشد الآن تحت اسم «جبهة الإنقاذ الوطنية» وتعمل الإدارة الأميركية وحلفائها العرب على تنشيطها لدمجها في النظام المصري الجديد.
وقد وضعت الوثيقة احتمالاً لحدوث صدامات وفوضى بين الإسلاميين وبقايا الأنظمة الحاكمة اثناء عمليات التحول الديموقراطي (ص 10) وهو ما يحصل الآن.
المفاجئ في الوثيقة كان إدراج «تونس» ضمن الدول الديكتاتورية..؟
وذكرت الوثيقة ليبيا، ولم تحدد تفاصيل التحولات فيها، لكن وثائقي بثه التلفزيون الفرنسي الشهير يغني عن البحث، فقد أكد تدبير فرنسا وقطر مخططاً للإطاحة بالقذافي منذ سنة 2009 بموافقة أميركية أطلسية، أي قبل الربيع العربي بسنتين لأجل الاستيلاء على حقل غاز مكتشف في الصحراء الليبية، يكفي أوروبا لـ30 يوماً. وقد استند الوثائقي إلى شهادات ضباط مخابرات فرنسيين أكدوا مشاركتهم في نقل أسلحة لثوار بنغازي لتزخيم «الثورة».
أما سوريا، فلم يفصل تحولها الديموقراطي، لكن وردت اشارة إلى نظام يضم اثنيات مذهبية، قد يؤدي التحول فيه إلى «عنف همجي».
لكن وثائق اخرى، تشير إلى انه منذ 2009 اعد مركز دراسات مقره لندن يسمى «المركز الدولي للدراسات السورية» دراسة مفصلة عن 220 صفحة تحت عنوان «البعث الشيعي» ويتلقى دعمه من المعارض السوري «أنس العبدة» بتمويل من وزارة الخارجية الأميركية حسب ويكيليكس، ويفهم من الدراسة (ص 177) وجود خطة لإسقاط سوريا من خارطة «الهلال الشيعي» وفق سيناريو يبدأ بتنظيم احتجاجات في محافظات سورية من لون طائفي. وما يؤكد خطورة الدراسة، تطابقها لاحقاً مع تصريح لمراقب الإخوان المسلمين رياض الشقفة لصحيفة تركية بعد سنتين من الربيع العربي عن سعي حركته لقصم ظهر «الهلال الشيعي».