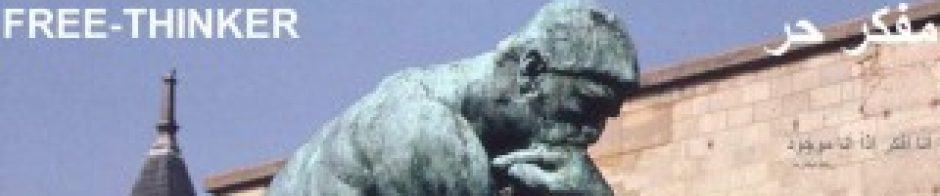أجمل وأحلى المفردات ومعانيها في تاريخ العراق
سرسبيندار السندي: “لتعميم الفائدة إرتأيت نشره في موقع ( مفكر حر ) وشكرا لمن أعده حيث لم يذكر إسمه “؟
القبانجي : الشخص الذي يوزن البضاعة، ومتأتية من ألقبان أو الميزان.ه
الاطرقجي : بائع السجاد والبساط.ه
مغازجي : بائع الكراسي والمناضد المرايا واللوازم المنزلية.ه
العبايجي : بائع العبي وناسجها، والعباية تسمى أحيانا (بشت) وتعني بالفارسية والكردية الظهر، ومنه ورد أسم (بشت كو) طرف العراق الشرقي التي يقطنه العراقيون الفيلية، و الذي يعني ظهر الجبل.ه
علوجي : يبيع الحبوب والطحين. والعلوة هي السوق أو سوق الجملة، وتعني باللغة الكثبان أو مرتفع الأرض، وشرح عنها وقال الكثير المرحوم مصطفى جواد، وكانت ساحة الشهداء بالأساس علوة، وأشهر العلاوي الباقية (مستلهمة أسمها من الحلة) والواقعة على أطراف الكرخ، وكانت تباع فيها السلعة الآتية من جهات الحلة والفرات.ويتذكر جلنا أنها كانت شحيحة البنيان حتى بعد أن أنشاء المحطة العالمية لسكة القطار ثم المطار المدني (المثنى).ه
العربنجي : صاحب العربة.ه
قلمجي : تاجر التبغ. وكان لا يطلق على تاجر التبغ (تاجر) بل قلنش.ه
الفروجي : خياط العبي (الفرو).ه
القندرجي : الشخص الذي يصنع الأحذية، و (قندره) كلمة تركية.ه
جرخجي : حارس ليلي، وجرخ يعني دائر أو دورة، والاسم متأتي من دورانه في الأزقة، ويسمى أحيانا النوبجي، ويعني الذي يأتي بالنوبة، أي بوقت معين أو فترة عمل محددة
الحمامجي : صاحب الحمام، والحمام كلمة عربية.ه
الفيترجي : وهو مصلح السيارات، والكلمة وارده من (فيتر
Fitter)
الإنكليزية، وتعني صاحب المقاييس أو آخذ القياس بـ (ألفيته)، وليس مصلح شيء ما.ه
بنجرجي : وهو مصلح إطارات السيارات المطاطية، والكلمة واردة من الإنكليزية (بوينجر
Puncture )
والكلمة تعني صاحب (النقطة) أو محددها وتعني مجازا مكان التنفيس، ولا علاقة لها بإطارات السيارات.ه
شاهبندر : (شاه بندر) رئيس التجار وهي من الفارسية مركبة من (شاه) ويعني رئيس أو ملك كما هو متداول، وبندر يعني الميناء وجعلت لدى المصريين المدينة للتمييز عن القرية (الكفر)، وبذلك فالمركب يعني كبير رئيس الميناء.ه
جلبي : وتعني مثل شاهبندر لكن من اللغة التركية، وتداولها العراقيون للدلالة على ملاك الأراضي، كما عبد الهادي بن عبد الحسين الجلبي والد السياسي أحمد الجلبي المتوفى 1988ه
دامرجي: وتعني حداد، والكلمة واردة من التركية حيث (دامر) يعني حديد، وثمة عائلة غنية في بغداد تحمل هذا الاسم.ه
دايه: بمعنى مربية، أو سيده، والكلمة من أصل فارسي بمعنى الرب أو الرئيس، وقد كان الأعراب في العراق القادمين من الجزيرة العربية يروجون (العراق دايه ونجد أمايه) ، أي أن أصلهم من نجد وتربيتهم في العراق، وهذا ما ذكره علي الوردي في لمحاته الاجتماعية. وداي أو دائي، ربما لها صلة مع اصطلاح (يدعي) و (مدعي بها) أي (شقي) (اباضاي عند الشاميين) ومتقوي بين القوم بجسارته وشكيمته، فهو مثل السيد. والداعي: أي الشخص المتكلم أي الداعي لكم بالدعوات الصالحة كما يفسرها البعض.وداي تداولها الولاة الأتراك في الجزائر وتونس، كلقب لهم وأشهرهم حسين داي. وترادف كذلك تداول لقب (بآي) كما أحمد بآي والي قسنطينة الذي طرده الفرنسيون 1832م، وبآي، تعني درجة رفيعة أو ذو المراتب، وهي من الفارسية كما (بآية) درجة السلم عند العراقيين.ه
كولجي : حارس المرمى، وكول كما هو معروف كلمة إنكليزية، مثلما كل مصطلحات اللعبة. والسبب لأن البريطانيين هم من أتى بهذه اللعبة بعد احتلالهم العراق.ه
كلاوجي أو كلاوات : يعني يضحك على ذقن الناس ويخدعهم.ه
لوتي: تأتي بمعنى محتال، وهي تذكر بطبقة الشطار والعيارين في التراث العراقي أو الحرافيش في التراث المصري. وبعضهم يرجعها للمفردة الإنكليزية
Looting
وربما الأمر أبعد من ذلك، وينسبها البعض إلى قوم يسكنون سلطة عمان اليوم، و يدعون (اللواتي أو اللوتي)، وكانوا يؤمون البصرة ويكثرون فيها، ويتعاملون بالتجارة، ومن هناك انطلقت الكلمة كون بعضهم كان يحاول الاحتيال. واللواته العمانيين شيعة، ويتكلمون العربية مع لغة سنسكريتية خاصة، لكنهم أكثر الناس تعريبا وصيانة للعربية في السلطنة. والغريب في الأمر أن أسمهم يرتبط بقبيلة (لواته) البربرية في المغرب الإسلامي، وهي حمولة من قبائل صنهاجة البربرية، التي كني بها أبن بطوطة (اللواتي) الطنجي. وقد رحلتْ مع الفاطميين إلى مصر ثم كتب لها أن تستقر في اليمن، التي تبعت للفاطميين بالإضافة للحجاز والشام. ولكن أخبروهم بأن صلاح الدين الأيوبي سوف يتعقبهم ويفنيهم، فهربوا إلى الهند بعد سقوط الدولة الفاطمية، ثم عادوا بعد أجيال إلى عمان، وهم اليوم يشكلون أحدى فسيفسائها الجميل.ه
خشب جاوى : جاوى اسم البهارات التي كانت تأتي من مدينة جاوه في اندونيسيا وآخذت التسمية على الخشب القوي الممتاز.ه
لولة أو نبوبة : خشبة صغيرة كان يلف عليها خيوط الحرير، وفي بعض مناطق العراق يطلق على الحنفية (لولة)، وتسمى (جشمه) لدى البعض وهي من التركية. ونبوبه وأنبوب العربية كلها من مصدر (نبار) السومرية ويعني القصب، ومنها جاءت كلمة أنبار، ربما بسبب وجود القصب على ضفاف الفرات فيها، أو ربما من (نبر) السامية التي ترمز لارتفاع أرضها، بما يرد مثلا في (نبرة الصوت) .ه
النونة : دائرة صغيرة سوداء التي ترسم بين الحاجبين.ه
نمنم : وهو الخرز الصغير الذي يستعمل في توشيح الأنسجة النسائية، وفي كساء بعض المقتنيات الجميلة. وربما الكلمة واردة من (نمنم) ومنها (منمنمة) وهي الرسوم الدقيقة التي كانت تزوق بها الكتب، ولاسيما في الحقبة العباسية، ولاسيما القصص والمقامات ومنها مقامات الحريري التي رسمها الواسطي عام 1237م. ونرجح هنا أن هذا العرف قد ورد من كتب ماني البابلي، الداعية العراقي (213-277م) ، حيث كان رساما، وكان يضفي على كتبه الدينية وتعاليمه المكتوبة مسحات فنية من خلال الرسم عليها، ودعي كتابه حينئذ، قبل أن يمنع (ماني نامه) أي سجل أو كتاب ماني، ومنها حرفت لتصبح مع التقادم (منمنمة) التي احتفظت بفعل الرسم على الكتب، وقد ترجمها الأوربيون
(Miniature
وترجمها البعض منهم (مصغرات) بما بدا لهم أنها تعني نمنم أي الصغير كما مفهوم النمنم لدينا.ه
الكليدار : رئيس سدنة الروضة المقدسة كمرقد الروضة الحيدرية والروضة الحسينية والعباسية.ه ه
الكيم : (القيم) رئيس سدنة في المراقد المقدسة مشتقه من مقام، ويعني الضريح
الأسطة : كلمة تحوير لكلمة أستاذ، ويعني معلم الحرفة أو حرّيف، وكان تطلق على المهندس والمعمار.ه
شقندحي : الشخص الفكه المحب للنكتة.ه
سيبندي : أي أبو الثلاث ورقات، من مركب (سي- بند) من الفارسية، وتستعمل كلمة (دربدو) محاكية لها في الكردي والفارسي والتركي، ونقلها الأتراك للبلقانيين، ومعناها طارق الأبواب أو المتسول.وكنت أسمع والدي يقول عن الشخص الضائع (در بدر) أو (هدر بدر) ومعناها من باب إلى باب.ه
بلتيقة (برتيقة): ومعناها حيلة، واردة من اللغات الغربية التي تعني سياسة
(Political)
، لما فيها من حيل.ه
بلشتي : ومعناها صاحب الحيلة، وقد اشتقت من بلشفي، وترتبط بحادث تسلق البلاشفة إلى السلطة في روسيا، بعدما كان المناشفة أعدائهم وأصحاب الثورة أكثر منهم، لكن حيلتهم أوصلتهم للسلطة.ه
مسقوفي : ومعناه الشخص الذي لا دين له (دين سز) ولا يحرم أمر، وانطلقت منذ هجوم الروس على العراق بعد عام 1914، من ضمن أحداث الحرب العالمية الأولى، وعاثوا في قرى ومدن شمال وشرق العراق ظلما واغتصاب وسرقه.ه
حبنتري : وهي متعددة المعاني وأهمها المعتد بنفسه، والمنتفخ اختيالا، وذهب الدكتور علي الشوك، بأنها واردة من مغامر (
أوفنتور) في اللغات الغربية
(Adventure)
.ه
القمري : الآنة الهندية وهي تساوي 4 فلوس، والظاهر أن كان بها شعار القمر في سكتها، وما زال الناس يستخدمون (ما يساوي ولا قمري) يعني لا يساوي شيء. وقد سمعنا مثلا كلمه (طره وكتبه) وهي تعني وجهي العملة التركية، فطره تعني رسم الطغرائي المميز للعثمانيين، والكتبة هي الكتابة على الوجه الآخر.ه
البابوج، الكلاش : نعال جلد أو المداس، ويسمى أحيانا الصندل.ه
قصر : هو البيت الكبير ذو الواجهة الفخمة والذي يطل على النهر مباشرة، وبلاط كلمة قديمة يذكر البعض أنها محرفة من مصدر روماني.ه
سكاير المزبن : سميت لوجود الزبانة في قاعدة السكارة.ه
كرنتينه: ومعناها نظام الحجز الصحي لمن يحمل مرضا معديا. والكلمة أصلها إيطالي، وعممها الأتراك.ه
كنتور: هو دولاب الملابس، والكلمة من أصل إيطالي ويعني المحتوي
Counter) )
مزين : حلاق، وإن أول من ادخل كلمة حلاق على محل عمله هو الحلاق مكي الأشتري (في بغداد العشرينات)- عباس بغدادي.ه
صوج : كلمة تركية معناها الذنب أو الجناية.ه
يمعود، معود : أي طويل العمر الذي تعود عليه السنون تلو السنون وهو في أحسن حال، أو يذهب البعض على تعوده على الكرم والعطاء. وفي السياق نشير إلى أن اسم (مناتي) العراقي الذي لم يعد يطلق على المواليد منذ نصف قرن معناه المعطي أو الكريم من المصدر الآرامي، وهي نفسها كلمة (متي
Matti)
ومعناها (معطي) المقترنة باسم احد حواريين السيد المسيح (ع) .ه
عالكيف : حسب المرام، وترد بكيفك أي كما تبتغي. وكيفجي، يعني كثير الأفراح، والراغب بالحفلات، وهي واردة من كيف أي فرح التي تعني المخدر (الحشيش) لدى المصريين والمغاربة.ه
الطوبجي : جندي المدفعية.طوب معناها مدفع (كلمة تركية) جي ضمير يدل على النسب لشيء مثل (عربان جي) أي صاحب العربة.ه
التوثية : عصا غليظة تتخذ من شجرة التوت، وجذع هذا الشجر ضخم حتى ورد في الأمثال البغدادية (فحل التوت بالبستان هيبة)، بما يعني شخص ضخم، ومهيوب، لكنه ليس ذي فائدة كثيرا.ه
جام : كلمة مخففة من كلمة الزجاج، وتستعمل بالتركية وفي لغات البلقان.
محروك الصفحة: هي شتيمة يطلقها الشامت على الميت، وتعني أن الميت قد أدخل جهنم لسوء عمله، وأن جانبا منه قد أحترق فيها.ه
فد : فرد واحد.ه
جفيان : كلمة مشتقة من كفى . كأن يقال مثلا، كفى الله شر فلان.ه
ملا : كلمة تستعمل لدى الشعوب الأعجمية محرفة من (مولى) أي سيد، و تعني في الدارجة الشيخ أو الأستاذ، ويتداولها المغاربة باسم الشيخ أو الفقيه.ه
جلت: كلت من كل أي اكتفى ومل.ه
الكاع : القاع الأرض، وتعني عند بعض المغاربة (الكل) .ه
جيب: أصل الكلمة فعل أمر من جاء يجئ. فيقال هات الشيء، أو جئ به. ثم حرفت.ه
الآنة : (العانة) عملة هندية تسير على نظام الأربعة، فهي أربع بيزات، والقران أربع آنات، والربية أربع قرانات. ونعتقد هنا أن بيزه قد حرفت من كلمه (بيسه) البرتغالية وتعني قطعة من اللاتينية.. وتداوها الأسبان تصغيرا (بيسيتا)، وقران هي محرفة لكلمة (كورون) وهي عملة الكثير من الأوربيين ومنها النمسا في القرن التاسع عشر التي كانت تعتبر عملة قوية. والكلمة محرفة من (قرن) السومرية المصدر، التي استعملت في (هورن) المنبه أو البوق، و(كورن- كورنر) أي زاوية..الخ.ه
السيان : طين أسود كريه الرائحة لوجود غاز الكبريت فيه، تخلفه مياه المجاري، والمياه الآسنة.ه
البزاز : بائع القماش. البز (الثياب) مهنة البزاز، البزازة (عربية (.ه
عزه العزاك : أي أصابك من الحزن والنكبات ما يستحق التعزية وتطيب الخاطر عليه.ه
عمامة آخوندية : هي عمامة كبيرة الجليلة القدر التي يلبسها كبار العلماء والفقهاء، و(آخون) كلمة فارسية بمعنى القارئ، ومنها جاءت (روزه خون) أو قارئ الروضة كون بعض الواعظين والقراء كانوا يحفظون كتاب (روضة الصالحين) عن ظهر قلب ويقرءوه على الناس. ومنها جاءت (قصه خون) أي قارئ القصة، وهو ما يقابل الحكواتي في الشام والكوال في المغرب العربي.ه
الوادم : الأوادم بلهجة أهل الريف في العراق جمع آدمي.ه
الطلي : هو الخروف الفتي، وهو أكبر من الحمل وأصغر من الكبش.ه
خلي : فصيحة، بمعنى، دع أو أترك.ه
السردار : السر، كلمة أعجمية، معناها رأس. دار، معناها القوم، رئيس القوم، ويذهب البعض أنها عربية وتعني دار السر، وكانت تطلق في السودان على القائد العام للجيش.ه
درد : كلمة فارسية تعني الألم والوجع (الشبعان ما يدري بدرد الجوعان).ه
دا : وتستخدم من قبل ساكني بغداد الحبيبة في الغالب وتعني الاستمرارية مقل دا خابر أو دا أدور دا يدك…. الخ
جا : وهي أداة استفهام وتستعمل عند أهل الجنوب والوسط مثل جا شسوي؟ جا شلون؟ جا ليش؟….الخ
شبيك : أداة استفهام ويستعملها جميع العراقيين وتعني ماذا بك؟
خو ماكو شي : أيضا أداة استفهام ويستعملها جميع العراقيين وتعني ارجوا أن لم يحصل لك شي؟
شعواط : ويستعملها جميع العراقيين وبالذات عندما يشموا راحة بلاستك محروق.ه
شيل : وتعني ارفع.ه
اثول : وهو نعت يطلع على الشخص الأبله.ه
هيج : وتعني هكذا.ه
بكيفي : وتعني على مزاجي.ه
دفره : وتعني ركله بالقدم.ه
راشدي : وتعني ضربة بالكف.ه
ملتح : وتطلق على الشخص الالعوبان.ه
مفتح بالبن : وتطلق على الشخص الذكي والذي لا تفوته فائتة.ه
حباب : وتطلق على الشخص الرزن والذي يحترم نفسه وذو أخلاق عاليه مع كافة الناس.ه
تمًن : وتعني الرز.ه
خاشوكه : وتعني ملعقة.ه
اتزقنب : وتعني تفضل بالأكل، ولكن تطلق في حالة العصبية للشخص المقابل.ه
ولًي : وتعني اذهب ولكن في حالة العصبية، وهي مأخوذة من الفصحى ولًى.ه
قنقينه : وتطلق على الشخص الذي يبقى يلح ويدقق في الموضوع ويلح بالأسئلة ويتردد وهي مأخوذة من نبتة القنقينة المتسلقة.ه
لوكي : وتطلق على الشخص الذي يتملق للمقابل في سبيل الحصول على مبتغاه.ه