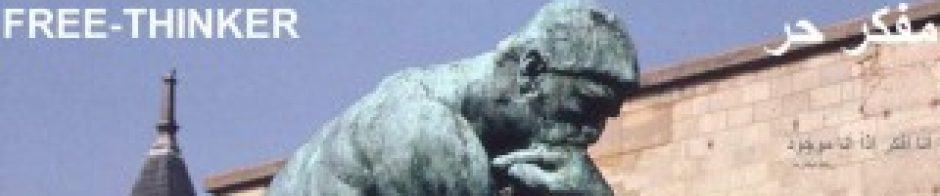الموارنة والصراع السياسي التأريخي في لبنان1
الموارنة والصراع السياسي التأريخي في لبنان1
بقلم:عضيد جواد الخميسي
بداية الانتداب عام 1920 ، نشأ صراع بين البطاركة الموارنة والمفوضين الساميين الفرنسيين حول حكم لبنان. ويكشف مثل هذا الصراع تـنامي السلطة الزمنية للبطريرك التي اكتبسها أيام المتصرفية. إلا أن البطريرك بدأ ، في عهد الانتداب بفقدان سلطته بينما اكتسب رئيس البلاد المزيد من السلطة. وعندما نشر دستور دولة لبنان الكبير رسمياً عام 1926 ، كان رئيس البلاد هو المنفرد بالسلطة لا البطريرك .
من الواضح أن الموارنة تمتعوا في عهد الانتداب بمركز أفضل من مركز الشيعة والسنة والدروز وأفضل حتى من الطوائف المسيحية غير الكاثوليكية. فقد كان لبنان بشكل أساسي بلداً مكوناً من طوائف شغل الموارنة من بينها جميعاً أغلب المراكز البارزة في الدولة. إلا أن الطائفية التي عمل الفرنسيون على تشجيعها لم تكن مقبولة لدى الجماعات الأخرى ، وخاصة المسلمين. وبعد إعلان استقلال لبنان كانت معظم المبادئ الطائفية في دولة لبنان الكبير بحاجة إلى تعريف واسع النطاق لكي تكون مقبولة لدى المجموعات الدينية المختلفة .
كانت هناك حاجة الى تغيير جذري في الدولة ، بحيث يخلق توازناً طائفياً تقبله كافة الطوائف في لبنان. كانت النتيجة الإعلان الرسمي للميثاق الوطني عام 1943 الذي قام باعداده رئيس جمهورية لبنان المنتخب حديثاً بشارة الخوري بالمشاركة مع رئيس الوزراء السني رياض الصلح .
ومن جملة ما نصّ عليه الميثاق هو ان يتخلى مسيحيو لبنان عن فكرة لبنان منعزل عن محيطه العربي ويقبلون لبنان كدولةً مستقلة ضمن الحظيرة العربية. كما نصّ ايضاً ان يتخلى المسلمون بدورهم عن فكرة إعادة تلك الأراضي التي الحقت بلبنان في عام 1920 إلى سورية. وأخيراً نصّ الميثاق على ان يرفض العرب الحماية الأجنبية ويتوقفون عن نشاطهم في إخضاع لبنان لسورية أو للعالم العربي. بعبارة أخرى ، وفقاً لهذا الميثاق يكون لبنان بلداً مستقلاً لكافة الشعب العربي الذي يقطنه بغض النظر عن دينهم ويكون احد الدول في مجموعة الدول العربية .
كان الميثاق ، بشكل اساسي ، حلاً وسطاً لا تغييراً راديكالياً لهيكلية لبنان الطائفية. بل ظل النظام البرلماني للبنان قائماً على تمثيل طائفي ، كما كان في زمن الانتداب. وكان على المراكز الثلاثة الرئيسية ضمن الحكومة أن توزع على النحو التالي : يكون رئيس الجمهورية مارونياً ، ورئيس البرلمان شيعياً ورئيس الوزارة سنياً. فليس من الغرابة اذن أن كان العديد من الكتّاب الموارنة أو خلافهم قد نظروا إلى الميثاق الوطني على أنه ترسيخ للطائفية التي أوجدها العثمانيون ، وأعادت السـلطات الفرنسية تثبيتها ، لكن البطريرك الماروني رحب بالميثاق ودعمه .
كان الميثاق الوطني وفقاً لميخائيل غريِّب الماروني ، جائراً ومعيباً. كما كان ترسيخه للطائفية سبباً في احتراق لبنان اليوم وانهيار دعائمه على شعبه. ويرثي غريِّب الحقيقة وهي ان الميثاق خلق فراغاً سياسياً هائلاً في لبنان حرض الفلسطينيين ومن ثم السوريين وأخيراً كل العرب على محاولة ملء هذا الفراغ . وهذا السيناريو نفسه اعيد تطبيقه في العراق بعد 2003 مما اعطى نفس النتائج لما حصل في لبنان .
كان الميثاق في الحقيقة تسوية بين فردين لا طائفتين مختلفتين في لبنان. كان علاجاً مؤقتاً لا شفاءً تاماً من مرض الطائفية التي هي مصدر الأزمة اللبنانية حالياً. هذا ما شجع القادة الدروز والشيعة بعدئذ على الجدل بأن الميثاق الوطني لعام 1943 لم يعد مجدياً .
لقد تغيرت الأمور ، وتكاثرت الطائفتين الدرزية والشيعية عدداً ومكانةً بالقدر الذي يكفي ليجعلهما تطالبان بإعادة نظرة جذرية حول مضمون الميثاق الوطني ، لا على أساس طائفي بل على أساس حكم الأغلبية. كان الميثاق الوطني ، من وجهة نظر الرابطة المارونية دلالة على الإيمان الواقعي والعملي لتاريخ الموارنة وتطلعاتهم. كان ، قبل كل شيء ، تعبيراً عن أقصى رغبة لهم في التعايش مع الطوائف غير المارونية. ويجادل بعض الموارنة بأن الميثاق قد خصّ رئاسة الجمهورية بالموارنة لأكثر الأسباب جوهرية ـ وهو أن منصب الرئاسة المرموق يشكل رمزاً للأقليات المسيحية في العالم العربي الإسلامي . ولكن قادة الموارنة الشباب كانت لديهم على الاخص ، بعد الحرب الأهلية التي اندلعت عام 1975 ووفاة الرئيس الراحل بشير الجميل ، نظرة مختلفة بخصوص الميثاق الوطني لعام 1943. ففي آذار من عام 1977 اجتمعت مجموعة من الشخصيات اللبنانية البارزة من كل الأديان والصبغات الدينية في الكسليك لمناقشة إيجاد نظام سياسي جديد للبنان يحل محل الميثاق الوطني. وفي هذا الاجتماع أعلن بشير الجميل صراحة بأن الميثاق الوطني بدأ منذ عام 1958 بالانهيار أمام أعين اللبنانيين والعرب والعالم أجمع. وأضاف قائلاً ” إذا كان عام 1958 هو بداية إصابة صيغة الميثاق الوطني بالسرطان ، فلا بد من اعتبار عام 1975 تاريخ اعتلاله الحقيقي”. ويختتم الجميل بأنه يـرفض صيغة الميثاق قائلاً: ” لقد اشتركت شخصياً في طعنه بمديه وفي دفنه ووضع حراس على قبره بحيث لا يبعث مرة أخرى ” ….
اما البطريرك عريضة فقد سُرَّ بالميثاق الوطني لأنه أبقى الرئاسة ، وهي أعلى منصب في الحكومة ، بأيدي الموارنة. كان اهتمام البطريرك الرئيسي هو لبنان مستقل لأنه البلد الوحيد في العالم العربي الذي استطاع فيه المسيحيون وخاصة الموارنة التمتع ببعض السلطة الحكومية. وعندما التقى ممثلوا الدول العربية في الاسكندرية ووقعوا بروتوكول الاسكندرية في 7 تشرين الأول 1944 لإنشاء جامعة الدول العربية اعترض البطريرك الماروني على بعض الصياغة الواردة في البروتوكول. فقد فهم البطريرك ومستـشاروه ان دعوة البروتوكول لقيام منظمة من الدول العربية ، تعني اتحاداً كونفدرالياً يُختزل فيه لبنان ليكون أقلية لا أهمية لها وسط أغلبية عربية مسلمة بشكل ساحق. كما اعترض البطريرك ايضاً بأن صيغة بروتوكول جامعة الدول العربية ليست صيغة اتحاد كونفدرالي بل اتحاد دول عربية مستقلة .
ان اهتمام البطريرك باستقلال لبنان ككيان مسيحي كان من الشدة بحيث انه راجع بشـأنه مناشدة الأمم المتحدة التي تمَّ تأسيسها عام 1945. ويصرح الكاتب اللبناني أنيس صايغ ، في كتابه لبنان الطائفي تصريحاً يدعو الى العجب حول تصرف البطريرك عريضة. يقول أنيس صايغ أن البطريرك عريضة بمراجعته الأمم المتحدة طلب تأسيس دولة اسرائيلية في فلسطين ودولة مسيحية في لبنان. لا بل أرسل مطرانه مبارك إلى فرنسا لترويج هذا الطلب. وعندما قدمت لجنة الأمم المتحدة إلى لبنان للاستفتاء بشأن القضية الفلسطينية ، طلب المطران مبارك من اللجنة العمل على تحقيق قيام دولة اسرائيلية في فلسطين ودولة مسيحية في لبنان .
ان تصرف البطريرك هذا والذي يستند فقط إلى ما قاله أنيس صايغ ، لا يظهر سوى منتهى قلق البطريرك الذي كان جلّ همّه ان يحفظ لبنان نفسه ككيان سياسي مسيحي وحيد في الشرق الأوسط بين غالبية مسلمة. كما يظهر أيضاً أن البطريرك كان يتمتع بسلطات زمنية كبيرة وكان بمقدوره التدخل في الشؤون السياسية للبلاد .
كتب رئيس جمهورية لبنان الأسبق ، بشارة الخوري حول كيفية معارضة البطريرك عريضة على ترشيحه عضواً في البرلمان. فهو يقول أن بعض أعضاء البرلمان الموارنة ذهبوا عام 1932 إلى المقر البطريركي في بكركي طالبين من البطريرك عدم المصادقة على ترشيحه. ويتابع الخوري قائلاً أنه حاول إقناع البطريرك بأن أعضاء البرلمان هؤلاء كانوا يلعبون لعبة سياسية ضده ، إلا أن البطريرك لم يقتـنع بذلك. يُـضيف بشارة الخوري ، بأن المطران عقل غالباً ما زار مكتب المفوض السامي الفرنسي لإعلان معارضة البطريرك في ترشيح الخوري لعضوية البرلمان .
ظل البطريرك عريضة حتى آخر حياته متمسكاً بإيمانه بأن لبنان يشكل كياناً فريداً منفصلاً عن بقية العالم العربي. هذا ما تجلى في الرسالة التي كتبها قبل وفاته بشهر واحد فقط في 19 أيار 1955 ، إلى الرئيس كميل شمعون والتي تنطوي على الرأي الماروني الرسمي لما يجب أن تكون عليه السياسة الصحيحة للبنان. أوضح البطريرك في هذه الرسالة بأن لبنان له كيان فذّ في الحياة ، بتأثير ظروف سياسية وجغرافية وروحية. وأن على كميل شمعون ، كرئيس للجمهورية ، ألا يربط لبنان بتحالفات في المنطقة. كان البطريرك هنا يُـشير إلى الاتفاقية التركية العراقية لعام 1955 ، التي أضحت نواة حلف بغداد. وأخيراً اشار البطريرك بأن يبقى لبنان محايداً وألا ينزلق في الصراعات الداخلية بين الدول العربية .
تغيرت هذه السياسة الضيقة ووجهة النظر المسيحية عن لبنان الى حدّ ما بمجيء البطريرك الجديد بولس المعوشي الذي خلف البطريرك عريضة في 30 أيار 1955. تبنى البطريرك الجديد سياسة متسعة الأفق محبذاً التعاون مع جيران لبنان المسلمين. وتطبيقاً لهذه السياسة قام البطريرك المعوشي في آذار عام 1956 بزيارة حي البسطة المسلم في بيروت وقال للمسلمين الذين حيوه بأبهة كبيرة بأنهم أقرباؤه الأعزاء وأنه كان سعيداً جداً بلقائهم على مستوى القومية العربية. أكَّد البطريرك وسط هتافات المرحبين به ، الذين خاطبوه على أنه بطريرك العرب ، بأن لبنان هو للكل ـ مسلمين ومسيحيين ـ وسوف يتعاون مع جيرانه. ومما يدل على ترحيب المسلمين بالبطريرك ان مسلمي حي البسطة علّقوا الصليب والهلال في أماكن بارزة على طول الطريق التي كان البطريرك سيجتازه ، رمزاً للوحدة المسيحية ـ الإسلامية . إلا أن هذه اللفتة الجديدة من النية الحسنة تجاه المسلمين لم يشارك بها كل الكهنة الموارنة. والمقصود هنا أن البطريرك الجديد إنهمك انهماكاً شديداً في السياسة اللبنانية وخاصة في الجدل حول الإصلاح الانتخابي. فبينما تمسك الرئيس شمعون بأن مجموع أعضاء البرلمان يجب أن يكون ستة وستين نائباً ، فكر البطريرك بأن عدد ثمانية وثمانين نائباً هو أكثر ملاءمة وأصدق تمثيلاً للبنان. وقد هتف المسلمون والمسيحيون للبطريرك على هذا الاقتراح .
وزاد إنهماك البطـريرك بشكل أكبر في السـياسة في السنة التالية 1957 ، عندما قبل لبنان مبدأ ايزنهاور الذي قدم المساعدة الاقتصادية والعسكرية لبلدان الشرق الأوسط التي طلبتها. في هذه الآونة قام المسلمون والدروز ، وبعض رجالهم ومنهم صائب سلام وكمال جنبلاط وغيرهم بتشكيل الجبهة القومية المتحدة لمضادة كميل شمعون والتي ضمت ايضاً شيوعيين وبعثيين وأعضاء من كتلة بشارة الخوري الدستورية. وفي 30 أيار من عام 1957 ، خرجت مظاهرة يقودها صائب سلام ضد كميل شمعون وضد قبوله لمبدأ ايزنهاور أصيب خلالها صائب سلام بجراح . واعتبر البطريرك المعوشي الحكومة مسؤولة عن الإصابة التي ألمت بصائب سلام . ويُـقال أن صائب سلام زار البطريرك في بكركي حيث بارك البطريرك جراحه .
وفي هذه الآونة وصلت موجة مد القومية العربية ، التي قادها الرئيس عبدالناصر منذ عام 1954 أوجاً جديداً باتحاد مصر مع سورية وتشكيل الجمهورية العربية المتحدة عام 1958. فقد اعتبر العديد من القوميين العرب هذه الوحدة بداية حلم طالما داعبهم بالوحدة العربية ، أما بالنسبة للبنان فقد تلقى كميل شمعون ومؤيدوه المناداة بالجمهورية العربية المتحدة بكثير من الخوف والقلق لإعتقادهم بأن الوحدة العربية ستعرض استقلال لبنان في النهاية الى الخطر .
حاول البطريرك بولس المعوشي تبني سبيلاً اكثر انفتاحاً وتعاوناً مع الوحدة العربية مما حمل الرئيس عبدالناصر على مدح البطريرك لموقفه من الوحدة العربية. أوضح الرئيس عبدالناصر أنه كان على استعداد لدعم الوحدة الوطنية في لبنان وتقاليده وعاداته ولكن البعض فسروا موقف البطريرك بكونه محاولة لكسب أكبر شعبية في العالم العربي والظهور بمظهر الصديق للقوميين. ربما كان البطريرك من الرأي القائل بأن مصالح لبنان كانت ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمصالح الدول العربية..
ذعر القادة الموارنة ، وخاصة بيير الجميل ، رئيس الكتائب من علاقات البطريرك مع عبدالناصر فاعلن في رسالة مطولة وجهها إلى البطريرك عن خوفه من أن يكون البطريرك قد رضخ لضغوط المؤيدين لاتحاد لبنان بالجمهورية العربية المتحدة. وجلب الجميل انتباه البطريرك بأن منصبه ومركزه يمثلان جوهر التاريخ اللبناني وبأن لدى الموارنة منتهى الإيمان ببطريركهم كوصي على التقاليد اللبنانية والاستقلال اللبناني. لذا ، ناشد الجميّل البطريرك بإعلان موقفه صراحة حول الشائعات المتداولة بأن لبنان سينضم إلى الجمهورية العربية المتحدة .
في هذه الأثناء سرت الشائعات بأن المجلس الماروني الأعلى قد اجتمع ووجّه رسالة إلى البابا بيوس الثاني عشر يحتج فيها على آراء البطريرك ونشاطه السياسي وفي 4 آذار 1957 ، اجتمع بيير الجميل على رأس وفد ، بالبطريرك لمعرفة الحقيقة عن موقف البطريرك. ولكي يطمأن الوفد صرّح البطريرك بأن بكركي هي فوق سياسات الأحزاب والاعتبارات الشخصية. وأضاف أنه يؤمن دون قيد أو شرط بسيادة لبنان وحريته لأن لبنان كبلد حر ذي سيادة يستطيع ان يقدم احسن خدمة للبلدان العربية. كما أكَّد البطريرك للوفد أن لبنان لن ينضم إلى أي اتحاد أو يصبح تابعاً لأية دولة في المنطقة .
واستمر تدخل البطريرك بالسياسة في قضية إعادة انتخاب الرئيس شمعون. ان الدستور اللبناني ينص على انتخاب رئيس الجمهورية لمدة واحدة فقط ولكن يبدو أن شمعون كان يحاول تعديل الدستور لتعبيد الطريق لإعادة انتخابه. ولما كان البطريرك ضد أي تعديل للدستور ، فان موقفه يعني بأنه كان يعارض إعادة انتخاب شمعون. ربما كان البطريرك يعتقد أن مارونياً آخر ، غير شمعون ، سيكون افضل لخدمة مصالح الطائفة المارونية .
وهكذا بدأ الصراع بين البطريرك وشمعون حول قضية الانتخاب ، واشتدت حدّة التوتر عندما أنشأت الحكومة ميليشيا من المواطنين اعتبرتها الجماعات المناوئة لشـمعون بأنها غطاء تستخدمه الحكومة لتعزيز موقف شمعون ومؤيديه. لكن البطـريرك كان مصراً على إدانته لإنشاء الميليشيات . وهناك بعض الأدلة بأن البطريرك حاول إقناع القائد العام للجيش ، فؤاد شهاب ، للحصول على منصب رئاسة الجمهورية إلا أن شهاب رفض ذلك. وبينما كانت معركة الانتخابات جارية في لبنان نشط الناصريون جداً في محاولتهم إزاحة شمعون عن كرسي الرئاسة وإعادة انتخاب رئيس جمهورية ناصري ..
وهنا اخذ الناصريون وكذلك السلاح بالتسرب إلى لبنان ، مما حدا بمجلس الأمن في الأمم المتحدة إلى اتخاذ قرار في 11 حزيران 1958 ، بإرسال فريق لإغلاق حدود لبنان مع الجمهورية العربية المتحدة. وفي غضون ذلك تولّد لدى الرئيس شمعون الانطباع بأن أزمة لبنان كانت مدفوعة من الخارج للتدخل في شؤون لبنان ، وخاصة من رئيس مصر عبدالناصر الذي كانت له اليد الطولى في هذا التدخل. غير ان التغيير السياسي العراقي الذي حصل في 14 تموز 1958 سبب صدمة للحكومة اللبنانية ، وخاصة لشمعون ، الذي ظنَّ بأن حكومته قد تسقطها قوى إسلامية خارجية. وكإجراء فوري لحماية حكومته وحماية لبنان طلب شمعون من حكومة الولايات المتحدة وفق شروط مبدأ ايزنهاور التدخل في لبنان لمساعدته..
استجابت الولايات المتحدة فأرسلت قوة بحرية إلى لبنان انزلت في بيروت عام 1958. وأخيراً جرى الانتخاب وفاز فؤاد شهاب الذي سانده البطريرك برئاسة الجمهورية. وخلال الأسابيع التي تلت انتخاب شهاب ثارت مناقشة حامية حول وضع لبنان بعد انسحاب القوات البحرية الاميريكية، ومن سيحمي لبنان؟
كان هناك اقتراح بتدويل لبنان الذي قد يستوجب وضع قوات أجنبية في لبنان للحفاظ على كيانه. وطرح اقتراح آخر مفاده أن يكون لبنان بلداً محايداً على النمط السويسري. كما ان البطريرك المعوشي طالب بحياد لبنان بالاتفاق مع الدول العربية .
المقصود هنا أن البطريرك ظل يتدخل في شؤون لبنان ويتكلم باسم لبنان كما لو كان رئيس الجمهورية. مثلاً عندما زار البطريرك الولايات المتحدة ، في أيلول عام 1962 ناقش مع الرئيس كيندي وضع لبنان ومصيره وأبدى اهتماماً كبيراً بتحقيق الجامعة اللبنانية في العالم. وفي غضون الخلوة الروحية في أيار 1963 ، وبينما كان الناس ينتـظرون ان يصدر البطريرك بعض الإرشادات الروحية طفق يتحدث عن استقلال لبنان ” الذي تعتبره البطريركية وديعتها بدلاً عن ذلك “.
وفي 8 أيار 1963 ، كتب الكاتب اللبناني يوسف الخال في جريدة بيروت اليومية النهار انه مع كل احترامه للبطريرك وإيمانه بحكمته الدينية يفتقد بأن بيان البطريرك بشأن استقلال لبنان لم يكن ضرورياً أو مفيداً .
وبينما كان البطريرك المعوشي يتكلم عن كل قضية سياسية تقريباً في لبنان ، حاول خلفه البطريرك أنطونيوس خريش ، إدراكاً منه للضرر الذي سببه سلفه أن يبقى بعيداً عن السياسة. كانت الأمور قد تغيرت في لبنان منذ الخمسينات ، وكان على البطريرك الجديد الذي تولى مقام منصبه عام 1975 ان يعالج المشاكل التي كانت إما هاجعة أو في طور الظهور في عهد سلفه بمزيد من الحكمة. ربما كانت المشكلة الرئيسة هي إقحام لبنان في حرب أهلية. كان البطريرك قبل المناداة بالميثاق الوطني لعام 1943 الرجل الفذ الذي يستطيع التكلم باسم الطائفة المارونية وحماية المصالح المارونية. ولكن بعد عام 1943 عندما اصبح رئيس الجمهورية مارونياً ، واصبح بمقدوره ومقدور رجال دولة موارنة علمانيين آخرين التكلم لمصلحة الطائفة المارونية.
وهذا لا يعني بأن الميثاق الوطني قضى على مكانة البطريرك كناطق باسم شعبه؛ بل جعل مكانته ثانوية بالنسبة لمكانة رئيس الجمهورية في المسائل المدنية. وليس أدل على كراهية البطريرك خريش للسياسة كالبيان الذي أدلى به لمندوبي مجلة الصياد نقولا صيقلي وفؤاد دعبول ومنير نجار ومريم أبو جودة وفوتين مهنا الذين اجتمعوا معه زهاء ثلاث ساعات ونصف. قال البطريرك للموفدين :
إنني رئيس كنيسة لا رئيس طائفة. لذا يجب ألا يفرض أحد رأيه على البطريرك. ليس هناك من حل (لمشاكل لبنان) إلا بالعلمنة أو العودة إلى الميثاق الوطني بعد تطهيره من الممارسات الخاطئة. إن من مصلحة المسلمين في العالم وفي لبنان خاصة أن يبقى لبنان كما كان .
تابع البطريرك قائلاً: ” في الماضي كان الموارنة بمفردهم وكان البطريرك كل شيء. ولكن عندما صارت لنا جمهوريتنا الخاصة عام 1943 ، تغيرت مهمة البطريرك ودوره “…..
يبدو ان البطريرك كان يشـير الى الحـرب الأهلية (1975ــــــ 1976) وهجوم إسرائيل واحتلال جنوب لبنان عام 1978. فقد كانت الحرب الأهلية ذروة المأساة اللبنانية الحالية لا سبباً لها. ويرجع البعض سبب الحرب إلى الطبيعة الطائفية للمجتمع اللبناني وانقسامه إلى ما لا يقل عن سبع عشرة طائفة رسمية تعترف بها الدولة ولكل منها الحق بتطبيق قانونها الديني للأحوال الشخصية في المحاكم الروحية. وبناء على هذه الطائفية المذهبية لم يكن يسمح لأية طائفة الهيمنة على الأخرى ، بل تمّ توزيع المراكز والامتيـازات الحكومية وفقاً لصيغة الميثاق الوطني لعام 1943 .
يعزو آخرون أسباب المأساة إلى نشوء القومية العربية في الخمسينات في عهد الرئيس جمال عبدالناصر كما ينسبها آخرون ايضاً إلى تهجير إسرائيل الفلسطينيين وخلق مشكلة اللاجئين التي عانى لبنان الكثير بسببها.
إن ما يرتبط ارتباطاً وثيقاً باللاجئين الفلسطينيين في لبنان هو اتفاقية القاهرة لعام 1969 ، التي تبعتها اتفاقية مماثلة وهي اتفاقية ملكارت في 15ــــ 17 أيار 1973 ، التي تُعتبر على حد تعبير عضو البرلمان اللبناني ريمون أده ” المصيبة التي نزلت حقاً بمسيحيي لبنان لا بل بكل لبنان ” . وقد تمَّ التـفاوض بشأن هذه الاتفاقية في القاهرة بين وفد لبناني يرأسه اللواء أميل البستاني ووفد فلسطيني يرأسه ياسر عرفات رئيس منظمة التحرير الفلسطينية بحضور ممثلين عن الجمهورية العربية المتحدة. وأعطى المندوبون الذين اجتمعوا في 3 تشرين الثاني 1969 ، الحق للفلسطينيين ، بالتعاون مع السلطات المحلية ، بتسليح أنفسهم للإبقاء على الثورة الفلسطينية حية بواسطة النضال المسلح ولكن دون خرق سلامة لبنان وسيادته . بعبارة أخرى ، اعترفت اتفاقية القاهرة لعام 1969 بوضع الفلسطينيين في لبنان ككيان عسكري منفصل عن الكيان اللبناني لغرض القيام بالنضال المسلح ضد إسرائيل. إن من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن الاتفاقية صادق عليها كميل شمعون وبيير الجميل ، وخاصة الأخير الذي سيصبح العدو اللدود للفلسطينيين ….
أخذ الفلسطينيون بتشجيع هذه الاتفاقية لكي يحصلوا على السلاح وخزنه في تل الزعتر في وسط بيروت دون أن يعلموا السلطات اللبنانية بذلك. وبحلول عام 1975 أصبح تل الزعتر ترسانة عامرة بالأسلحة التي كان بمقدور الفلسطينيين استعمالها لا ضد إسرائيل فحسب بل ضد حكومة لبنانية ضعيفة لم يكن لديها سوى قوة عسكرية رمزية. اعتقد الفلسطينيون ، باستغلالهم ضعف الحكومة اللبنانية وربما بتشجيع من بعض الدول العربية ، أن باستطاعتهم الاستيلاء على لبنان وتحويله إلى قاعدة فلسطينية يستطيعون منها قتال إسرائيل. في الحقيقة ان هذا الحلم راود الفلسطينيين منذ أن فقدوا سلطتهم في الأردن ، حين قام الملك حسين في أيلول الأسود 1970 بقتل زهاء عُشر الفلسطينيين تقريباً الذين كانوا قد تحولوا بقوتهم ضده وتصرفوا كدولة ضمن دولة. وبعد أن فقد الفلسطينيون موقعهم في الأردن ، تحولوا الى لبنان الذي أصبح الأرض الوحيدة المناسبة لعملياتهم. ومما زاد من حدة التوتر بين الفلسطينيين والحكومة اللبنانية هو ازدياد الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان في عام 1971 و 1972 وقصف مخيم الفلسطينيين ، والانتـقام المحدود من جانب الفلسطينيين. لكن التوتر استمر في التصاعد حتى 12 نيسان 1975 عندما اعتقد الفلسطينيون أن الوقت قد حان لكي يحوزوا السلطة في لبنان.
شرارة الحرب الأهلية//
في ذلك اليوم ، وكان يوم أحد ، حضر بيير الجميل ، رئيس حزب الكتائب الماروني احتفالاً دينياً لتقديس كنيسة مارونية جديدة في عين الرمانة في بيروت الشرقية. وما أن غادر مبنى الكنيسة مع حارسه حتى بدت على الفور سيارة تحمل رجالاً فلسطينين وفتحت النار. وقتل ثلاثة أشخاص منهم مرافق الجميل الخاص. وفي نفس الوقت اطلق الكتائبيون النار على حافلة وصلت على الفور تحمل ثلاثين فلسطينياً مسلحاً ، وقتلوا سائر ركابها. وهكذا بدأت الحرب الأهلية .
سعى كمال جنبلاط القائد الدرزي للحزب التقدمي الاشتراكي إلى معاقبة الكتائبيين بإقصائهم عن الحكومة كما أمر الجميل وزيريه في حكومة رشيد الصلح بالاستقالة ، إلا أن الوزراء الآخرين الموجودين في الوزارة ، وخاصة الوزير الدرزي مجيد أرسلان ، عارضوا جنبلاط بشدة .
أعلن البطريرك خريش صراحة أن إقصاء الكتائبيين عن الحكومة كان أمراً لن تقبله الكنيسة . ومن ثم بقي الوزراء الكتائبيون في الوزارة. ولكن الجميل وجد نفسه يحارب نفس الأشخاص الذين كان قد دعمهم بالتصديق على اتفاقية القاهرة التي سمحت لهم بتسليح أنفسهم. ومع أن البطريرك أراد من الوزيرين الكتائبيين المارونيين البقاء في الحكومة ، إلا أنه لم يفعل ذلك من موقف متّسم بالقوة بل كان يعبر بالأحرى عن وجهة نظره الخاصة. لان السلطة الدينية كانت في أيدي سلك الرهبنة المارونية ورئيسها الآباتي شربل قسيس ، الذي أضحى بمثابة القلب والروح لحزب الكتائب .
كان الاب شربل قسيس هو الرئيس غير الرسمي للكتائبيين والذي صاغ بعض بياناتهم الرسمية المتطرفة لأجل وجود لبنان يتمتع بالسيادة. وبرهاناً على دعمهم للكتائبيين الموارنة ضد الجماعات غير المسيحية ، هرع هؤلاء الرهبان إلى اتخاذ مواقع حول أديرتهم رافعين أثوابهم الكهنوتية فوق ركبهم وحاملين بنادق الكلاشينكوف في أيديهم ( هذا ما يدل على أن البطريرك لم يعد قادراً على التكلم لصالح الطائفة المارونية حول المسائل السياسية) …
قام كتّاب آخرون بكتابة تاريخ لبنان منذ عام 1975 وحتى الوقت الحالي بحثه ولا حاجة الى اعادته هنا. بل يكفي إعطاء صورة سريعة عن الأحداث في لبنان المتعلقة بموقف الكنيسة المارونية والطائفة المارونية على ضوء هذه الأحداث .
في عام 1976 داهم الكتائبيون تل الزعتر تساعدهم جماعات مسيحية أخرى. ومع أن الفلسطينيين فقدوا ترسانتهم وعدداً كبيراً من الضحايا إلا أن الحرب الأهلية لم تقصم ظهورهم. فقد أعادوا تكتيل أنفسهم ونقلوا قواهم الى الجنوب لقصف الأجزاء الشمالية من إسرائيل بالقنابل. وفي عام 1976 قررت جامعة الدول العربية إرسال قوة عربية رادعة إلى لبنان قامت الدول العربية المنتجة للنفط بتقديم العون المالي لها ، وخاصة المملكة العربية السعودية والكويت. وكانت سورية هي إحدى الدول العربية التي اشتركت في هذه القوة .
كانت سورية ، من بين كل البلاد العربية ، قلقة جداً بخصوص الوضع في لبنان لأسباب سياسية واقتصادية. وبما أن سورية هي جارة لبنان فقد كان بمقدورها ان تلعب دور كبيراً في الشؤون الداخلية للبنان. وقد اتاح لها الكتائبيون الفرصة عندما طلبوا منها عام 1976 مساعدتهم ضد الفلسطينيين. وهكذا دخلت القوات السورية لبنان .
بدأ الصدام عندما قامت إحدى الفـرق الفدائية بالخطف وقطع الطرقات وأدّى هذا إلى قتل عشرات المسلمين والمسيحيين بمجرد إنتمائهم الديني المدوّن على بطاقة الهوية الخاصة بهم . قاد هذا الصراع الدامي إلى العداء الديني فدُنِست مساجد وكنائس وخلقت أجواء استغلت بسهولة من المتطرفين عند كلا الطرفين في داخل لبنان وخارجه .
تحدث رجال الدين ابان خطبة الجمعة في دمشق على العمل لنجدة إخوانهم المسلمين اللبنانيين ، مما أضاف صدى الشعور الطائفي التي كانت الحكومة السورية تتحسس منه . أدى هذا النزاع إلى تحريك الشعور الطائفي في مصر ، فنشرت إحدى الصحف في القاهرة صورة أحد أفراد حزب الكتائب اللبنانية ، حاملا صليباً ضخماً على صدره ، يحرس صفاً من السجناء المسلمين مصفوفين تجاه الحائط ، قادت بعد يومين من نشرها وتوزيعها إلى تعكير العلاقات ما بين المسلمين والأقباط المسيحيين.
تابعت السلطات الإسرائيلية صراخ الاضطهاد المسيحي في لبنان بشكل رسمي وأشار وزير خارجيتها إلى أن مضـايقة المسيحيين تمّث على يد “الأكثرية الإسلامية المتعصّبة” وعبرّ عن دهشته على صمت “العالم المسيحي” إزاء ذلك !.
وفي 15 آذار 1978 ، أغارت إسرائيل على حدود لبنان الشمالية لصد الفلسطينيين. وتكرر الاجتياح في حزيران 1982 عندما وصلت القوات الإسرائيلية إلى بيروت واضطر القادة الفلسطينيون مغادرة لبنان واللجوء إلى تونس. وفي 6 آذار 1985 أبلغ رئيس الوزارة الإسرائيلي شمعون بيريز صحيفة لوموند بأن بيير الجميل وابنه بشير الجميل طلبا المساعدة من إسرائيل بهيئة أسلحة وتمويل ، فسارعت إسرائيل لمساعدة الكتائب. وكانت إحدى نتائج هذا الاجتياح مذبحة الفلسطينيين في مخيمي صبرا وشاتيلا للاجئين. ولكن يجب الا ننسى بأن الفلسطينيين كانوا مسؤولين عن مذابح مماثلة لكهنة ومدنيين مسيحيين أبرياء في الدامور وفي قرى جنوبية أخرى من لبنان. وإذا كانت إسرائيل قد أنزلت الدمار بلبنان بسبب اجتياحه في عام 1978 وثانية في عام 1982 ، فإن سورية وبعض الدول العربية لم تكن أقل مسؤولية عن دمار لبنان بتزويدها الفلسطينيين ومجموعات لبنانية أخرى بالسلاح والمال ..
عندما اجتاح الإسرائيليون لبنان عام 1982 كانوا على ثـقة بأن بشير الجميل ، حليفهم ، سيكون راغباً جداً في توقيع اتفاقية تعترف بإسرائيل. بل كل ما كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بيغين يتوقعه في صيف 1982 هو إما ان تكون هناك حكومة مركزية قوية في لبنان صديقة لإسرائيل أو على الاقل اتفاقية سلام يوقعها كلا البلدين. لكن بشير الجميل تردد في توقيع اتفاقية مع إسرائيل لأنها في نظره كانت جزءاً فقط من حل شامل في الشرق الأوسط. وفي 14 أيلول 1982 ، قُـتل بشير الجميل عندما ألقيت قنبلة داخل مركز القيادة الرئيسي لحزب الكتائب في الأشرفية وخلفه أخوه أمين كرئيس جديد للبنان ..
كان أمين الجميل هو اختيار إسرائيل فقد انتخب في ثكنة للجيش بدعم من وزير الدفاع الإسرائيلي آرييل شارون. ولهذا وقع أمين ، وهو الأكثر عزماً ولكن الاقل اندفاعاً من أخيه في معالجة الشؤون السياسية ، اتفاقية مع إسرائيل في 17 أيار 1983 وأعلن دون وجل من رد فعل سوري أو عربي على هذه الاتفاقية قائلاً بأنه سوف ” يرد القنابل السورية صوب دمشق ” . لكن موقفه تغير بعدئذ. وتحت ضغط أو إقناع الرئيس السوري حافظ الأسد ، نقض امين الجميل اتفاقية 17 أيار مع إسرائيل بعد ثلاثة أشهر وكاد أن يصبح ألعوبة بيد السوريين. واثار الغاء الاتفاقية مع إسرائيل استياء الولايات المتحدة التي تخلت على ما يبدو عن أمين الجميل.
أصبح الموارنة في عهد آل الجميل أكثر ضعفاً مما كانوا عليه من قبل؛ لا بل نجدهم يسيطرون على جزء يحتلون من لبنان أصغر مما كانوا يشغلونه سابقاً .
إن مركز أمين الجميل قلق جداً ، ولبنان هو دولة أقل قدرة على الحياة. وربما كانت أكثر الضربات الموجعة لأمين الجميل ، من وجهة النظر المارونية ، هي المصالحة القريبة العهد بين سليمان فرنجية رئيس جمهورية لبنان الماروني الأسبق وايلي حبيقة قائد القوى اللبنانية التي أسسها بشير الجميل في ربيع 1976 لتنظيم المجهود الحربي المسيحي في لبنان ..
في 13 حزيران 1978 هاجمت مجموعة من القوى اللبنانية قصر الرئيس فرنجية في أهدن وقتلت بهدوء أعصاب ابن الرئيس طوني الذي كان عضواً في البرلمان وزوجته فيرا وابنتيهما والخادمة وكلبهم. وبالرغم من أن بشير الجميّل أقسم بأن لا علم له بأن طوني وزوجته كانا داخل القصر إلا أن أعذاره لم تـقنع اللبنانيين . وفي يوم الخميس الواقع في 8 آب 1985 ، دفن سليمان فرنجية وايلي حبيقة أحقادهما بمعانقة أحدهما الآخر. وبعد أربع وعشرين ساعة فقط من هذه المصالحة ، والتي أعادت على ما يُزعم الوحدة بين الخصمين المسيحيين ، طالب الرئيس فرنجية بتنحية أمين الجميل ، دالاً بذلك على الصدع العريض بين صفوف الموارنة والقـادة المـوارنة في لبنـان . كما يـدل هذا على أن الجبهة المسـيحية والجبهة الإسـلامية أيضاً رفضتا الرئيس الحالي للبنان ..
مازال لبنان اليوم يعاني من الطائفية أكثر مما عاناه في الأجيال الماضية.
إن التوزيع الحالي للطوائف الدينية الرئيسة ، أي المسيحيين ، والموارنة بشكل أساسي ، والمسلمين من سنة وشيعة والدروز كل في منطقته ، يدل على وجود التقسيم الفعلي للبنان. فبيروت ، العاصمة ، يقسمها خط أخضر إلى بيروت غربية مسلمة وبيروت شرقية مسيحية. والاكثر من هذا ان الحكومة المركزية فقدت سلطتها على معظم البلاد بل هي موجودة بالاسم فقط. ومما زاد في ارتباك هذا الوضع المشوش وجود السوريين في شرق لبنان والإسرائيليين في جنوبه. وهكذا اصبح هذا البلد الذي كان يوماً بلداً جميلاً ، يُوصف بأنه “سويسرا الشرق” كومة من ركام .
يؤمن الرهبان الموارنة أن لبنان هو مجتمع مذهبي ذو صفة مسيحية بشكل أساسي أي ان صبغته مسيحية مارونية. فهو مزيج من ثـقافات متعددة أبرزها المارونية. لهذا السبب نرى الرهبان يوافقون على الميثاق الوطني لعام 1943 بكونه الوثيقة التي تعكس الهيكلية البانورامية للمجتمع اللبناني. ولهذا أصروا على أن تكون لرئيس لبنان الماروني سلطة واسعة لحماية الطائفة المارونية. وإلا فإن مارونية الرئيس دون سلطة واسعة لا معنى لها كما يعتقدون .
يؤمن موارنة لبنان اليوم بأن لبنان هو بلد مسيحي للمسيحيين. إنه وطنهم وهم يرفضون كمسيحيين العيش في أي مفهوم ” للذمة ” ، أي مسيحيين تحت حماية الإسلام. لقد استمروا وسيستمرون في الشهادة لمسيحيتهم في الشرق الأوسط. وهم يرغبون في الاحتفال بطقوسهم وتقاليدهم متى شاءوا. وعلى حد تعبير رئيس لبنان الراحل ، بشير الجميل ” لبنان هو وطننا وسيبقى وطناً للمسيحيين… نريد الاستمرار في التعميد وفي الاحتفال بطقوسنا وتقاليدنا ، بإيماننا وعقيدتنا متى شئنا… نحن نرفض العيش تحت أي مفهوم ” للذمة ” ….